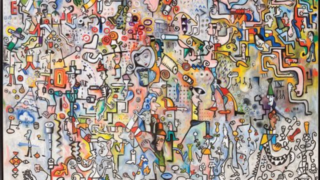ثمة ارتباط شرطى بعدم الارتياح لازمني لفترة طويلة مقترناً باسم "درية شفيق" . الآن، وفيما أحاول أن أتذكر أسباب ذلك لا أكاد أتذكر سبباً واضحاً، إلاّ تلك الأدبيات التي طالعتها منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي وحتى مفتتح الألفية، والتي كانت صدى لما تم ترديده عن السيدة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ثم قام بإعادة إنتاجها بعض المحافظين من التيار الديني المتشدد، وغيرهم، لاقتران اسمها بمفهوم "تحرير المرأة"، وهو المفهوم الذي كان وقتها غامضاً وفضفاضاً. بل إنه رادف الانحلال عند بعضهم.. ولا يزال!
ظلّت معلوماتي ملتبسة عن السيدة لفترة طويلة، حتى عثرت على كتاب "امرأة مختلفة" عن السيرة الذاتية لـ"درية شفيق"، والذي كتبته الكاتبة الأمريكية "سينثيا نلسون"، لأجد أنني إزاء "امرأة مختلفة" بالفعل. وأن الإنصاف يقتضي إعادة قراءة التاريخ النضالي لتلك المرأة الاستثنائية، المثيرة للجدل والإعجاب في آن، والتي غرّدت دائماً خارج السرب، ودفعت الثمن كاملاً غير منقوص.
تقول "سينثيا نلسون" في مقدمة كتابها إنها "قصة امرأة أرادت لحياتها أن تكون تحفة فنية، قصة كفاح امرأة وحدها في مواجهة قوى الرجعية في مجتمعها - ثقافية كانت أو دينية أو سياسية - قصة لقاء بين الوعي الإنساني الوليد لامرأة، وعي شكلته القيم الإسلامية والإنسانية، وبين صحوة الهوية القومية لمجتمعها، الصحوة المنبثقة عن الوعي التاريخي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
لم يقتصر نضال "درية شفيق" في تلك المساحة المحدودة التي صارت تعرف بالنضال النسوي، والذي يسعى طوال الوقت إلى محاولة انتزاع حقوق طبيعية أو مفترضة للمرأة، أو دفع التحيز أو التمييز ضدها، بل اتسع مفهومها النضالي ليستوعب أن السلطة المستبِدة صارت تشكل خطراً داهماً على حقوق النساء والرجال معاً. وعلى حقوق الوطن الذي صار رهينة مزاج الحكام ورغبتهم العارمة في التسلط والاستبداد، ومصادرة الحقوق مهما كانت الذرائع التي يتم تسويقها لتسويغ ذلك الاستبداد.
النشأة
ولدت "درية" في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1908 في مدينة طنطا بدلتا مصر، وجاء ترتيبها الثالث بين إخوتها الستة. والدها "أحمد شفيق" كان مهندساً للسكة الحديد، وأمها "رتيبة ناصف" ذات الأصول الثرية والتي عملت كربة منزل.
____________
من دفاتر السفير العربي
من تراث ربّات القلم
____________
ومنذ النشأة المبكرة، تلمست "درية" بألم تلك الفروق الطبقية التي حكمت حياة الناس ووضعتهم داخل مراتب اجتماعية محسومة سلفاً. حتى في محيط أسرتها الصغيرة، كانت أمها تثقل كاهل الأب الموظف، محدود الدخل، للاحتفاظ بالمظاهر أمام أقاربها الأثرياء. تقول " كنت أميل دائماً إلى تصنيف الناس والأشياء في فئات وطبقات، وبما أنني كنت أدرك دائماً أنني لا أنتمى إلى الطبقة التي تصورتها في مخيلتي، ظللت أتعذب من جراء ذلك".
تقول "سينثيا نلسون" في مقدمة كتابها إنها "قصة امرأة أرادت لحياتها أن تكون تحفة فنية، قصة كفاح امرأة وحدها في مواجهة قوى الرجعية في مجتمعها - ثقافية كانت أو دينية أو سياسية - قصة لقاء بين الوعي الإنساني الوليد لامرأة، وعي شكلته القيم الإسلامية والإنسانية، وبين صحوة الهوية القومية لمجتمعها، الصحوة المنبثقة عن الوعي التاريخي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
في السادسة من عمرها، قرر أبواها إرسالها للالتحاق بمدرسة الإرسالية الفرنسية ("نوتردام دي أبوتر"). وفي المدرسة، أبدت تفوقاً لافتاً حتى أنها نُقلت إلى فصل أعلى أثناء السنة الدراسية.
عندما انتقلت إلى الإسكندرية بعد ذلك، التحقت بمدرسة راهبات القديس "فنسان دى بول"، ولكنها عندما أرادت استكمال دراستها الثانوية والحصول على البكالوريا من مدرسة "الليسية" التي كان القبول بها مقتصراً على البنين، قررت أن تدرس مناهجها بنفسها في المنزل، ليأتي ترتيبها في المركز الثاني على مستوى البلاد، وهو الترتيب الذي جعل المدرسة تسمح للفتيات فيما بعد باستكمال الدراسة المنتظمة فيها. حصلت درية على الثانوية الفرنسية كأصغر طالبة تحصل عليها في سن السادسة عشرة.
فرنسا
راسلت "درية" السيدة "هدى شعرواي"، مؤسِّسة "الاتحاد النسائي المصري"، أول منظمة نسائية في العالم العربي - وهي الأخرى أرستقراطية ثرية قريبة من شبكات النفوذ - كي تطلب مساعدتها للحصول على منحة لدراسة الفلسفة في جامعة "السوربون". وفي آب/ أغسطس من العام نفسه، سافرت إلى باريس بصحبة إحدى عشرة فتاة، تحت رعاية وزارة التعليم، ضمن برنامج البعثة الثقافية والتعليمية في الخارج. وكان عمرها ساعتها تسعة عشر عاماً.
أثر الفراشة: إبراهيم النبراوي نموذجاً
17-02-2022
وفي فرنسا عملت "درية" بدأب وبلا هوادة منذ اليوم الأول. في البداية حصلت على ليسانس الدولة بمرتبة الشرف، وبدا أن لديها قدرة هائلة على التركيز للوصول إلى أهدافها. تلك القدرة التي ستصبح مصدر قوتها ونقطة ضعفها في آن واحد، لأن طموحها الذي لا يعرف حداً سوف يجعلها ترتطم طوال الوقت بصخور كان بعضها مما يصعب إزاحته أو تحطيمه.
وفى فرنسا قابلت "درية" "نور الدين رجائي" ابن خالتها الذى أوفدته الحكومة المصرية للحصول على الدكتوراه في القانون التجاري من السوربون وتزوجته.
مصر من جديد
عادت "درية" إلى مصر في ربيع عام 1940 بعد حصولها على الدكتوراه، كانت مصر ساعتها تنساق نحو الحرب العالمية الثانية بلا إرادة، والمجتمع يمور بمجموعة من التغيرات الاجتماعية والسياسية العاصفة.
أوصد الباب في وجهها عندما حاولت العمل بالتدريس في كلية الآداب. رفض عميد الكلية، "الدكتور أحمد أمين"، تعيينها لمجرد أنها امرأة . وبدا أن الرجل المحافظ يخشى على سمعة الجامعة من تعيين سيدة جميلة ومنفتحة... بدت الأسباب عبثية فالرجل الذى أنفق جل حياته وهو يكتب عن التاريخ الإسلامي رفض تعيين السيدة التي كانت رسالتها عن المرأة في الإسلام، والتي لم يتردد أحد أساتذتها في السوربون بأن يخبرها بأن "رسالتك أفضل دفاع عن حقوق المرأة كتبت حتى الآن، أو قد تُكتب في المستقبل. لقد أثبتت أموراً في الإسلام لم يعد فيها شك . لقد نجحت في تصحيح أفكارنا الخاطئة عن الإسلام، ولك أن تعتبري نفسك المدافعة عن المرأة المسلمة عامة، وعن المرأة المصرية خاصة".
عندما أرادت استكمال دراستها الثانوية والحصول على البكالوريا من مدرسة "الليسية" التي كان القبول بها مقتصراً على البنين، قررت أن تدرس مناهجها بنفسها في المنزل، ليأتي ترتيبها في المركز الثاني على مستوى البلاد، وهو الترتيب الذي جعل المدرسة تسمح للفتيات فيما بعد باستكمال الدراسة المنتظمة فيها.
في فرنسا عملت "درية" بدأب وبلا هوادة منذ اليوم الأول. في البداية حصلت على ليسانس الدولة بمرتبة الشرف، وبدا أن لديها قدرة هائلة على التركيز للوصول إلى أهدافها. تلك القدرة التي ستصبح مصدر قوتها ونقطة ضعفها في آن واحد، لأن طموحها الذي لا يعرف حداً سوف يجعلها ترتطم طوال الوقت بصخور كان بعضها مما يصعب إزاحته أو تحطيمه.
وعندما حاولت الانضمام إلى الاتحاد النسائي الذى أسسته السيدة "هدى شعرواي" جوبهت بموقف عدائي نتيجة بعض الدسائس التي لم تستطع "درية" أن تفهمها في حينها، وإن كانت في مجملها طبقية، إذ أن معظم النساء المنتميات لذلك الاتحاد كن من أصول شركسية أو تركية، ينظرن بتحفظ إلى نموذج "درية شفيق" ابنة الطبقة المتوسطة، والمولودة في الأقاليم، حتى وإن حملت درجة الدكتوراه من السوربون.
سارعت "درية" بتكوين حركتها الخاصة التي سميت بـ"اتحاد بنت النيل"، وسعت من خلالها إلى تشجيع تعليم النساء العاملات، وفتح فصول لمحو أمية السيدات، وتشجيعهن على العمل من خلال وكالات توظيف. كما شمل نشاط الحركة فعاليات ثقافية وعروض مسرحية. وأصدرت عدة دوريات أدبية منها مجلة "المرأة الجديدة" ومجلة "بنت النيل" ومجلة "الكتكوت الصغير" للأطفال. كما ألفت عدة دواوين شعرية وكتب إضافة إلى مذكراتها الخاصة.
ولكن الدور الحقيقي الذى احتشدت له "درية" بأقصى ما تستطيع هو المطالبة بالحقوق السياسية المهْدرة للمرأة المصرية التي لم تتمكن من ممارسه حقها قط.
الدور السياسي العسير
"كان بلدي في حال من الغليان يصعب معه التنبؤ بكل ما يتجمع في الأفق من عواصف، ووجدتني مضطرة لخوض المعمعة. لم تكن المسألة مجرد فضول، وإنما رغبة دفينة مشوبة بالقلق، في أن ألمس بيدي ذلك الشر الذي تعاني منه بلادي والذي لم ألمس أسبابه بعد"[1]
في شباط / فبراير عام 1951، قادت "درية" مظاهرة مكونة من 1500 سيدة إلى البرلمان المصري، والذي كانت تطلق عليه "برلمان النصف الآخر من الأمة"، للمطالبة بحق الانتخاب وحق الترشح للنساء، وحق الاشتراك في الكفاح الوطني والسياسي، وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية. واستمرت المظاهرة لمدة 4 ساعات، مما دفع برئيس المجلس لمقابلتهن وبحث مطالبهن. وبعد أسبوع واحد من المظاهرة، عرض على البرلمان مشروع بمنح المرأة حق التصويت والترشح، وهو ما لم يتحقق.

في العام نفسه قامت بإعداد فرقة شبه عسكرية من النساء المصريات للمقاومة ضد وحدات جيش الاحتلال البريطاني في قناة السويس، تضمنت الاستعداد للقتال وتدريب ممرضات للميدان. حوكمت لقيادتها مظاهرة نسائية من "اتحاد بنت النيل" حيث قمن بمحاصرة "بنك باركليز" البريطاني باعتباره رمزاً للاحتلال في القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1951، ودعين لمقاطعته..
بعد قيام "ثورة 23 يوليو " طلبت درية من الحكومة تحويل "اتحاد بنت النيل" إلى حزب سياسي، فتم الأمر ليصير حزب اتحاد بنت النيل أول حزب سياسي نسائي في مصر.
شاهندة مقلد: سيدة الاختيارات الصعبة
03-07-2013
منى مينا: الحالمة التي لا تعرف المستحيل
10-03-2016
وعندما شرعت حكومة الثورة في وضع دستور عام 1954، احتجت " درية شفيق" لعدم وجود امرأة واحدة بين أعضاء لجنة الدستور. وقامت برفقة نساء أخريات من أعضاء حركتها بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على ذلك، ثم وجهت رسالة إلى الرئيس "محمد نجيب" تخبره بأنهن "مقتنعات بأن النساء اللواتي يشكّلن أكثر من نصف الشعب المصري يجب ألا يحكمهن بدستور لم يشاركن في كتابته بأي ثمن"، حتى وعدها الرئيس بأن المرأة المصرية سوف تنال حقوقها في الدستور الجديد.
"كان بلدي في حال من الغليان يصعب معه التنبؤ بكل ما يتجمع في الأفق من عواصف، ووجدتني مضطرة لخوض المعمعة. لم تكن المسألة مجرد فضول، وإنما رغبة دفينة مشوبة بالقلق، في أن ألمس بيدي ذلك الشر الذي تعاني منه بلادي والذي لم ألمس أسبابه بعد".
في 3 آذار/ مارس 1956 صدر قانون الانتخاب الخاص بتنظيم الحقوق السياسية، بعد 4 أعوام من "حركة الضباط الأحرار"، ليمنح المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة في تاريخ البلاد. ولكن "درية" اعتبرت أن القانون جاء ناقصاً ومعيباً لأنه كان يشترط إجادة المرأة للقراءة والكتابة، وهو شرط لا ينسحب على الرجال، كما جعل حق مشاركتها في الانتخابات اختيارياً. وهو ما رأته حينها تمييزاً ضد المرأة.
بعد صدور القانون الذي نص على حرية المرأة في المشاركة السياسية، كانت المستجدات على الأرض تتجه للقضاء على حرية التعبير، بإلغاء الأحزاب السياسية ووضع الصحافة تحت سلطة ورقابة الدولة، وتقييد الحريات العامة، وكانت تؤكد بجلاء أن النظام يسعى إلى منح حقوق سياسية شكلية، وأنه قد صادر بالفعل ليس فقط حقوق النساء ولكن حقوق النساء والرجال معاً.
والمفارقة أن "درية شفيق" تنبهت إلى ذلك في وقت مبكر للغاية وفى ذروة تنامي شعبية "جمال عبد الناصر"، وصعود نجمه عقب تأميم قناة السويس وحرب عام 1956. واتهمته بالديكتاتورية في الوقت الذى كان قد نجح في تعزيز سلطته وخلق قاعدة جماهيرية كاسحة جعلت كل معارضه لشخص الرئيس تبدو بلا طائل وبلا جدوى..
في أعقاب مجابهتها للرئيس، قامت السيدة بإضراب آخر عن الطعام وحدها من داخل السفارة الهندية، لستة أيام هذه المرة. أعلنت قبله بأنها "تطالب السلطات المصرية بإعادة الحرية الكاملة للمصريين رجالاً ونساءً، وبوضع حد للحكم الديكتاتوري الذي يدفع ببلادنا إلى الافلاس والفوضى، وأنني وحدي أتحمل مسؤولية التخلي عن حياتي من أجل تحرير البلاد".
وربما يمكن فهم دوافع "درية" من تلك الخطوة التي بدا واضحاً أنها إنْ لم تنهِ حياتها، فقد أنهت مسيرتها السياسية للأبد، عندما سألتها رفيقة رحلتها، "راجية رجب"، لماذا تفعل ذلك، خاصة ومصر كلها تقريباً كانت تؤيد "عبد الناصر"؟ فأجابتها درية: "إن واجبي كمصرية يحتم علي أن أسأل حاكم مصر إلى أين يقودنا، فإن لم نفعل شيئاً الآن فلن نفلت من عبد الناصر أبداً".
أبصرت "درية" أن مصادرة المناخ العام، ووضع كل الصلاحيات في يد شخص واحد، مهما بدا أنه يمضي قدماً نحو تحقيق غايات الوطن هو "تفويض" يأتي بعيداً عن المساءلة والمحاسبة، وتهميش أو إلغاء لدور المؤسسات، وهو ما يصل بشكل مؤكد نحو أخطاء كارثية.
ولكن وسائل إعلام الدولة هاجمتها باعتبارها خائنة. وانقلب حلفاؤها عليها، وطُردت من "حركة بنت النيل" التي أنشأتها.
وبدأت الدوائر تضيق حولها بالتدريج، وبدأت الصحافة في مهاجمتها باعتبارها من بقايا "المجتمع الاقطاعي البائد" على الرغم من أنها لم تكن إقطاعية في أي وقت، بل وتمّ حصرها في إطار أنها "سيدة صالونات لا صلة لها بالجماهير العريضة ولا تعرف عنها شيئاً".
بعد صدور القانون الذي نص على حرية المرأة في المشاركة السياسية، كانت المستجدات على الأرض تتجه للقضاء على حرية التعبير، بإلغاء الأحزاب السياسية ووضع الصحافة تحت سلطة ورقابة الدولة، وتقييد الحريات العامة، وكانت تؤكد بجلاء أن النظام يسعى إلى منح حقوق سياسية شكلية، وأنه قد صادر بالفعل ليس فقط حقوق النساء ولكن حقوق النساء والرجال معاً.
أبصرت "درية" أن مصادرة المناخ العام، ووضع كل الصلاحيات في يد شخص واحد، مهما بدا أنه يمضي قدماً نحو تحقيق غايات الوطن هو "تفويض" يأتي بعيداً عن المساءلة والمحاسبة، وتهميش أو إلغاء لدور المؤسسات، وهو ما يصل بشكل مؤكد نحو أخطاء كارثية.
أدى موقف درية إلى استبعادها تماماً من الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وأصدر "عبد الناصر" قراراً بتحديد اقامتها في منزلها، وقام بطرد زملائها من "اتحاد بنت النيل"، وعينت الحكومة لجنة من خمس سيدات لإدارة الاتحاد. كما تمت مصادرة المجلات الخاصة بالحركة.
رضوى وأروى: البدايات والمآلات
08-06-2023
في 20 ايلول/ سبتمبر سنة 1975 ألقت "درية شفيق" نفسها من شرفة منزلها بالزمالك، لتلقى حتفها على الفور، بعد سنوات طويلة من العزلة جرت خلالها تحت جسور الوطن مياه كثيرة، وكان جيلاً جديداً قد نشأ وهو لا يعرف شيئاً عن تلك السيدة التي لخصت الصحافية "فاطمة عبد الخالق" قصتها ومأساتها، فكتبت "في يوم ما، كانت درية شفيق هي الرجل الوحيد في مصر. التزمنا كلنا الصمت خوفاً. نزل علينا سهم الله. ثم ظهرت "درية" لتخبرنا بأننا في طريقنا إلى الديكتاتورية، وحينها هبّت نساء مصر وتنظيماتها احتجاجاً عليها. وعلى الرغم من أنها دفعت الثمن كاملاً فإنها لم تحنِ هامتها أبداً. إننا ندين لتلك السيدة بالعرفان الذي تستحقه.
- "امرأة مختلفة"، سينثيا نلسون، ترجمة نهادة أحمد سالم، اصدار "المجلس الأعلى للثقافة" القاهرة 1999