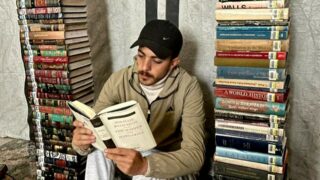نقرأ الآن، لأننا بعيدون عن دائرة القصف. نتأمل لأننا بعيدون عن ملمس الوجع.
يقول مؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ إن "الألم الذي لا يتحول إلى وعي يعيد إنتاج نفسه بأشكال مختلفة". وعقب نكبة العام 1948، كتب المثقف الفلسطيني تقي الدين إبراهيم النبهاني أن "إنقاذ فلسطين مرتبط بإنقاذ الشعب العربي في مجتمعه وكيانه بقيادة كتلة اجتماعية وسياسية تبصر الحياة بالتعب".
هي إذاً متلازمة الوعي والوجع. لكن من هو القادر عليها؟ وبأي وقت؟ أهو من يكتوي بجحيم الفقد والتشرد والألم الجسدي في غزة الآن؟ أم من يتابع عن بعد، عاجزاً مكوياً وفي أمان؟ وهل هذا البعيد عن مكامن الألم يمكنه أن يرى في هذه اللحظة ما لا يراه صاحب الوجع؟
هكذا دارت الأفكار في ذهني، وأنا أقف أمام البائع شاردة، أشاهد صورة يحيى السنوار على الغلاف، وأقتني روايته "الشوك والقرنفل"..
عن الرواية
في أغلب الروايات الفلسطينية، دائماً ما تقع أولاً على العائلة، ثرية التركيب، داخل البيت المتواضع المسقوف بألواح الزينكو، والمفتوح تماماً على الشارع الخانق، الذي يفضي بدوره إلى مجموعة أزقة، لا بد أن يخوض فيها المرء حتى يصل إلى خارج المخيم. وهناك في رحلةٍ عبر المكان والزمان، وفي مخاضٍ بين الوعي والوجع، يتبلور في ذهن صنفٍ حالمٍ من البشر، تصور محدد عن قضية بلاده وكيفية "التحرير".
في رواية "الشوك والقرنفل"، تجد نفسك تماماً هناك، في ذلك الخضم. وبينما لم يغب عنها البناء الدرامي المتماسك، فقد غلب عليها وعي صاحبها بقضيته، التي من أجلها فقط دلف من ضيق الزنزانة إلى رحابة الكتابة. بين صفحاتها، وعيٌ تستطيع تلّمُسه من السطر الأول وحتى الأخير. ثم تعبر من بعد الغلاف إلى حياة الكاتب، وما تحمله من فصول حية، مرئية وغير مرئية، حتى تصل إلى الفصل الأخير الأشد دوياً، فصل استشهاد السنوار الذي جاء ملء الكون، خارج الورق.
تشكلت لبنة هذا الوعي مع السنوات الأولى داخل مخيم خانيونس. تعلمتْ ساقه الخطو قبل حلول الموجة الثانية من الاحتلال في صيف حزيران/ يونيو عام 1967. واستمر بناء هذا الوعي على صعيدين: الأول في ضوء تفاعلات الحياة اليومية، الاجتماعية والسياسية، الممتدة داخل قطاع غزة، والثاني في حضور فكرة "المقاومة" توهجاً وخفوتاً.
ذكرى الانتفاضة الأولى: الحجارة والجسد في وجه الآلة العسكرية
11-12-2020
أرشيف الانتفاضة حيّ على إنستاغرام
08-10-2020
يعتلي هذا الوعي من بعد، درجاته الأعلى والأعتى، وذلك بدلوف صاحبه إلى تجربة السجن الطويلة المُبَكّرة، التي بدأت منذ العام 1988، بعد عامٍ واحد من انطلاق الانتفاضة الأولى ومشاركة هذا القيادي الشاب في تأسيس العمل المسلح، وتشكيل كتائب عزالدين القسّام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية ("حماس"). دخل السجن وهو في عمر الثانية والعشرين. لكنه عبر هذه الرواية يقدم لك تجربة عمر آخر يمتد حتى العام 2004، لا يضعك طوال هذه السنوات، داخل حدود الزنزانة ومشاعره فيها، أو تجليات تفكيره عبرها، بل يفعل ذلك عبر سردٍ متداخل، يأتي أغلبه على لسان شاب ينتمي إلى أسرة تضم قيادات حمساوية وفتحاوية في بيت واحد. يسرد تفاصيل الأحداث الرئيسية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المغتصَب. ويستخرج الدلالات.
في أغلب الروايات الفلسطينية، دائماً ما تقع أولاً على العائلة، ثرية التركيب، داخل البيت المتواضع المسقوف بألواح الزينكو، والمفتوح تماماً على الشارع الخانق، الذي يفضي بدوره إلى مجموعة أزقة، لا بد أن يخوض فيها المرء حتى يصل إلى خارج المخيم. وهناك في رحلةٍ عبر المكان والزمان، وفي مخاضٍ بين الوعي والوجع، يتبلور في ذهن صنفٍ حالمٍ من البشر، تصوّر محدد عن قضية بلاده وكيفية "التحرير".
تشكلت لبنة هذا الوعي مع السنوات الأولى داخل مخيم خانيونس. تعلمتْ ساقه الخطو قبل حلول الموجة الثانية من الاحتلال في صيف حزيران/ يونيو عام 1967. واستمر بناء هذا الوعي على صعيدين: الأول في ضوء تفاعلات الحياة اليومية، الاجتماعية والسياسية، الممتدة داخل قطاع غزة، والثاني في حضور فكرة "المقاومة" توهجاً وخفوتاً.
هي ليست تجربة أسير، ولكنها تجربة مقاوِم، في ظل جدل اجتماعي وسياسي متعدد الأصعدة؛ يبدأ برحلة طفلٍ صغير من حدود المخيم إلى بدايات المعسكر المصري، قبل العام 1967، كي يحصل على الحلوى من الجنود البسطاء، وتنتهي حين يضع الكاتب قلمه، مع استشهاد هذا الطفل، الذي صار قيادياً مقاوماً في العام 2004، يغادر الحياة محمولاً هو الآخر على أكتاف البسطاء.
"الشوك والقرنفل"، رواية محمّلة بنظرة ثاقبة من عين مراقب، نظرة من قلب الاشتباك لا الانزواء، من أكثر النقاط عمقاً، وأكثرها انكشافاً وكشفاً، من داخل زنزانة الاحتلال.
يقول السنوار: "هذه ليست قصتي الشخصية، وليست قصة شخص بعينه، على الرغم من أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك، الخيال في العمل فقط هو في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين، ما غير ذلك فكله حقيقي، عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه، هم أهلهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة".
عن الرؤية
"إبراهيم" هو الاسم الذي اختاره السنوار للبطل الخفي، الذي يظهر على مهلٍ في روايته. وهو ابن عم "أحمد" الراوي الذي كان يصاحبه في رحلة الطفولة إلى معسكر الجيش المصري، وهو من كان ينتظره ليتقاسم معه رغيف اللحم، الذي تمنحه الوكالة تحت اسم "الطعمة" لأطفال المخيمات الأقل حظاً في التغذية السليمة.
لا يروي الشاب الثلاثيني "أحمد" كل الرواية، فكثيرٌ ما يَحضر صوتٌ خارجيٌّ غير مُعرّف، هو صوت المراقِب الذي يسرد في إسهابٍ عشرات وعشرات من عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 حتى مطلع الألفية الثالثة، حيث تنتهي أحداث الرواية.
الخلاف حول ثغرة الدفرسوار
28-12-2023
حرب الاستنزاف كما رآها الجنود: شهادة
20-05-2024
خريطة تستحق التأمل، بدءاً من "أبو حاتم"، الصول السابق في جيش التحرير، التنظيم العسكري التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعمله على قيادة الفدائيين داخل المخيمات في قطاع غزة فور انتهاء حظر التجوال بعد انتهاء حرب الأيام الستة، مروراً بعمليات الطعن والقنص لفدائيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية والداخل، ومن ثم انطلاق معركة الكرامة في الأردن للعام 1968، وانعكاس ذلك على انتعاش العمل المسلح في الأراضي المحتلة على يد حركة "فتح"، وصولاً إلى ألق العبور المصري في تشرين الأول/ أكتوبر 1973، ثم انكساره بتوقيع معاهدة السلام في العام 1979، وانعكاس خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان بداية الثمانينيات، ثم الانتقال إلى سلسلة عمليات كفاح مسلح فردية بالطعن، على يد شباب كتائب حركة الجهاد الإسلامي، ثم وصول الاحتجاج السياسي الميداني إلى أعلى مداه، مع انطلاق الانتفاضة الأولى بالحجارة، وإرهاصاتها، ودور حركة حماس الواسع في تنظيمها، ثم الانطلاقة القوية ودلوفها للعمل المسلح الذي استمر على يدها ويد غيرها، على الرغم من توقيع اتفاقية أوسلو... ومن ذلك كله إلى حجم ما تعرضت له المقاومة من ضربات جراء "السلطة الفلسطينية" والتنسيق الأمني...
ليس هذا فقط، بل يَعد إلى كيف - بعد تعثر هذا المسار، برفض ياسر عرفات التوقيع على تنازل عن حق العودة والقدس في العام 2000 - انخرطت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح هي الأخرى، في أعمالٍ مسلحة.
لا يستهدف السنوار، في كتابته المستطرِدة، التأكيد أن المقاومة المسلحة هي السبيل الرئيسي بل الوحيد للتحرر في مثل هذا النوع من القضايا الوطنية شديدة التعقيد، بل أنها هي الأكثر تعقيداً في تاريخ البشرية. لا يستهدف ذلك وحده، ولكنه على أرضية السرد التاريخي، تتجلى قضايا خلافية ومعادلات رئيسية، يعرضها غالباً في صيغة حوار جدلي بين طرفين، يعرض كل منهما ما لديه حتى تَفرض عليهما الأحداث الانتقال إلى مربعٍ آخر، يصمت فيه الجدل ويعلو صوتان: السلاح والألم. السلاح الذي يندر الوصول إليه، والألم الذي لا أكثر منه.
الموقف من التفاوض مع العدو وانعكاسه على كل التفاصيل، قضية أساسية، وكذلك إدارة علاقة الاشتباك مع العدو. كيف يمكن فهمها، وكيف يجب التعامل معها.
إدارة الاشتباك مع العدو
يلتفت باحث العلوم السياسية طارق حمود إلى تفصيلةٍ قد تبدو هامشية، لكنها بكل حال تستحق التوقف أمامها. يقول "في صورةٍ مسربة للسنوار من داخل السجن، رأيته يرتدي ساعة اليد، وتساءلت يومها ما حاجة هذا الرجل المحكوم عليه بالحبس ثمانين عاماً لمعرفة الوقت؟". ثم يستدرك الباحث ويطرح نقطتين أخريين، الأولى هي آخر ما نطقه السنوار قبل أن يخطو من باب السجن؛ قال: "وعدٌ مني ما أكون السنوار إلا لو حررتكم". وأول ما قاله لمن لاقوه عند أبواب غزة: "لماذا لم تحرروا فلسطين حتى الآن؟".
دخل السنوار السجن ليس فقط لاتهامه بقتل جنديين محتلين، ولكن لقتل فلسطينيين أدانتهم فصائل المقاومة بالخيانة. وتاريخ الرجل يشير إلى تشكيله نواة الجهاز الأمني لحركة حماس، الذي عرف آنذاك باسم "مجد".
يَعد في الرواية إلى كيف - بعد تعثر المسار، برفض ياسر عرفات التوقيع على تنازل عن حق العودة والقدس في العام 2000 - انخرطت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح هي الأخرى، في أعمالٍ مسلحة.
يصف مشهد الاحتكاك الأول مع العدو، وقيادته مجموعة شبابية صغيرة، انطلقت من غزة وحتى المسجد الأقصى، للمشاركة في الوقوف على أبوابه، لمنع مرور المستوطِنين. لم يأتِ الصهاينة في ذلك اليوم، وعاد "إبراهيم" إلى قطاع غزة وفي يده العصا التي لم يستخدمها، لكنه تعهد أمام نفسه بألا يفلتها بعد هذا اليوم. هكذا نقرأ بأثرٍ رجعي، بعد أن شاهدنا عصا السنوار الأخيرة، يلقى بها العدو في لحظة الاستشهاد.
عبر الرواية تجد ظلال هذه القضية التي يراها صاحبها شائكة، فتتابع شخصية "ابراهيم" شديد الهدوءِ واللطف والحزم والعصامية، وقد واجه أولى المشكلات الدرامية مع شقيقه الذي شاركه مشاعر اليتم ثم تحوّل تدريجياً ليصبح عميلاً للصهيونية. هنا بدأ ارتباط "إبراهيم" التدريجي بجماعة الشيخ "أحمد ياسين"، من باب التدين أولاً، والقناعة الوطنية بحتمية تحرير الأرض ثانياً. وكانت أولى العمليات المباشِرة هي جمع المعلومات الاستخباراتية حول العملاء، وأن تكون رصاصة التصفية الأولى في قلب أخيه. وهكذا يطرح السنوار مبكراً قضية "أن ثلثي الرصاص للخاين"، لكنه لا يطرحها فحسب، بل يُسهب في طرح الجدل ما بين خطورة وجود هؤلاء ودورهم في تصفية موجات من المقاوِمين، وبين كيفية ضبط هذه الملاحقة، وأن تتسم بالحرص والحسم واللاوحشية.
دروس أخرى وكثيرة ستتوقف عندها كثيراً وأنت تقرأ الآن، و"طوفان الأقصى" لم يضع بعد أوزاره. لعل من أولها مشهد الاحتكاك الأول للبطل مع العدو، وقيادته مجموعة شبابية صغيرة، انطلقت من غزة وحتى المسجد الأقصى، للمشاركة في الوقوف على أبوابه بالطوب والشوم والجنازير، لمنع مرور المستوطِنين, لم يأتِ الصهاينة في ذلك اليوم، وعاد "إبراهيم" إلى قطاع غزة وفي يده العصا التي لم يستخدمها، لكنه تعهد أمام نفسه بألا يفلتها بعد هذا اليوم. هكذا نقرأ بأثرٍ رجعي، وبعد أن شاهدنا عصا السنوار الأخيرة، يلقى بها العدو في لحظة الاستشهاد.
دروسٌ أخرى عن علاقة المقاومة بالمخيم، حيث هذه الجدليات التي اعتادها كل فلسطيني عن العلاقة العكسية تارة، والطردية تارة أخرى، بين اتساع الأفق وضيق الزقاق.
يحكي السنوار ضمن ما يحكي، عن صعوبة الحصول على السلاح من أجل المقاومة، ورحلات جمعه وشذبه وتدريب القادرين على حمله، وعن شجرة الزيتون التي أريق دم الشهيد عماد العقل تحتها، فاعتاد الشباب على الذهاب إلى أكل ثمرها وتلمس المدد.
هى مراحل تشكل الوعي إذاً في كيفية مواجهة العدو. منذ تَخفّي المجاهدين الأوائل في أزقة المخيم، وتعرض أهله لعقاب جماعي إثر ذلك، واكتشافهم بعد رفع حظر التجوال، أن الحياة تسري بشكل طبيعي خارجه في المدن القريبة، وكأن شيئاً لم يكن... محاولة إسرائيل التدخل في هذه المساحة الشائكة، ولكن بشكلٍ ناعم، من خلال السماح للفلسطينيين بالعمل داخل الأرض المحتلة. وهذا الجدل بين الاحتياج الضاغط والتحلل المحتمل، وكيف أن الأمور جميعها تسري في دائرة واحدة. فهذا التراخي الذي صاحب مناخ العمل إلى حد تنامي العملاء كان بعد عقدٍ كامل مدخلاً لعمليات طعن مباشر في الداخل عبر الاندساس بين العمال، أو اصطياد الصهاينة المتبضعين في أسواق غزة. وهي مهدت بشكل أو بآخر لانطلاق الانتفاضة الأولى.
ومن جامعة بيرزيت إلى الجامعة الإسلامية في غزة، كانت الدروس الأقوى والأشد وضوحاً. يرسم الراوي صورة المدرعة التي تتحرك باتجاه باب الجامعة، فتقتلعه وتتقدم باتجاه الطلاب. وهنا يكون دور القائد إقناع الجميع بخطورة التراجع، ومن ثَم يكثِّفون معاً إلقاء الحجارة، ليكتشف قائد المدرعة أنه يتقدم وحده بينما الجنود من خلفه يتقهقرون.. فيتقهقر معهم.
الدرس الثاني كان مع الدبابة التي باغتتهم من الخلف. تكسر الجدار مع اقتراب الليل، وتتقدم نحو الطلاب المعتصِمين. يقول: "يستدير نحو سبعمئة ويجرون كالمجانين جرياً سريعاً باتجاهها، كانت مسافة مئة متر بينهم، كان واضحاً لفريق الدبابة أنهم سيحصدون العشرات تحت المجنزرات، ولكنها دقائق وتصبح هذه الجموع أيضاً فوق الدبابة تحاصرها من كل جانب".
ثم كان الدرس الثالث والأهم، حين صدحت مكبرات المساجد مع آذان العشاء، تطالب أهل القطاع بالخروج الفوري من أجل دعم طلاب الجامعة المحاصَرين، فخرجت المظاهرات، واشتعلت إطارات السيارات وأقيمت المتاريس، وعرف العالم للمرة الأولى هذا التعبير الجليل "انتفاضة الحجارة".
من جامعة بيرزيت إلى الجامعة الإسلامية في غزة، كانت الدروس الأقوى والأشد وضوحاً. يرسم الراوي صورة المدرعة التي تتحرك باتجاه باب الجامعة، فتقتلعه وتتقدم باتجاه الطلاب. وهنا يكون دور القائد إقناع الجميع بخطورة التراجع، ومن ثَم يُكثِّفون معاً إلقاء الحجارة، ليكتشف قائد المدرعة أنه يتقدم وحده بينما الجنود من خلفه يتقهقرون.. فيتقهقر معهم.
من الشعب وإليه. يؤكد السنوار تباعاً، على لسان بطله الذي يدور في الشوارع، يتابع الحركة الجماهيرية، ويؤكد لصاحبه صدق حدسه بأن الجماهير حاضرة، ولم يفسدها ما سعى إليه الاحتلال على مدار عشرين عاماً. لكنه يؤكد في الوقت نفسه بأن العمل الجماهيري وحده لا يكفي، فدوماً وأبداً لا بد من السلاح من أجل التحرير.
هكذا هي الملامح لخريطة المواجهة، التي ظل يعتنقها الرجل بكل وضوح، حيث لا تراجع في ساحة الاشتباك، ولا استمرار من دون احترافية في وضع التكتيكات، ولا مقاومة من دون حاضنة شعبية. إلا أن تناقضاً رئيسياً يطرح نفسه، ومعه نتلمس الرافد الثاني في وعي هذا الرجل بقضيته، أي مسار التسوية السياسية.
الموقف من مسار التسوية السياسية
يستفيض الرجل في طرح موقفه من خلال نقاش جدلي مستمر بين إبراهيم، وابن عمه، القيادي الفتحاوي، محمود، فور توقيع "اتفاق أوسلو" بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1993.
بالنسبة إلى محمود، فأوسلو مرحلة اضطرارية، خاصةً في ظل خفوت حضور انتفاضة الحجارة جماهيرياً، واتّجاه الأنظار إلى حرب الخليج الأولى. كما أنها ستسمح بعودة ثوار فتح إلى الداخل وتتيح، في ظل مواءمات دولية بعينها، الانسحاب من القطاع والضفة، ومن ثم بدء المرحلة الثانية من مفاوضات "الأرض مقابل السلام"، من أجل إعلان الدولة الفلسطينية.
على الجانب الآخر، يقول إبراهيم نصاً: "منحتم الاحتلال السلم للنزول من على شجرة الاستهداف، كانوا سيخرجون رغماً عنهم، تحت وطأة الكفاح المسلح، لكنكم جعلتم ذلك مرتهناً باتفاقات وتنسيق، وأصبح دوركم تقويض المقاومة".
الدرس الثاني كان مع الدبابة التي باغتتهم من الخلف. تكسر الجدار مع اقتراب الليل، وتتقدم نحو الطلاب المعتصِمين. يقول: "يستدير نحو سبعمئة ويجْرون كالمجانين جرياً سريعاً باتجاهها، كانت مسافة مئة متر بينهم، كان واضحاً لفريق الدبابة أنهم سيحصدون العشرات تحت المجنزرات، ولكنها دقائق وتصبح هذه الجموع أيضاً فوق الدبابة تحاصرها من كل جانب".
كان الدرس الثالث والأهم، حين صدحت مكبرات المساجد مع آذان العشاء، تطالب أهل القطاع بالخروج الفوري من أجل دعم طلاب الجامعة المحاصَرين، فخرجت المظاهرات، واشتعلت إطارات السيارات وأقيمت المتاريس، وعرف العالم للمرة الأولى هذا التعبير الجليل: "انتفاضة الحجارة".
يعرض "السنوار" عبر روايته مآل "سياسة التنسيق الأمني"، وكذلك الحرب الضروس بين سلطة أوسلو وفصائل المقاومة المسلحة: اعتقالات موسعة جراء استمرار العمليات النوعية على الرغم من قيام السلطة، تبادل اتهامات بين قيادات فتحاوية ترى أن هناك إمعاناً حمساويّاً في إفشال مسارها، وأنه بسببهم وحدهم صعد صوت اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، إلى سدة الحكم في الكيان الصهيوني، بدلاً من شيمون بيريز عام 1996.
أما معارضو "أوسلو" من كافة الفصائل، على تنوعها، ففضلاً عن رفضهم لمنطق التسوية الذي يرونه قد فُرِض عليهم فرضاً، وأهدر تضحيات ونضالات شعبية، فهم كذلك على قناعة كاملة، بأنه لولا استمرار العمليات النوعية بعد توقيع الاتفاقية، لما خرج جيش الاحتلال.
وبين هذا وذاك، صعد لسدة المشهد إيهود باراك، خليف بيريز، والصوت الأقل تطرفاً وفق تقديرات. وفي وجوده أعلن الرئيس الراحل "ياسر عرفات" من منتجع كامب ديفيد الأميركي عام 2000 عن فشل مسار "أوسلو"، وأنه لا يمكنه التنازل عن "حق العودة" و"القدس" عاصمةً لدولة فلسطين، لتشتعل الأرض المحتلة بانتفاضة ثانية.
من فوق سرير حديدي داخل أحد سجون السلطة الفلسطينية، يجلس "إبراهيم" من دون انفعالٍ زائد، لا غضباً وخوفاً من تكرار قصف الاحتلال عنابر السجون للتخلص من مقاوِمين سابقين قد تفكر السلطة في إطلاق سراحهم الآن، ولا تفاؤلاً وفرحاً بأن التفاف جميع الأطياف في تلك اللحظة، يبشر ببداية جديدة لحرب التحرير وتجدد الثورة الفلسطينية.
من فوق سريره قال لرفيقه: "هذا هو حالنا. أرواح ودماء أبناء شعبنا أصبحت حقلاً لتجارب أوسلو، فإن تنجح بها نعمت، وإذا لم تنجح، فلا مانع أن نبدأ من نقطة الصفر. كل تضحيات الانتفاضة الأولى ذهبت هدراً. والآن وصلت الأمور مع السياسيين والمفاوضين لطرق مسدودة. فما المانع أن تبدأ تجربة من جديد!! آلاف الشهداء سيسقطون ثم تجد من يأتي ليطرح "أوسلو جديدة". وهكذا بعد كل جولة كفاح وجهاد لشعبنا، يأتي السياسيون ليقطفوا الثمرة. ولأنهم يسارعون في قطفها قبل أوانها، فإنهم يعاقَبون بحرمانها. فلا الثمرة تبقى على الشجرة حتى تنضج، ولا يُنتفع بها حين قطافها المتعجل".
بعض الرؤية
على الرغم من الوضوح الشديد في الرؤية في سطور "السنوار"، والمراوحة بين قضيتي "الكفاح المسلح" و"التسوية السياسية"، بل والتعريج على قضايا رئيسية أخرى كإشكالية "الديمقراطية"، ومن له حق تمثيل الشعب الفلسطيني واتخاذ القرار، على الرغم من ذلك، فإن المسار الفكري للرجل قد وجد نفسه بكل تأكيد على محك الاختبار العملي، حين أغلق غلاف النهاية في روايته، ومضى في طريقه إلى الإعداد بصحبة الرفاق لإطلاق "الطوفان"، بعد ما يقرب من عقدٍ من الزمن. ثم جاء رحيله عبر الاستشهاد قبل أن تنتهي المعركة، وقبل أن يعلِّق هو بقولٍ أخير.
هكذا هي الملامح لخريطة المواجهة، التي ظل يعتنقها الرجل بكل وضوح، حيث لا تراجع في ساحة الاشتباك، ولا استمرار من دون احترافية في وضع التكتيكات، ولا مقاومة من دون حاضنة شعبية. إلا أن تناقضاً رئيسياً يطرح نفسه، ومعه نتلمس الرافد الثاني في وعي هذا الرجل بقضيته، أي مسار التسوية السياسية.
ملامح هذا الاختبار العملي، يمكن التقاطها في اقتباسٍ أخير، من جدلٍ آخر بين أبناء العمومة القيادييَن "الفتحاوي" و"الحمساوي"، ننهي به هذا النص من دون تعليق إضافي:
- إبراهيم: "الصهاينة لن يعطونا شيئاً، إلا وأحذيتنا على رقابهم، وبنادق المقاومة تحصدهم.
-صرخ محمود قائلاً: "ماذا تقول يا رجل!! إن كانت الحسابات بهذه الصورة، فإسرائيل قادرة على سحقنا في دقائق.
-ضحك إبراهيم قائلاً: "إذاً فلماذا لم تسحقنا؟ إن معادلات المعركة ليست عسكرية مادية بحتة، فإسرائيل تدرك أن وراءنا أمة عربية إسلامية، ولو مفككة، ولكن لو استخدمت ضدنا القوة بصورة زائدة فإن موازين الكون سوف تنقلب. إسرائيل غير قادرة على سحقنا، إنها تدرك كونها محكومة بمعادلات كثيرة، وكسر أية معادلة منها من أجل سحقنا تعني أنها ستنسحق هي الأخرى".