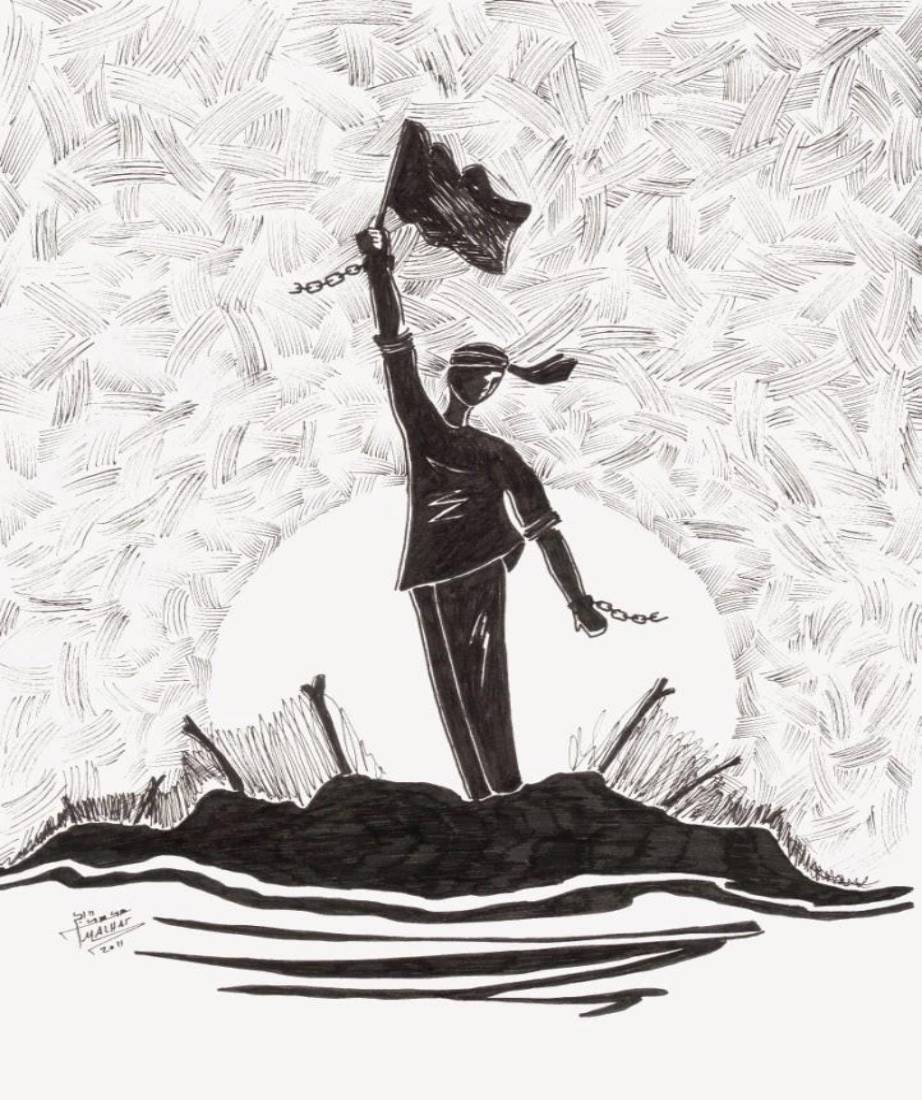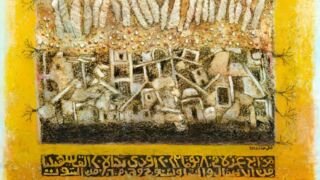لم يكد الفلسطينيون يستقبلون بفرح خبر وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير، متأملين فرصة لالتقاط أنفاسهم بعد خمسة عشر شهراً مروّعاً من الحرب والاضطراب، حتى استعرت المعركة الأوسع مع الاحتلال في الضفة الغربية، قاطعة عليهم فرحتهم.
لقد عُقدت صفقات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي بغية تمرير قرار وقف إطلاق النار، وتجاوُز اعتراضات واستقالة "إيتمار بن غفير"، أحد أكثر أعضاء الائتلاف تطرفاً. وبموجب جزء من تلك الصفقات، وافقت الحكومة على إضافة هدف حرب جديد إلى الأهداف التي وُضعت سابقاً لقطاع غزّة. استلزم ذلك "تحولاً في مفهوم الأمن وإطلاق حملة للقضاء على الإرهاب" و"حماية المستوطنات والمستوطنين" في الضفة الغربية، كما أعلن بثقة وزير المالية (ونائب وزير الدفاع الإسرائيلي) "بتسلئيل سموتريتش". لكنّ حزب "سموتريتش"، القومي الديني، لم ينسحب من الحكومة. ويظهر أن هدف ذلك الاحتفاظ بشيء من النفوذ في الفترة التي تسبق المرحلة الثانية من مخطط وقف إطلاق النار، ولعرقلة تنفيذها إن أمكن. في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، يمكن رصد تحوّل مزلزِل في استراتيجيات ال"نيو-صهيونية، من سياسة "الاحتواء غير المتكافئ" التي أثبتت نجاحها لسنوات طويلة، إلى محاولات التهجير القسري ("الترانسفير") التي تفوقها عنفاً، بما لا يقاس.
الضفة الغربية ساحةُ حرب
منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، اضطربت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل عنيف، إثرَ هذا التحول في سياسة الحرب الإسرائيلية. بالطبع، كان الوضع متوتراً وعنيفاً بالفعل في جميع أنحاء الضفّة، فقد قُتل نحو 1000 فلسطيني هناك على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وسُجن أكثر من 5000، كما دمّر الجيش الإسرائيلي مخيمي "جنين" و"طولكرم" للاجئين. مع نهاية عام 2023، ارتفع عدد الحواجز والمعابر الإسرائيلية بين المناطق الفلسطينية من 550 إلى أكثر من 700 مع اشتعال الحرب على غزة، ثم ارتفع عددها إلى نحو 870 بحلول نهاية عام 2024. وتعرض اقتصاد الضفة الغربية لخضّة كبيرة، فخسرت 30 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي (GDP) خلال العام الماضي، وتضاعف معدّل البطالة، فصار أكثر من ثلث القوة العاملة حالياً عاطلاً عن العمل.
خلال الأسبوعين الأولين بعد وقف إطلاق النار، أضيف 20 حاجزاً ومعبراً جديداً، وكُثِّفت عمليات التفتيش الجسدي الانتهاكي عند نقاط التفتيش، وتمت جدولتها عند أوقات الذروة المرورية. صار التنقل بين المدن والقرى شبه مستحيل لمئات آلاف الفلسطينيين، كجزء من سياسة تقول إسرائيل أنها ستبقى سارية لستة أسابيع على الأقل، من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
في هذه الأثناء، استمرت الهجمات المنظّمة التي يشنها المستوطنون ضد منازل الفلسطينيين وسياراتهم ومتاجرهم في القرى المعزولة، بينما يقف الجيش الإسرائيلي متفرجاً. بشكل موازٍ، أعادت عشر كتائب عسكرية إسرائيلية انتشارها من غزة إلى الضفة الغربية، مع بدء هجوم عسكري كبير في 20 كانون الثاني/يناير المنصرم على مخيم "جنين"، بغية القضاء على خلايا المقاومة التي لا تزال تنشط فيه، ولتسوية المخيم بالأرض في الوقت نفسه.
تسارَع المسار الاسرائيلي القائم اليوم في ظلّ التخبط الذي أصاب الإسرائيليين في " 7 اكتوبر"، إذ كانوا جاهزين لقبول السرديّة حول تهديدٍ وجودي، لا يمكن دفعه إلا من خلال وسائل لم يسبق استخدامها. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يدرك الإسرائيليون أن تدمير "غزة" والحدّ من تهديد "حماس" المباشر لم يؤدّيا إلاّ إلى نقلهم إلى مرحلة أخرى من حربهم الطويلة مع الشعب الفلسطيني.
ويظهر أن ضمان مرور اتفاق وقف إطلاق النار تطلّب مقايضاتٍ سياسية إسرائيلية كبيرة على شكل وعود أو التزامات قُدِّمت، أو على شكل خداع مُورس بين أعضاء الائتلاف. لكن وبكلّ الأحوال، فإسرائيل ملزَمة بالشروط التي وقَّعتها حول غزة، ولا يَحتمل وضعها الحالي كلفة تنفير إدارة أمريكية جديدة متعاطفة علناً معها بهذا الشأن. خفتت الجلَبة الغوغائية المعتادة لكل من "سموتريتش" و"بن غفير" بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، فيما يُعوِّل المسؤولون الإسرائيليون على دعم الولايات المتحدة لمتابعة خطوات الضمّ الإسرائيلية لِلأرض التي يعتبرها بعض المسؤولين الأمريكيين أيضاً "يهودا والسامرة" التوراتية (جزء مما يُسمى "أرض إسرائيل")، لا أرضاً "محتلة" ولا "فلسطينية"، كما هو التعريف الدولي للضفة الغربية. وإن غالى ترامب بحشو إدارته بالموظفين المؤيدين للاستيطان، وإحاطة نفسه بهم، إلا أن المعايير الواضحة للسياسة الأميركية تجاه الضفة الغربية لم تُقرّ بشكل رسمي بعد. إذاً، قد تجد إسرائيل نافذة للعمل على توسيع نطاق ما تسميه "النصر الكامل"، وربما للتقدم لتحقيق هدف واحد دون الوصول إلى أهدافها الأُخرى بالضرورة.
لقد تلقّف الدنماركيون والمكسيكيون والكنديون والبنميون، بتهكّم، شهية ترامب المفتوحة على إعادة تسمية المناطق والدول بأسماء غير تلك المقبولة والمعترف بها دولياً (أو حتى الاستحواذ عليها)، بحيث لا يمكن للفلسطينيين بدورهم إلا أن يقابلوها بابتسامة مريرة. لكنّ محاولة إعادة تقييم وتحديد مدى المخاطر بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، على خلفية المفاهيم اليهودية-المسيانية والمسيحية-الإنجيلية للواقع والحقيقة والعدالة، هي بمثل صعوبة نجاح إسرائيل في تحقيق "نصرها الكامل" الأجوف، الذي لا يكاد يقترب من شكله الذي سعت إليه في غزة على مدى 15 شهراً من الحرب.
بالفعل، فبمجرد استجابة إسرائيل للضغوط الشعبية للعمل على تحقيق إطلاق سراح الرهائن، مؤجِّلة الاستهجان الدولي للحصيلة المروعة للحرب على غزة، قامت في المقابل بفتحِ جبهة جديدة في الضفة الغربية تهدد بالانزلاق إلى دوامة من الدمار والمقاومة المسلحة على غرار ما حدث في غزة، بدءاً من "جنين". يزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، "كاتس"، أن السياسة الجديدة في الضفة الغربية تهدف إلى "ضمان عدم عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية ـ وهو الدرس الأول المستفاد من أسلوب الغارات المتكررة في غزة". وقَف "كاتس" فوق أنقاض مخيم "جنين"، الذي طردت إسرائيل 20 ألفاً من سكانه وهدمت نحو 100 منزل فيه خلال عشرة أيام فقط، وتوعّد بالبقاء فيه، وأخذ المعركة إلى "معسكرات إرهابية" أخرى، على حدّ تعبيره.
لا يبدو هذا الدرس منطقياً على الإطلاق إذا أخذنا بالاعتبار إعادة إحكام حماس سيطرتها العسكرية على الأرض في غزة في الأسابيع الماضية. إذاً، بعيداً عن الحسابات الفجّة حول كيفية ضمان "نتنياهو" لاستمرار حياته السياسية، أو كيفية تحقيق الكتلة الاستيطانية لأقصى استفادة من فترة تواجدها في الحكومة، كيف علينا أن نفهم أهداف الحرب الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية؟ هل هناك أفق لوقف إطلاق نار محتمل في الضفة الغربية أيضاً؟
"سموتريتش" يدخل المشهد
"بتسلئيل سموتريتش" هو الزعيم المتعصب للّوبي الاستيطاني واسع النفوذ في الحكومة الإسرائيلية، والذي يدفع باتجاه الضمّ "القانوني" من خلال بسط السيادة الإسرائيلية إلى مناطق من الضفة الغربية لم تعترف إسرائيل قطّ بأنها محتلة، بل تصفها بالـ"متنازع عليها". بالفعل، كرّس سموتريتش حياته السياسية وعلّة وجوده صراحةً لتوسيع المشروع الاستيطاني بالقوة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط في المنطقة (ج) التي تسيطر عليها إسرائيل بموجب "اتفاقيات أوسلو"، والتي صار الاستيطان فيها واقعاً بالفعل، مع أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي (بالإضافة إلى 350 ألف مستوطن في القدس الشرقية). تجلّى مذهب "سموتريتش" الاستيطاني في مطالبه المتعلقة بسياسة الحرب على غزة، من خلال دعمه للأعمال الإباديّة مثل التطهير العرقي، الذي يُسمّيه تلطيفاً "التهجير الطوعي". كما أن موقف "سموتريتش" كان بالتصلّب نفسه في ما يخصّ إصراره على منع قيام الدولة الفلسطينية أو أيّ حكم وطني، من خلال الاستيلاء المتكرر على أموال السلطة الفلسطينية، والتعدي على نطاق سلطتها المحدودة أصلاً في 40 في المئة فقط من الضفة الغربية (و100 في المئة من سكانها الفلسطينيين).
منذ "اتفاق أوسلو"، كان كثيرون يعتقدون أن هدف إسرائيل هو إقامة دولة ذات أغلبية يهودية، مستقرة ومعترَف بها عالمياً، وبالتالي إنهاء الصراع. لكن لو كان ذلك هو الهدف بالفعل، لكانت إسرائيل قد سارعت إلى تنفيذ حل الدولتين. أما إذا كان الهدف الإسرائيلي الأساسي هو ترسيخ "الحقوق غير المتساوية"، فإن حل الدولتين يحقق عكس ذلك في الواقع.
يُنظر إلى "سموتريتش" على المستوى الدولي كمتطرفٍ تحرّكه دوافعه "المسيانية"، المستندة إلى أيديولوجية سياسية توراتية، أي كاستثناء لقاعدة "إسرائيل الليبرالية والديمقراطية". لكن في إسرائيل، نجح "سموتريتش" وحلفاؤه إلى حد كبير في تضمين نموذجه من الصهيونية داخل العقيدة الإسرائيلية الاستراتيجية والعسكرية، وتعزيز تجريد الفلسطينيين من الإنسانية في الخطاب العام، وإعادة تكريس الوجه القبيح لإسرائيل العسكرية-التوسعية. هذا المسار سابق لعام 2023 بوقت طويل، لكنه تسارع وتمّ التطبيع معه في ظلّ التخبط الذي أصاب الإسرائيليين بعد "السابع من أكتوبر". كان الرأي العام الإسرائيلي جاهزاً لقبول سرديّة مبالغٍ فيها حول تهديدٍ وجودي للشعب اليهودي، لا يمكن دفعه إلا من خلال وسائل لم يسبق استخدامها ،وعلى نطاق غير مسبوق.
قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يدرك الإسرائيليون أن تدمير غزة والحدّ من تهديد "حماس" المباشر لم يؤدّيا إلا إلى نقلهم إلى مرحلة أخرى من حربهم الطويلة مع الشعب الفلسطيني. لكن، للأسف، قد يستغرقنا الأمر وقتاً أطول لاستيعاب أن المشروع الوطني الإسرائيلي كما صاغه "سموتريتش" يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الوطني الفلسطيني. يدرك بعض الناس في إسرائيل بالفعل مخاطر ترك مستقبل دولتهم تحت رحمة أيديولوجيين مغامرين مثل "سموتريتش"، إذ لن يؤدي ذلك إلا إلى تسريع التدهور الداخلي لإسرائيل وانهيار شرعيتها الدولية. ولكن قراءة حالة "سموتريتش" باعتباره ظاهرة استثنائية عابرة في السياسة الإسرائيلية (التي اعتادت أن تشهد تقلباتٍ بين اليمين واليسار) تؤدي إلى إغفال الفكرة الأساسية. فهذا رجل عازم على تحقيق مهمّةٍ يُحضِّر لها منذ سنوات – مهمّة شهدت أول تطبيق عملي لها تحت النار في غزة. كما يبدو أنه على استعداد لخوض التجربة مجدداً في الضفة الغربية. بالنسبة "لسموتريتش" ونهجه الصهيوني، فإن حملات الإبادة الجماعية هي الخيار الوحيد. هو استنتاج بات يشاركه فيه حتى المؤرخ الصهيوني الليبرالي "بيني موريس".
منذ عام 2017، كان سموتريتش يدفع بـ"خطة الحسم" لضمّ الضفة الغربية وفرض السيادة اليهودية عليها، وقد أتاحت الحرب على غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فرصة وافرة له لتوضيح مفهومه حول دولة إسرائيل. حسب تعبيره: "إنّ دمج الضفة الغربية في إسرائيل... سيتمّ من خلال عمل سياسي-قانوني، يبسط السيادة على كامل "يهودا والسامرة"، بالتزامن مع الأعمال الاستيطانية: أي إنشاء المدن والبلدات". وتوضِّح الخطة صراحةً الشروط التي ستفرضها الصهيونية الدينية على الفلسطينيين الراغبين بالاستمرار في العيش في وطنهم، وترسم تصوّراً "ديستوبياً" عن ذلك - باعتبار الصعود الصاروخي ل"سموتريتش" منذ طرحه أفكاره التي كانت قبلاً لا تلقى سوى قلة من الآذان الصاغية. فبعد أن يتخلى الفلسطينيون عن طموحاتهم الوطنية، سيكونون أمام ثلاثة خيارات: أ- يمكنهم قبول وضعهم كمواطنين خاضعين لإسرائيل ومحرومين من الجنسية، يحكمون أنفسهم مناطقياً، أي على مستويات ما-دون-وطنية. ب - يمكنهم "الانتقال الطوعي" إلى دول أخرى، بتمويل وتسهيلات إسرائيلية. ج - أمّا من يختار المقاومة، فسيتعامل معه جيش الدفاع الإسرائيلي كما تقتضي الضرورة.
حماس وسكان غزة لم يقبلوا بوضعهم كشعب محاصَر وتحت رحمة إسرائيل. بل على العكس من ذلك، كان "السابع من أكتوبر" بمثابة هروب جماعي من السجن، ورفضاً قاطعاً لقبول مثل هذه الشروط. كما أن المخاوف والمخاطر الحقيقية المتمثلة في تهجير الفلسطينيين بالقوة أو انتقالهم تلقائياً إلى شمال سيناء، خلال أعتى معارك الحرب المستعرة، قد تَحطمت مقابل الرفض المصري والعربي للانخراط في مثل هذه المخططات.
جاء "السابع من أكتوبر" طوفاناً حقيقياً عطّل التسوية السياسية القائمة على "الاحتواء غير المتكافئ" من خلال عدة طرق جوهرية. فقد أثبت أن استراتيجية "جزّ العشب" لم تعد مضمونة النجاح. فمع تطور تكنولوجيا الحرب، أصبح بالإمكان تصنيع أسلحة فعالة، كالصواريخ والطائرات المسيّرة، داخل مصانع صغيرة أو تحت الأرض، في منشآت صناعية-عسكرية موضعيّة، وهو ما حدث في غزة وفي لبنان مع "حزب الله".
إذا كانت كتلة "سموتريتش" قد رأت في الحرب فرصة بالفعل لتنفيذ مراحل "خطة الحسم" بشكلٍ متزامن، فالواقع يقول أنه وبعد 15 شهراً، لم يتحقق أيّ من أركانها الثلاثة. وبكل تأكيد، فحماس وسكان غزة لم يقبلوا بوضعهم كشعب محاصَر نهائياً تحت رحمة إسرائيل. بل على العكس من ذلك، كان السابع من تشرين الأول/أكتوبر بمثابة هروب جماعي من السجن، ورفضاً قاطعاً لقبول مثل هذه الشروط. كما أن المخاوف والمخاطر الحقيقية المتمثلة في تهجير الفلسطينيين بالقوة أو انتقالهم تلقائياً إلى شمال سيناء خلال أعتى معارك الحرب المستعرة، قد تحطمت مقابل الرفض المصري والعربي للانخراط في مثل هذه المخططات. وحتى في حين يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن مصر والأردن سوف يمتثلا لنسخته من التطهير العرقي ("سوف يفعلون ذلك، حسناً؟")، فإن الاعتراض على هذه الفكرة يتسع في مختلف أنحاء العالم العربي. وأخيراً، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد أتى بكل عتاده وعديده لمواجهة المقاومة المسلحة في غزة، إلا أنه تكبد خسائر قاسية حتى الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، في حرب عصابات اعترف خبراء الجيش الإسرائيلي بأنها تحولت إلى "فييتنام إسرائيلية".
نهاية سياسة الاحتواء غير المتكافئ
إذاً، فأوّل الاستنتاجات القاسية هو أنه على الفلسطينيين أن يتوقعوا أن تكون أهداف الحرب والعمليات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية متّسقة مع أهداف واستراتيجيات حركة الاستيطان وخطة "سموتريتش"، كما مع "عقيدة جباليا" الجديدة التي تُنظِّر للتدمير المدني الكامل. من الواضح أن إسرائيل لم تعد ترى الاحتواء غير المتكافئ كاستراتيجية مستدامة، سواء في الضفة الغربية أو غزة. لا يدع ذلك مجالاً لغير استراتيجية التطهير العرقي في كلّ منهما. لكن حتى مع دعم "ترامب"، تبقى هذه استراتيجية اليائس. يمكن لإسرائيل أن تقتل الكثير من الفلسطينيين، ولكن من المستبعد جداً أن تتمكن من تحقيق إفراغ سكاني على نطاق يسمح لها بحلٍّ مشكلة تعزيز الصهيونية الجديدة.
لن تتضح التداعيات الكاملة للوقائع الكارثية التي أعقبت "السابع من أكتوبر" إلا بعد سنوات من الآن، لكن من الواضح أن الوضع السابق المعتاد، لجهة سياسة الاحتواء غير المتكافئ، قد انتهى. إن العنف المذهل الذي طبع الردّ الإسرائيلي لم يهدف فقط إلى إظهار قدرة إسرائيل على إلحاق قدر هائل من الألم غير المتناسِب، واستخدامه كوسيلة ردع، بل تخطى ذلك إلى حدّ بعيد. فقد أُجبرت إسرائيل على اللجوء إلى آخر الاستراتيجيات المتاحة لها، ألا وهي التطهير العرقي.
لفهم هذا الأمر، لا بد من العودة إلى الأسباب التي أدت إلى فشل حل الدولتين. فمنذ "اتفاق أوسلو"، كان الفلسطينيون وكثيرون في المجتمع الدولي يعتقدون أن هدف إسرائيل هو إقامة دولة ذات أغلبية يهودية، مستقرة ومعترَف بها عالمياً، وبالتالي إنهاء الصراع. لكن لو كان ذلك هو الهدف بالفعل، لكانت إسرائيل قد سارعت إلى تنفيذ حل الدولتين. أما إذا كان الهدف الإسرائيلي الأساسي، كما عبّر عنه "سموتريتش" وآخرون، هو ترسيخ الحقوق غير المتساوية، فإن حل الدولتين لا يتعارض مع هذا الهدف فحسب، بل يحقق عكسه في الواقع.
ليس من المستغرب إذاً أن إسرائيل لم تدفع نحو حل الدولتين بعد "أوسلو"، بل استخدمت الاتفاق لإدامة استراتيجيتها الجديدة القائمة على "الاحتواء غير المتكافئ"، أو التسوية السياسية المبنية على استخدام القوة والموارد لضمان استمرار نظام مستقرّ يكرّس التفاوت في الحقوق.
بالنتيجة، حُرم الفلسطينيون من أي حقوق سياسية حقيقية، وعانوا من قيود مشددة على حرية الحركة داخل أراضيهم ومن قيود أشدّ على السفر إلى الخارج. كما بقي اقتصاد الأراضي المحتلة، بما في ذلك العملة والضرائب، خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية. عملياً، تمدَّد واقع الدولة الواحدة القائمة على الفصل العنصري على كلّ فلسطين، على شكل منظومة تعمل بمستويات متباينة الشدّة، ووفق أنظمة قانونية وأمنية مختلفة داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة، وبين الضفة الغربية وغزّة.
في هذا السياق، جاء "السابع من أكتوبر" طوفاناً حقيقياً عطّل التسوية السياسية القائمة على الاحتواء غير المتكافئ من خلال عدة طرق جوهرية. أولاً، أثبت أن استراتيجية "جزّ العشب" لم تعد مضمونة النجاح. فمع تطور تكنولوجيا الحرب، أصبح بالإمكان تصنيع أسلحة فعالة، كالصواريخ والطائرات المسيّرة، داخل مصانع صغيرة أو تحت الأرض، في منشآت صناعية-عسكرية موضعيّة، وهو ما حدث في غزة وفي لبنان مع "حزب الله".
شكّل ذلك صدمة غير مسبوقة للطبقة السياسية الإسرائيلية، إذ كشف فشل استراتيجيتها في الحفاظ على الوضع الراهن. تُدرك إسرائيل أنه حتى لو سوّت غزة بالأرض وقتلت ما بين 70 و120 ألف فلسطيني، أو تمكّنت من تحييد "حزب الله"، فلا يوجد ما يضمن عدم ظهور أسلحة أكثر فتكاً وطائرات مسيّرة أكثر فاعلية في المستقبل القريب. ومع ذلك، من الخطأ افتراض أن الدرس الذي استخلصته إسرائيل مما حدث هو ضرورة التخلي عن نهج "سموتريتش". على العكس من ذلك، ردّت إسرائيل باستراتيجيات أشد عدوانية تؤكّد سياسة التمييز في الحقوق، بما فيها استراتيجيات التهجير القسري وتحويل أجزاء واسعة من غزة إلى مناطق غير صالحة للحياة.
إذا أثبتت استراتيجية "الاحتواء غير المتكافئ" عدم فعاليتها على المدى الطويل، وإذا لم يتم التراجع عن النهج النيو-صهيوني المتطرف الذي يدعو إليه "سموتريتش"، والذي يستلزم استمرار التمييز في الحقوق، فإن التسوية السياسية الوحيدة المتبقية أمام إسرائيل هي التطهير العرقي. لم تقتصر هذه السياسة على غزة وحدها، فالعديد من المسؤولين الإسرائيليين يدعمون صراحةً عنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. في الأيام الأخيرة من الحرب، ذهب سموتريتش إلى حد اقتراح أنّ "قرية الفندق ونابلس وجنين يجب أن تبدو مثل جباليا".
بالتالي، نحن نشهد الآن نهاية المرحلة الأولى من الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على "الاحتواء غير المتكافئ". إنها نقطة تحول من الصنف الذي وصفه "تشرشل" بـ"نهاية البداية"، في حديثه عن "معركة العلمين" عام 1942. كان "تشرشل" يمتلك من العبقرية الاستراتيجية ما يجعله مدرِكاً أنه حتى لو كانت مرحلة الحرب الخاطفة قد انتهت، إلا أن ذلك لا يعني أن الألمان سيخسرون كل معركة يخوضونها بعد ذلك. لم تكن تلك بداية النهاية، لكنها كانت نهاية البداية. فقد انتهت مرحلة التقدّم السريع، وبدأ الحلفاء تدريجياً في استغلال نقاط الضعف العسكرية والاستراتيجية للألمان.
وقَف "كاتس" فوق أنقاض مخيم "جنين"، الذي طردت إسرائيل 20 ألفاً من سكانه وهدمت نحو 100 منزل فيه خلال عشرة أيام فقط، وتوعّد بالبقاء فيه، وأخذ المعركة إلى "معسكرات إرهابية" أخرى، على حدّ تعبيره. لا يبدو هذا الدرس منطقياً على الإطلاق، إذا أخذنا بالاعتبار إعادة إحكام حماس سيطرتها العسكرية على الأرض في غزة في الأسابيع الماضية.
على الفلسطينيين تطوير استراتيجيات خاصة بهم لتقويض شرعية ونجاح الاستراتيجيات الإسرائيلية الساعية للحفاظ على نظام التمييز الممنهج في الحقوق، إن كان ذلك عبر استراتيجية "الاحتواء غير المتكافئ" أو من خلال التطهير العرقي.
هذه "نهاية بداية" مشابهة في فلسطين: فقد انتهت استراتيجية الاحتواء غير المتكافئ التي اتّبعتها إسرائيل منذ "اتفاق أوسلو". لم تعد إسرائيل قادرة على متابعة هذه الاستراتيجية لأن الفلسطينيين أظهروا قدرتهم على الفكاك من كلّ احتواء. وقد أدركت إسرائيل بالذات عواقب ذلك المحتملة. حتى وإن كانت حالات الفكاك من الاحتواء التي على شاكلة "السابع من أكتوبر" قليلة ومتفرقة، إلا أنها مكلفة للغاية لإسرائيل، وقد تزداد تكلفتها مع الوقت. لذلك، تبنّت إسرائيل استراتيجيةً أكثر عنفاً لمتابعة سياستها التمييزية، والاستراتيجية الأخيرة المتاحة لها هي خلق الظروف المؤاتية لتهجير السكان.
لم يتغير أيّ شيءٍ مما قد يشير إلى أن إسرائيل قد تتخلى عن التمييز الممنهج في الحقوق. ومع استمرار هذا الوضع، لا يمكن حدوث تسوية سياسية قائمة على تسوية حدودية، مثل حل الدولتين. كما أن تصور إمكانية عودة إسرائيل إلى مرحلة أقل عنفاً من الاحتواء غير المتكافئ، سيمنحها ببساطة الوقت الكافي لتعزيز الظروف التي تعتقد أنها تدفع قدماً بمخططها للتهجير.
قد يصير وقف إطلاق النار دائماً، لكن إذا تابعت الحكومة الإسرائيلية والإسرائيليون التمسك بصيغة "سموتريتش"، أي "الإخضاع أو الطرد أو القمع"، باعتبارها استراتيجيتهم الوحيدة، فمن المرجح أن تستخدم إسرائيل فترة وقف الحرب للبحث عن فرص جديدة لتحقيق أهدافها في الضفة الغربية، أو حتى للبحث عن طرق لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. على الفلسطينيين تطوير استراتيجيات خاصة بهم لتقويض شرعية ونجاح الاستراتيجيات الإسرائيلية الساعية للحفاظ على نظام التمييز الممنهج في الحقوق، إن كان ذلك عبر الاحتواء غير المتكافئ أو من خلال التطهير العرقي. لا شكّ أن إسرائيل قادرة على إطلاق عنف هائل في الأمدين القريب والمتوسط، لكن لن يُكتب لأهدافها الاستدامة إذا رفض الفلسطينيون والشعوب في جميع أنحاء العالم التمييز بكل أشكاله. ليس للعقلاء في مختلف أنحاء العالم إلا أن يأملوا في ألا تغري الأفكار المجنونة والنرجسية المنفلتة ل"دونالد ترامب"، إسرائيل لمحاولة تنفيذ رؤاها المتطرفة التي ستؤدي إلى عواقب مدمرة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل.
*ترجمته عن الانجليزية صباح جلّول