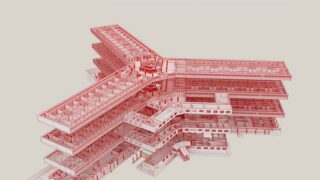ابتدأ النقاش حول "أصل" سكان الساحل السوري في حقل التبشير المسيحي منتصف القرن الثامن عشر عبر البعثات والإرساليات الغربية للمنطقة. وفي زمن لاحق، حطّ في المجال السياسي، متخذاً شكل تأويلات إيديولوجية، دينية وقومية، شرعنت وجودها في تصورات تاريخية مسبقة تجاوزت مسائل تطور الهوية عبر العَيش المشترك، وانجرفت بسهولة وراء نزعات المِلل والطوائف الحاضرة بكثافة على مسرح أحداث المنطقة منذ قرون.
لا وجود لأعراق أو أديان صافية!
يمكن اختصار تيارات التأويلات الإيديولوجية في أصل سكان الساحل السوري والجبال تحديداً، في ثلاثة، أولها العروبي البحت (الهجرات من الجزيرة العربية، وهو تيار عريض)، والثاني تيار السكان الأصليين غير العرب (الفينيقيين مثلاً، وهو أقل انتشاراً)، والثالث، التيار المختلط، وهذا الأخير يبدو الأكثر منطقية، انطلاقاً من فكرة تراكم السكان طبقات فوق بعضها عبر الأزمنة والأمكنة، بحيث يستحيل وجود أعراق أو أديان صافية، أو غير ذلك من محددات الهوية البشرية، مع تحوّلات وانتقالات دائمة بينها ليس صعباً ملاحظتها.
إنّ السؤال الذي تطرحه هذه التيارات هو بوضوح: من أين أتى هؤلاء السكان الذين يعيشون في جبال الساحل السوري ويدينون اليوم بالمذهب الإسلامي العلوي؟ هل هم من عرب الجزيرة العربية أم أنهم ورثة الحضارات القديمة في المنطقة؟ ماذا لو أنّ هؤلاء لم يأتوا من أي مكان؟ ولماذا الاهتمام بهذا الأصل؟ وما الذي تفيدنا معرفته بهذا الشأن؟
قد يقول قائل إنّ هذه الأسئلة ذات انشغال تأريخي وديني وليست ذات أهمية قياساً بما هو حاصل منذ عقد فأكثر على الساحة السورية. غير أنّ هذه الأسئلة حاضرة فعلاً في السياق السوري الراهن وتتجاذبها أطراف متعددة، لا من منطلق الهوية الجامعة المفترض حضورها في الحل السياسي القادم فقط، بل وأيضاً من جهة التعاطي مع مكوّنات سكان الساحل وعلاقتهم الحصرية بالسلطة السورية الحالية، وكأنهم المكوِّن الوحيد لهذه السلطة. ويرافق ذلك تصوّر ممتد لهذه المكوّنات بشكل غرائبي إلى درجة يبدو معها هؤلاء السكان وكأنهم من كوكب آخر، وكأننا نعيش كسوريين في مجرّات مختلفة لا ندرك فيها بعضنا بعضاً إلا من الباب الإقصائي بنسبة كبيرة. وبالطبع، كان من مصلحة السلطة -وبعض المعارضة- تعميم الإقصائية وتأصيلها لدى الجميع.
تواجه دراسة تاريخ المجموعة البشرية في الساحل السوري وتتبّع مسار تطورها الإثني والحضاري صعوبات عديدة، منها ما يتصل بالمعطيات التاريخية، ومنها ما يرجع إلى ثقل التأويلات الإيديولوجية، وخاصة أن الجانب الديني طاغٍ على سرديات القرون السابقة، بحيث أن هذه المجموعة البشرية هي أحد أكثر المجموعات التي بُحث في أصلها بكثير من الخيال والمثابرة، باعتبار الميل العام إلى افتراض تجانس تام أو على الأقل مقنّن (في حالة وجود المسيحيين مثلاً)، والاندهاش من مغالطة الواقع الدائمة لهذا الميل! وأيضاً باعتبار أن الانقسامات في الدين الاسلامي "مؤلمة" وقد ترافقت دوماً مع وقائع دموية - وأخرى أسطورية ما زالت حية! وباعتبار، ثالثاً، قروناً من سلطة جائرة في مواجهة الاختلاف في الاسلام، آخرها سلطة العثمانيين، وباعتبار أخيراً العبث الكولونيالي في المكونات منذ القرن التاسع عشر على الاقل...
هويات سكان الساحل السوري في الأزمنة القديمة
يمتد الساحل السوري حالياً من أنطاكية شمالاً إلى جبال لبنان الغربية جنوباً بمسافة 170 كم وبعرض يتراوح بين 25-30 كم، وترتفع جباله بتدرج من الجنوب إلى الشمال حتى تصل إلى ارتفاع 1562 متراً في "جبل متّى" شرقي "صلنفة" شمالاً، وهو أعلى ارتفاع في هذه الجبال التي كانت تضم جبال لبنان سابقاً.
اللاذقية: صورة سوريا الصغرى
28-04-2016
"طرطوس" مدينة الفرص الضائعة
13-07-2016
تسببت طبيعة الجبال الصعبة، المغطاة حتى وقت قريب بالغابات والأحراج والثلوج والوديان القاسية، في خلق تجمعات سكانية وبلدات وقرى متباينة القرب والعدد على مرّ الزمان، كما تسببت أيضاً في قلّة الطرق العابرة لها من الساحل إلى الداخل (حتى الآن) كونها تنغلق شتاءً مما يعيق السيطرة الدائمة عليها. ولذلك أحجمت حضارات المدن الساحلية الأولى، مثل "أوغاريت" والإمبراطوريات التالية، عن محاولة بسط نفوذها الدائم على الجبال مما جعل سكانها منعزلين أحياناً كثيرة عن الجوار.
بُحِث في أصل العلويين بكثير من الخيال والمثابرة! حيث هناك ميل عام إلى افتراض التجانس التام، والاندهاش من مغالطة الواقع الدائمة له! وهناك قسوة الانقسامات في الدين الاسلامي وترافقها مع وقائع دموية وأخرى أسطورية ما زالت حية! وهناك قرون من سلطات جائرة في مواجهة الاختلاف، آخرها سلطة العثمانيين، وأخيراً هناك العبث الكولونيالي في المكونات منذ القرن التاسع عشر على الاقل...
ليس من الممكن حالياً معرفة وتحديد هوية السكان الأوائل هنا، عرقياً، في غياب تحليل جيني موثوق. وتبعاً للّقى الأثرية المكتشفة، فإنّ قرية "ستمرخو" الساحلية يعود عمرها إلى أكثر من مليون عام، وتشير المشيّدات القديمة من قبور وقلاع وأديرة ولهجات لغوية إلى حضور سرياني وآرامي يدعمهما حضور رومانيّ ملحوظ في العديد من المواقع، أي أنّ التواجد البشري هنا قديم جداً.
بعد أقل من نصف قرن على انطلاقة المسيحية، اعتنقها الآراميون وهم عرب (الآرامية لغة السيد المسيح) وبعض القبائل العربية مثل الغساسنة المقيمين جنوب سوريا، وبني تغلب (سكّان حلب والجزيرة والساحل). ويمكن ملاحظة الانتشار المسيحي (النسطوري الغالب) في جبال الساحل السوري حتى الآن، في عدة جوانب، منها الحصيلة اللغويّة لأسماء مواقع وقرى ولهجات محلية جداً، وفي الحياة اليومية للناس، إذ تنتشر هنا مفردات يمكن وصفها بالمسيحية تجاوزاً، مثل كلمة "دير" وهي استمرار للكلمة الآرامية "دير" ومعناها "مزرعة" أو "بيت" أو "حجرة في البيت"، كما أنّ هناك عدداً من البلدات التي توجد فيها كنائس وأديرة وصوامع عبادة وتحمل بشكل مباشر اسم "كنيسة" أو مشتقاتها (كنائس، كنايس، كنيسات، كنيس)، وهناك رواية سريانية تقول بتسمية البلدة على اسم الراهب الذي يتعبد فيها، وهناك مفردة "صومعة" وهي من أشكال التديّن الرهباني قبل المسيحية، وينطبق الأمر على غالبية مناطق بلاد الشام والعراق ومصر أيضاً.
الطائفية في الأمثال الشعبية السورية
29-11-2016
تذكر روايات متعددة أنّ هناك أقواماً حلّوا هنا من اليونان وقبرص وإيطاليا وشرق المتوسط عموماً، وتذكر مصادر تلك الفترات أنّ الموانئ المتوسطية كانت تعج بالتجّار من مختلف مناطق المتوسط، وقد بقي هؤلاء حاضرين حتى منتصف القرن التاسع عشر في اللاذقية، وتتضح البقايا في أسماء العائلات حتى الآن.
تحوّلات الساحل في العهود الإسلامية
على الرغم من دخول الإسلام إلى بلاد الشام مبكراً منذ العام 636 ميلادي في عهد الخليفة الراشدي الثالث، فقد بقي جزء كبير من سكان المناطق الشامية متنوعو الإثنيات يدينون بالمسيحية (سريانيون في الغالب) واليهودية أو غير متدينين بالإسلام الرسمي حتى القرن العاشر، وخاصة في الأرياف وعند القبائل الكبرى التي لم تتنازع معها السلطات، فحافظ سكان جبال الساحل السوري واللبناني على عقائدهم (المسيحية وربما الوثنية أو عبادات الطبيعة) وعاداتهم قدر الإمكان، فيما حلّ الإسلام الرسمي في المدن الكبرى بشكل متدرج.
تبعاً للّقى الأثرية المكتشفة، فإنّ قرية "ستمرخو" الساحلية يعود عمرها إلى أكثر من مليون عام، وتشير المشيّدات القديمة من قبور وقلاع وأديرة ولهجات لغوية إلى حضور سرياني وآرامي يدعمهما حضور رومانيّ ملحوظ في العديد من المواقع، أي أنّ التواجد البشري هنا قديم جداً.
في عهود الإسلام الأولى، المحمديّ والأمويّ، جرت عمليات تهجير لأقوام أخرى إلى المناطق الساحلية السورية كما تذكر ذلك المدونات التاريخية، ومنها "البلاذري" (توفي 892 م) في كتابه "فتوح البلدان" الذي ذكر أنه "بعد أن استولى معاوية بن أبي سفيان على السلطة، وتفرّغ لتنظيم شؤون الدولة، شرع سنة 50 هـ (670 م) في نقل عدد من الزط والسيابجة (قوم أصلهم من الهند) من أهل البصرة إلى سواحل بلاد الشام" وكانت هي الحدود مع الروم، لإبعادهم عن العراق، منطقة الشغب الأهم بالنسبة له، وتقوية الحاميات الإسلامية بالقرب من الحدود البيزنطية، وبناء السفن وإعادة بناء هذا البلد، وزيادة عدد سكانها من جهة أخرى". وعلى هذا الكلام يجب أن يكون عددهم كبيراً للوصول إلى زيادة في عدد السكان. استقر بعضهم في "أنطاكية"، حيث توجد فيها محلة معروفة باسم "الزط"، وفي "بوقا" وهي من أعمال أنطاكية (تقع في مدينة اللاذقية حالياً). وفي رواية أخرى تعضد رواية "البلاذري"، فإنّ سبب نقل معاوية للزط والسيابجة يعود إلى مغالاة هؤلاء القوم في "عليّ" مما دفع معاوية إلى نفيهم إلى السواحل والجبال فـ"تكاثروا هناك ونزلوا سهول أضنة وعكار وحمص وطبريا". ومن هؤلاء القوم في وقت لاحق "أبو إسحاق الرقاعي" تلميذ الخصيبي مؤسس الطائفة العلوية (القرن العاشر الميلادي) وقد سكن محلة "بوقا". وتشير الرواية ضمناً إلى انتشار "الغلاة" في العراق والشام بكثرة.
في العهد الأموي أيضاً، وصل إلى الساحل السوري من الجنوب والشرق، الغساسنة (القيسيون واليمنيون)، وهم قبائل عربية تنصّرت وأسلم بعضها، وفيما بعد أُطلق عليهم اسم "التنوخيون". وهناك مصادر متعددة تقول أنّ عشائر "الكلبية" في الموصل وشرق سوريا من حمْدانيين وتغلبيّين وفدوا إلى الساحل على شكل موجات متباعدة واختلطوا بالسكان الأصليين، وهؤلاء كانوا يدينون بالمسيحية. واليوم تشكّل هذه العشيرة نسبة كبرى من العلويين.
من العصر العباسي إلى حقبة المماليك (1250 ـ1517م) اشتد الصراع الدمويّ الحادّ على مختلف الجبهات الإقليمية، بين المماليك والأتراك والفرس والمغول والصليبيين والعرب في المنطقة الشامية والمصرية، وهو ما تسبب في تغيير مناطق إقامة الأقوام وانتقالهم من مكان إلى آخر. لم تنجُ من هذا الانتقال منطقة واحدة في مختلف جغرافياتها. ورافقت ذلك هجرات أوروبية نحو المشرق طيلة قرون الحروب الصليبية (1096 - 1291م)، مع حصول تحولات دينية (إسلامية ـ مسيحية، وسنية ـ شيعية، وبالعكس)، قسم كبير منها إجباري. فمثلاً كانت مصر شيعية المذهب حتى العام 1171م، حين أعادها الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى الشافعية.
التحولات الدينية للسكان الأصليين من مسيحيين ويهود
قاوم السكان الأصليون من العرب ومن غير العرب في عموم سوريا الإسلام والدخول فيه ما استطاعوا، وخاصة أنّ الإسلام اعترف بالمسيحية واليهودية كديانات "قانونية"، وفعل الأمر نفسه مع الصابئة والمجوس، كما ارتبط المسلمون الوافدون من الجزيرة العربية مع قيادات هذه الطوائف. ولكن هذا التسامح كان خاضعاً في كثير من تفصيلاته لجدلية الحاكم الأقوى، كما للتبشيرية الإسلامية الضاربة بقوة تجاه تلك المجتمعات ضمن مفهوم الثواب والعقاب في إدخال هؤلاء الدين الجديد.
كانت هناك قيود كثيرة على هذه الطوائف في حياتها اليومية، في أكلها وشربها ودفن موتاها وأدائها طقوسها الدينية وعلاقتها بالمجتمعات المسلمة. وكانت هذه القيود تحاصرها في كل شيء، فليس مسموحاً بناء الكنائس، وعلى "أهل الذمة" ارتداء ملابس معينة تمايزاً لهم عن المسلمين، كما أنّ مقدار الجزية المفروضة عليهم والمضاعَفة أحياناً كثيرة أرهقت غالبيتهم، والأهم من كل هذا أنّه "ليس مسموحاً لهم تنصير أولادهم ولا إعادة بناء كنائسهم، ما خرب منها وما تهدم دائماً"، وفق توجيه الخليفة الراشدي الثالث لعامليه على الشام.
تسببت هذه السياسات في بيئة تنتشر فيها بكثافة الأفكار المُغالية، في تحوّل جزء مهم من السكان الأصليين إلى هذه الأفكار بدل الذهاب نحو الإسلام الرسمي، فكان سكّان المناطق المفتوحة أكبر مورد للبيئة المُغالية فدخلوا مذاهب التأليه الشيعية المنبت، خاصة وأنّ قسماً وازناً من تلك الأفكار يتوافق مع المعتقدات المسيحية واليهودية، مثل التثليث.
دخل الإسلام إلى بلاد الشام مبكراً في عهد الخليفة الراشدي الثالث، لكن جزءاً كبيراً من سكان المناطق الشامية استمروا يدينون بالمسيحية (سريانيون في الغالب) واليهودية أو غير متدينين بالإسلام الرسمي حتى القرن العاشر، وخاصة في الأرياف وعند القبائل الكبرى التي لم تتنازع معها السلطات، فحافظ سكان جبال الساحل السوري واللبناني على عقائدهم فيما حلّ الإسلام الرسمي في المدن الكبرى.
"بعد أن استولى معاوية بن أبي سفيان على السلطة، وتفرّغ لتنظيم شؤون الدولة، شرع سنة 50 هـ (670 م) في نقل عدد من الزط والسيابجة (قوم أصلهم من الهند) من أهل البصرة إلى سواحل بلاد الشام" وكانت هي الحدود مع الروم، لإبعادهم عن العراق، منطقة الشغب الأهم بالنسبة له، وتقوية الحاميات الإسلامية بالقرب من الحدود البيزنطية...".
وما قرّبهم أكثر من تلك الأفكار أيضاً خوفهم المتصاعد من اندثار عقائدهم الأصلية، فربطوا أفكارهم بأفكار أصحاب تلك الفُرق حتى يتمكن أصحابها، عند دخولهم إلى تلك البيئة، أن يكونوا في أجواء غير بعيدة عن واقعهم وأفكارهم التي لم يكادوا يخرجوا منها. وساعد أمرٌ آخر ذو أهمية طقسية، هو افتقاد تلك المعتقدات للفرائض اليومية من صلاة ومعابد. فعلى سبيل المثال، تبنّت النصيريّة الأعياد المسيحية في غالبيتها، وربطت معتقداتها بالصابئة الحرّانيين، وجميع "المغالين" (نصيرية وإسحاقية وإسماعيلية وغيرهم) ربطوا معتقداتهم بالتناسخ، وهو قناعة شعبية وجدت لها سنداً قرآنياً.
جنود مخفيون في الحرب السورية!
19-08-2016
ويجب أيضاً قراءة هذه التحولات من قبل هؤلاء السكّان من باب آخر، وهو أنّ قادة الطوائف والقرى والبلدات هم مَن كانوا يسيّرون الرعية في مجتمع يندر فيه وجود من يقرأ ويكتب، وبالتالي كان غالب الإيمان غير ثابت المعالم ويرتبط بالطقس الديني اليومي.
الضغوط على أصحاب المذاهب الأخرى
تذكر المصادر المتوافرة أنّه حتى الحقبة المملوكية، كانت الأرض الممتدة من الموصل إلى جبال لبنان، بما فيها دمشق وطبريا، مكتظّة بأنواع مختلفة من التوجّهات الدينية، المنشقة عن الإسلام والمسيحية (النصيرية والنسطورية مثلاً). وهذا يعود في الأصل إلى أنّ الإسلام الرسمي لم ينجح في اجتثاث الأفكار التي ولّدتها المنطقة في العرفان والتصوف والفلسفة وغيرها. وحسب المعلومات المتوافرة، فقد كان أغلب القاطنين في مناطق حلب وسنجار والموصل من الشيعة أو النصيرية، في حين كان سكان الغرب من أنطاكية وحتى اللاذقية وصولاً إلى طرابلس من المسيحيين النساطرة والغيبييّن الإسحاقييّن (أتباع إسحاق الأحمر). وقد أشير إلى اتساع انتشار "الغُلاة" في النص الكامل لفتوى "ابن تيمية"، وفي كتاب "البداية والنهاية" ل"ابن الأثير" و"النويري"، وذكره "الديلمي" في رسالته "هداية المسترشد وسراج الموحد" حيث يقول: "إنّ الغالب على سكان أهل الشام الغلاة، والغالب على حكام ذلك الزمان هو اتخاذهم الغلو وتحديداً الدعوة النصيرية".
ولأسباب كثيرة، فقد مارست السلطات الحاكمة المتتالية ضغوطاً على أصحاب المعتقدات والمذاهب والمقولات من المسلمين، وعلى المؤلِّهين لعليّ، لإدخالهم جميعاً في حظيرة الإسلام الرسمي. وكان هذا الضغط طبيعياً بالنظر إلى مواقف هذه الفرق المناوئة للسلطات الحاكمة وامتلاكها مشروعاً سياسياً ضدها. والحجة في محاربتها جاهزة وهي "الكفر والحلولية والإلحاد والتجسيم". وقد استُخدمت هذه المفاهيم سياسياً، ويمكن ملاحظتها بوضوح في فتوى "ابن تيمية" التي صدرت العام 1305م، وأفضت باستخدامها من قبل المماليك إلى إفراغ مناطق الضنية وجبال كسروان (لبنان حالياً) من الشيعة ودفعهم شمالاً نحو بعلبك، ومن النصيرية ودفعهم إلى جنوب الساحل الشامي، ودفع الدروز إلى الجنوب بعد ارتكاب مجازر وتحريق وتخريب (1).
قاوم السكان الأصليون من العرب ومن غير العرب في عموم سوريا الإسلام والدخول فيه ما استطاعوا، وخاصة أنّ الإسلام اعترف بالمسيحية واليهودية كديانات "قانونية"، وفعل الأمر نفسه مع الصابئة والمجوس، كما ارتبط المسلمون الوافدون من الجزيرة العربية مع قيادات هذه الطوائف. ولكن هذا التسامح كان خاضعاً في كثير من تفصيلاته لجدلية الحاكم الأقوى، كما للتبشيرية الإسلامية.
تسببت السياسات التقييدية الصارمة في بيئة تنتشر فيها بكثافة الأفكار "المُغالية" في تحوّل جزء مهم من السكان الأصليين إلى هذه الأفكار بدل الذهاب نحو الإسلام الرسمي. وكان سكّان المناطق المفتوحة أكبر مورد لهذه الحركة، فدخلوا مذاهب التأليه الشيعية المنبت، خاصة وأنّ قسماً وازناً من تلك الأفكار يتوافق مع الأفكار المسيحية واليهودية، مثل التثليث.
كانت طبيعة المناطق التي وصل إليها هؤلاء قاسية وصعبة، وكثيراً ما أُهمِلت إلّا في حالات الجباية والضرائب. وتَرافق، مع شبه التحوّل العام إلى النصيرية في مناطق الجبال الساحلية من القاطنين فيها من المسيحيين، وصول هجرات من الداخل إلى الجبال قادها في القرن الحادي عشر والثاني عشر أمراء محلّيون اعتنقوا النصيرية، كقبائل بني كلب (تغلب وقضاعة) والمهلبيين وغيرهم، وبني رائق الغساسنة في طبريا، في فترة لم تكن فيها هذه القبائل قد بنت كامل معمارها العقائدي، وهو ما جعلها خليطاً من الشعوب القديمة والقبائل المهاجرة والمسيحيين واليهود المتحوّلين إلى الإسلام.
استمرت هذه الهجرات عقوداً بشكل غير منتظم ولكنه تراكمي، وأبرزها حضوراً وتأثيراً وضخامةً، هجرة الأمير حسن بن يوسف الملقّب "المكزون السنجاري" وأمراء قضاعة الكلبيون كآل مهنا، وهؤلاء كانوا مسيحيين وأصبحوا نصيريين، ولم يكتفوا بهذا بل طاردوا الإسحاقيين وضمّوهم إلى النصيرية.
الهويات في تحولات دائمة
نخلص هنا إلى أنّ مناطق الساحل، سهلاً وجبلاً، تعرّضت، كغيرها من المناطق، إلى تغيرات سكانية ودينية ناتجة عن أسباب في غالبها سياسي يرتدي لبوساً دينياً، مع ملاحظة أنّ سرديات الأزمنة الماضية تنحو دائماً نحو التفسير الديني على حساب السياسي والاقتصادي، على الرغم من وجود دلائل تُناقض هذا التوجه مثل وقوف السلطان المملوكي قانصوه الغوري مع شاه إيران اسماعيل الأول في حربه ضد الأتراك، مع أنّ المماليك أتراك بالأصل.
بالطبع، هذا لا يلغي العوامل الطبيعية للهجرة البشرية المزمنة صوب الكلأ والماء، فبعض المواقع في المناطق الساحلية كانت فارغة من السكان لأسباب بيئية وصحية، ولم تكن أعداد السكان ضخمة. وهجرة القبائل و"انتجاعها" مستمر حتى الآن على أطراف المدن والبوادي، وذلك للأسباب القديمة نفسها من الجوع والعطش والعمل.
ووفق وثائق "الأرشيف العثماني" التي بدأت تُنشَر منذ فترة ليست بعيدة، فإن غالبية القرى السورية واللبنانية قد شهدت خلال القرون الخمسة الأخيرة تحولات وتغيرات ديمغرافية ودينية هائلة، لم تترك من القديم سوى القليل، وهذه سنّة الجغرافيا والبشر على طول الأيام.
مصادر:
• ستيفن وينتر، "تاريخ العلويين من حلب القرون الوسطى إلى الجمهورية التركية"، ترجمة باسل وطفة وأحمد نظير الأتاسي، دار ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، اسطنبول، 2018.
• إميل عباس آل معروف "تاريخ العلويين في بلاد الشام"، دار الأمل والسلام، بيروت، 2013.
• د. الياس القطّار، "نيابة طرابلس في عهد المماليك"، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1998.
1- محمد جمال باروت، "حملات كسروان، في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيمية"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة 2017.