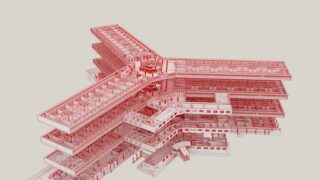لم يكن صعباً ملاحظة أنّ عواقب زلزال السادس من شباط/ فبراير 2023 تتجاوز قدرة تركيا الدولة - الحكومة والمؤسسات الإغاثية العريقة فيها - على استيعابها والتعامل معها. بالمثل، وبدرجات أكبر بكثير، فإنّ الدولة السورية ومؤسساتها الباقية على قيد الحياة في أنحاء البلاد، لا تمتلك الوسائل المناسبة لمعالجة تبعات كارثة كهذه، بعد عقد ونيف من الصراع والعقوبات، وعقودٍ من الفساد.
تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، بمقتل قرابة خمسين ألف شخص في تركيا وأكثر من ستة آلاف في سوريا، وتدمير مئات آلاف المباني، وتضرر نحو ثلاثة وعشرين مليون إنسان (تركي وسوري)، بينهم قرابة مليوني لاجئ سوري في تركيا بالأصل، هذا عدا الخراب العميم في البنى التحتية والخسائر الاقتصادية العالية.
بعد ساعات على الكارثة، سارعت عشرات الدول ﻹعلان تقديم مساعدات لتركيا، وامتلأت مطاراتها بآلاف المتطوعين، فيما استنفر المجتمع المدني التركي ومؤسساته بغية المشاركة في جهود اﻹغاثة ومحاولة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض. في سوريا وعلى استحياء، وبعد ثلاثة أيام على الكارثة، أعلنت دول عربية عن بدء انطلاق مساعداتها، دون أن تضيف هذه المساعدة اللوجستية كثيراً من النتائج. وحقيقةً، يعود الفضل الأكبر في جهود اﻹنقاذ لِما قامت به مؤسسات حكومية من القطاع العام، تلتها الجهود الأهلية في البحث عن ناجين وإغاثة المتضررين بأقصى السبل الممكنة.
جهود اﻹنقاذ التركية، ولسبب ربما غير مقصود، استغرقت وقتاً طويلاً للوصول إلى لواء الاسكندرونة السوري المحتل (ولاية هاتاي بالتركية) وعاصمته المدمّرة أنطاكيا، عاصمة سوريا المسيحية، وأحد مهاد الدعوة العلوية، وفيها إلى الآن عدد كبير من العرب السوريين. كما ظهرت اتهامات للحكومة التركية بالعنصرية إزاء السوريين والأكراد العالقين تحت الأنقاض في "غازي عينتاب" و"كهرمان مرعش" و"أنطاكيا" ومناطق أخرى. في واحدة من أكثرها تداولاً، قال رجل سوري انتشل من تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد أيام على الكارثة "إنه لم يصرخ طالباً النجدة ﻷنه خاف أن يصرخ بالعربية، فهو لا يعرف التركية"، وخاف أن تتركه فرق اﻹنقاذ التركية إذا عرفت أنّه سوري!
حاولت الحكومة التركية تبرير التأخر في إغاثة أنطاكيا بطرق مختلفة، دون كثير نجاح. فقد كان الدمار هناك هائلاً، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في عدد الضحايا (عشرون ألفاً حتى 17 آذار/ مارس من بين خمسين ألف ضحية)، ونسبة المباني المدمرة فيها تتجاوز 70 في المئة، وضررها أكبر من كهرمان مرعش (مركز الزلزال) التي استعادت الحياة فيها إيقاعها على الرغم من عدم توقف الهزات الارتدادية حتى اليوم.
تسبب التأخر في إغاثة أنطاكيا بإثارة هواجس الجيران القريبين منها، أي أهالي إدلب وشمال غرب حلب. إذا كانت تركيا، بقصد أو بدونه، تعاملت مع حاملي جنسيتها من سكان اللواء السوريين المحتل منذ العام 1939 بتجاهل، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، فكيف ستتعامل مع مناطق، هي رسمياً مناطق سورية محتلة من قبلها (منذ العام 2016)؟
صدمات
12-02-2023
الاستجابة السورية لكارثة الزلزال: زلزال فوق الزلزال
25-02-2023
وتدفقت هواجس إنسانية وعملانية ولوجستية تخص مناطق إدلب وشمال غرب حلب، تحتاج قراراً سريعاً بعيداً عن الحسابات السياسية. إذ كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع منطقة تتناهبها صراعات اﻹرادات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما لم يكن أي من الأطراف المعنية جاهزاً أو مستعداً أو راغباً القيام به... وخاصة مع تحوّل عملية التدخل في اﻹنقاذ من الساعات الأولى إلى مسألة سياسية واضحة لها أفضلياتها المعلنة. ففي وقت حرج جداً، كيف يمكن إرسال فرق الإنقاذ ومساعدات الاستجابة التركية للزلازل إلى سوريا بينما تحتاج تركيا المنكوبة كل قدراتها المحتملة ﻹنقاذ ثلاثة عشر مليون تركي متضرِّر؟ وكيف يمكن إرسال فرق الإنقاذ والمعدات إلى إدلب الواقعة تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" المصنفة إرهابية، والتي تتعامل معها تركيا فقط؟
بالمثل، طُرِحت تساؤلاتٌ حول وضع بلدة "جنديرس" في "عفرين" - إحدى أكثر مناطق الشمال السوري تدمراً وتضرراً - تتعلق بمشاركة ودور "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا"، كسلطة أمر واقع، في ما يجري في مناطق عفرين ومحيطها المحسوبة عليها كردياً، خاصة أنّ "جنديرس" كانت ذات أغلبية كردية قبل أن يُطرد سكانها ويحل بدلاً عنهم نازحون سوريون من مناطق أخرى؟ ثمّ أتى بعدها سؤال مركزي أكثر أهمية للمجتمع الدولي: كيف سوف يتم التعاطي مع الدولة السورية في عهد بشار الأسد حيث العلاقات مقطوعة بين دمشق وغالبية دول العالم؟
مخاوف في محلها أكّدتها الوقائع
منذ الأيام الأولى لكارثة الزلزال، ظهر أنّ التخوفات السابقة لسكان مناطق إدلب وريف حلب في محلها، فقد كانت تلك المناطق الأقرب إلى مركز الزلزال الأساسي في كهرمان مرعش، آخر المناطق التي انتهت فيها أعمال إزالة الأنقاض وإنقاذ الناجين المحتملين (وبعضها مستمر حتى الآن بالنظر إلى المساحات الواسعة للعمل). ولذلك سجّل عدد الضحايا في مناطقها المدمرة رقماً كبيراً (2157 وفق منظمة "الخوذ البيضاء"، فيما سجلت "الحكومة المؤقتة"، التابعة لما يسمّى "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة" - وغير المعترف بها دولياً - مقتل 4537 شخصاً)، مقارنةً بعدد ضحايا المحافظات السورية اﻷخرى المتضررة من الزلزال (1414 ضحية وفق وزارة الصحة السورية الحكومية) في اللاذقية وحلب وحماة.
وإذا كانت مناطق دمشق استقبلت عدداً قليلاً من فرق الإنقاذ (إماراتية وجزائرية وفنزويلية) بعد أسبوع على الكارثة، أي دون كثير فائدة، فإنّ مناطق إدلب لم تتلق خلال الأيام الثلاثة الأولى للكارثة - وهي الأيام الحاسمة في عمليات إنقاذ ناجين محتملين من تحت الأنقاض - أياً من فرق اﻹنقاذ على الرغم من الوعود الأممية والدولية ونداءات المسؤولين والجمعيات المحلية بالتدخل للإغاثة وسط ظروف جوية سيئة. حتى بعد مضي شهر ونصف على الكارثة، لم تصل أيٌّ من الفرق الأممية الإنقاذية إلى هناك. كان مارتن غريفيث، منسّق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، قد أقرّ خلال زيارته لشمال غرب سوريا، أن الأمم المتحدة فشلت في مساعدة ضحايا تلك المناطق.
تدفقت هواجس إنسانية وعملانية ولوجستية تخص مناطق إدلب وشمال غرب حلب، وكانت تحتاج قراراً سريعاً بعيداً عن الحسابات السياسية. كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع منطقة تتناهبها صراعات اﻹرادات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما لم يكن أي من الأطراف المعنية جاهزاً أو مستعداً أو راغباً القيام به.
في العديد من الشهادات التي قدّمها سكانٌ محليون للباحث، كان نقص المعدّات أحد أبرز العوامل في زيادة أعداد الضحايا، مع كثرة المواقع التي يلزم البحث فيها. عاملٌ آخر إضافيّ هو عدم سماح تركيا لفرق الإنقاذ بالدخول إلى مناطق الزلزال هناك، فقد كانت الحدود السورية مع الجنوب التركي مغلقة، وفعلياً، وفي الأيام الأولى بعد الزلزال مباشرة، كان الشيء الوحيد الذي يمر من الجانب التركي إلى شمال غرب سوريا هو جثث اللاجئين السوريين الذين سقطوا في مناطق تركية.
مجتمعات هشّة وكوارث لا تنتهي
باتت مجتمعات إدلب وغربي حلب، وبعد سنوات الحرب الطويلة، متهالكة ومتعبة أكثر من بقية المجتمعات السورية الأخرى، وهي بالأصل أقلها تنميةً، حيث يعيش هناك حوالي خمسة ملايين نسمة ثلثاهم نزحوا قسراً من أجزاء أخرى من البلاد، وبعضهم نزح عدة مرات، وهذا يعني أنّ هؤلاء السكان فقدوا أصولهم وممتلكاتهم مراراً وتكراراً وليست لديهم أية قدرة على مواجهة كارثة بحجم ذلك الزلزال، وسط حكم محلي عشوائي تغيب عنه المأسسة وسلطة الدولة بمعناها التقني.
مع حدوث الزلزال سوّيت قرى وبلدات بالكامل بالأرض، وفُقدت عائلات بأكملها، وتفاقم الأمر بسبب عدم وصول المساعدات إلى مناطق إدلب، وهي المساعدات التي وصلت ابتداءً إلى مناطق الحكومة السورية أو تركيا في الأيام اﻷولى التي أعقبت الزلزال. كان هناك آباء وأمهات يسمعون صراخ أولادهم تحت الأنقاض، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذهم بسبب عدم وجود فرق بحث وإنقاذ (مدرّبة أو غير مدرّبة) كافية. قبل الزلزال، كانت التجاذبات بين القوى المحلية عاملاً في عدم حدوث أي نوع من أنواع التنمية المتراكمة، وهو ما يعني ضعفاً أكيداً في الحفاظ على المساعدة اللازمة للاستجابة العاجلة، والتعافي على المدى الطويل.
إلى جانب تلك المشكلات، ظهرت مشاكل البنية التحتية السيئة لتلك المناطق، فهي تخلو من مستشفيات كبيرة مجهّزة للتعاطي مع كثافة الحالات والازدحام الناتج عن كوارث، كما تخلو من إمدادات مستمرة وكوادر طبية مدرّبة، في منطقة تعاني باﻷصل من فقدان الأمن الغذائي والإنساني، وتنتشر فيها مجموعات مسلحة فقدت مواردها من رواتب وتجارة سلاح.
ووفق سلطات إدلب المحلية، فإن أكثر من 100 مدينة وبلدة وقرية في تلك المنطقة وحدها تضررت، مع تهدم 812 مبنى وتضرر أكثر من 5937 مبنى.
وبالأصل، كان هناك حوالي 400 مرفق طبي وتعليمي ومياه وصرف صحي معلّقة منذ العام 2022 في شمال غرب سوريا بسبب انقطاع التمويل. لذلك، بعد الزلزال، كان هناك أطباء في المستشفيات يقررون حرفياً من سيعيش أو سيموت، لأنه لم يكن هناك معدات كافية ﻹنقاذ الجميع. حتى الآن، وبعد شهرين على الكارثة، هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في خيام (لا تديرها الأمم المتحدة) في منطقة تمر بفصول شتاء قاسية وفيضانات ضربت آخرها المنطقة بعد أيام على الزلزال.
بعد أسبوع على الكارثة استقبلت مناطق دمشق عدداً قليلاً من فرق الإنقاذ (إماراتية وجزائرية وفنزويلية). أما مناطق إدلب فلم تتلقَ خلال الأيام الثلاثة الأولى للكارثة - وهي الأيام الحاسمة في عمليات إنقاذ ناجين محتملين من تحت الأنقاض - أياً من فرق اﻹنقاذ، على الرغم من الوعود الأممية ونداءات المسؤولين والجمعيات المحلية بالتدخل للإغاثة وسط ظروف جوية سيئة.
ظهرت مشاكل البنية التحتية السيئة لمناطق شمال غرب سوريا، فهي تخلو من مستشفيات كبيرة مجهّزة للتعاطي مع كثافة الحالات والازدحام الناتج عن كوارث، كما تخلو من إمدادات مستمرة وكوادر طبية مدرّبة، وتعاني باﻷصل من فقدان الأمن الغذائي والإنساني، وتنتشر فيها مجموعات مسلحة فقدت مواردها من رواتب وتجارة سلاح.
في الأسبوع الثاني للكارثة، عبرت أكثر من مئة شاحنة تحمل مساعدات أممية تضم خيماً وأجهزة تدفئة ومعدات فحص الإصابة بالكوليرا إلى شمال غرب البلاد. توّلت توزيع هذه المساعدات، الأمم المتحدة وبعض المنظمات المدنية العاملة معها، ولكنّ المفاجأة التي حصلت أنّ هذه الشاحنات لم تكن استجابة للكارثة، فقد كان مقرراً دخولها قبل الكارثة وفق تصريحات مختلفة صدرت عن عدد من الجهات الفاعلة هناك.
ما زاد الوضع سوء أنّ برنامج الأغذية العالمي، وبعد شهر على الكارثة (12 مارس/ آذار)، اختار الإعلان عن تخفيض محتويات السلة الغذائية المقدّمة للنازحين في سوريا، بما فيها مناطق شمال غرب البلاد، وهو التخفيض السادس لمحتوى السلة الذي يجري منذ العام 2020.
مناطق شمال غرب سورية بوصفها استثماراً سياسياً
على مدار سنوات الحرب، تحوّلت معابر الحدود إلى إحدى أهم نقاط التجاذبات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين القوى اﻹقليمية والدولية المتصارعة على الأرض السورية، وجادلت موسكو بأن إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا ينتهك السيادة السورية.
أثار تمديد التفويض لعملية المساعدة تلك جدلاً دبلوماسياً بين روسيا والقوى الغربية في مجلس الأمن. وبعد فيتوهات روسية، لم يبق مع الجانب التركي سوى معبر رسمي واحد هو معبر "باب الهوى" (شمال شرق حلب). في نيسان/ أبريل 2022 فرضت تركيا قيوداً على دخول السوريين المستفيدين من الحماية المؤقتة في تركيا من هذا المعبر، بهدف تشجيع السوريين على العودة إلى مناطق شمال غرب البلاد بحسب الحكومة التركية. خلال الشهر التالي للكارثة عاد أكثر من أربعين ألف سوري إلى مناطق إدلب وغرب حلب عبر "باب الهوى" وعبر ثلاثة معابر أخرى غير رسمية (جرابلس وباب السلام وتل أبيض)، بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركات السوريين من وإلى تركيا إثر الزلزال.
سوريا: اقتصاديات المعابر... وآليات التغيير
15-06-2021
دمشق، وبعد مطالبتها عبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بأنه ينبغي لدمشق أن تكون المسؤولة عن تسليم كل المساعدات في سوريا، بحيث تشمل المناطق التي لا تخضع لسيطرتها، وافقت على فتح معبرين جديدين مع تركيا لترسل من خلالها المساعدات إلى شمال غربي البلاد. يظهر أن موافقة سوريا قابلتها موافقة أممية على اعتبار دمشق محطة للمساعدات الدولية القادمة إلى سوريا، وضمنها شمال غرب البلاد، أو على الأقل جزء منها، يقدّر بالثلثين من كامل المساعدات التي وردت أو سترد، وأن تقوم الأمم المتحدة بإرسال المزيد من المساعدات والمعدات الثقيلة إلى سوريا، وقابل هذه التوافقات انتقادات لاذعة وجهها مدير منظمة "الخوذ البيضاء" للأمم المتحدة قائلاً: "إن تلك الخطوة ستسمح للأسد بتحقيق مكسب سياسي".
مع تحقيق دمشق هذه النقاط على الصعيد السياسي واﻹغاثي، كان لافتاً عدم إعطاء الاتحاد الأوروبي (والمنظمات الأممية كذلك) أيا من جهات المعارضة السياسية أو العسكرية في مناطق غرب البلاد أهمية تُذكر في عمليات تسليم المساعدات أو اﻹغاثة، مفضّلاً التعامل مع منظومة دولة (على علاتها وضعفها واتهامات الغرب لها بسرقة المساعدات) على التعامل مع هياكل شكلية أثبتت مراراً وتكراراً فشلها في كل شيء. إذا كانت دمشق قد تجاهلت في تصريحاتها الإعلامية خلال الأسبوعين الأولين من الكارثة ذكر ضحايا الزلزال في إدلب وشمال غرب حلب في بياناتها (من ضمنها بيانات وزارة الصحة وخطاب بشار الأسد) فإنها عادت لتشمل تلك المناطق في تغطيتها الإعلامية والسياسية اللاحقة.
وافقت دمشق على فتح معبرين جديدين مع تركيا لترسل من خلالها المساعدات إلى شمال غربي البلاد. يظهر أن موافقة سوريا قابلتها موافقة أممية على اعتبار دمشق محطة للمساعدات الدولية القادمة إلى سوريا، وضمنها شمال غرب البلاد، أو على الأقل جزء منها، يقدّر بالثلثين من كامل المساعدات التي وردت أو سترد.
سيطرة "هيئة تحرير الشام" على أجزاء من إدلب مثّلت بالنسبة لعمليات الإنقاذ مشكلة كبيرة للمشهد السوري ككل، فمن المستحيل على "الهيئة"، التي تتبعها "حكومة الإنقاذ" كجهاز مدني، طلب المساعدة من أي مؤسسة أو جهة في العالم والحصول فعلياً على أي شيء من أي دولة أخرى، إلى جانب مشكلة انعدام الأمن العام هناك وانتشار الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
دمشق، كانت قد أرسلت رسائل مبكرة بشأن وضع إدلب تحديداً، عبر ما يشبه التهديد بأنها لن تترك تلك المناطق دون إغاثة، ووضعت كلامها موضع التنفيذ عبر إرسال قافلة إغاثية في الأيام الأولى لتلك المناطق عبر الهلال الأحمر السوري، ولكن مسلحي "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) منعوها من الدخول بعد أن بقيت على تخوم مناطقهم ثلاثة أيام.
رسائل دمشق تلك، التي تضمنت بالضرورة حمولات سياسية، تبعتها إجراءات عملية بتحريك عدد من فرق اﻹنقاذ التابعة لها (الهلال الأحمر السوري)، وصلت إلى تخوم إدلب الواقعة ضمن سيطرة دمشق، لم تتمكن عملياً من كسر التخندق المحيط بتلك المناطق منذ العام 2018، وبقيت مساحات السيطرة نفسها عملياً على الأرض. لكن بالمقابل، حققت دمشق عبر استثمارها هذا تفوقاً على جهات المعارضة ومشغلّيها، خاصة أنّ الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها تركيا هناك لم تقم بالحد الأدنى من واجبها، وهو ما عرّضها لانتقادات دولية، عدا منظمات المجتمع المدني التي تحركت بشكل طوعي محاولةً إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبرزت هنا منظمة "الخوذ البيضاء" كإحدى أقوى المنظمات العاملة على الأرض.
سيطرة "هيئة تحرير الشام" على أجزاء من إدلب مثّلت بالنسبة لعمليات الإنقاذ مشكلة كبيرة للمشهد السوري ككل، فمن المستحيل على "الهيئة"، التي تتبعها "حكومة الإنقاذ" كجهاز مدني، طلب المساعدة من أي مؤسسة أو جهة في العالم والحصول فعلياً على أي شيء من أي دولة أخرى، إلى جانب مشكلة انعدام الأمن العام هناك وانتشار الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، وهو ما كان وما زال يعقّد مهمات الجهات الدولية. فإذا كان لدمشق ألا تدير أو تمس المساعدات التي يتم تسليمها عبر المعبرين الجديدين اللذين وافقت على افتتاحهما إلى مناطق شمال غرب البلاد لأنها تمر من تركيا مباشرة إلى هناك، فإنّ هذه الفصائل تمثّل مشكلة أكبر في سرقتهم للمساعدات نفسها. وفي حالات سابقة، اعتقلت واحتجزت "هيئة تحرير الشام" أشخاصاً لمجرد مقاومتهم إياها إثر تدخلهم في توزيع المساعدات الأممية.
يبقى حتى الآن وضع إدلب - اﻹنساني والإغاثي - غائباً كلياً عن سلّم أولويات المجتمع الدولي أو تركيا، وتترك مرة ثانية لوحدها كي تعيش مصيرها الذي عقدّته صراعات متشعبة في تلك المنطقة. بالأصل، كان الوضع هناك مفعماً بالتشاؤم ويكاد يبلغ مرحلة الانهيار.
في العام 2019 سيطرت "هيئة تحرير الشام" على محافظة إدلب. وقتها، تمّ سحب مساعدات الاستقرار إلى جيب يقع شمال غرب مناطق سيطرتها وخارجها، ولكنه يقع تحت سيطرة ما يسمّى "الجيش الوطني السوري" التابع لتركيا. هذه المجموعات المسلحة ليست أفضل من "الهيئة" في قضايا الحوكمة والشفافية والعلاقة السيئة مع مجتمعاتها المحلية، حيث تسيطر الفوضى. وفي ظل أنّ هؤلاء لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور، فإنّ وصول المساعدات سيمثل فرصة لهم لكسب المال بأي طريقة ممكنة، وهذا أدّى بالنتيجة إلى تخفيف تدفق المساعدات الدولية إلى هناك، وأثار مخاوف عدد غير قليل من المانحين في مسألة دعم تلك المناطق بعد كارثة الزلزال. يعني ما سبق أن التداعيات سوف تستمر إلى أجل غير محدد.
مستقبل المنطقة بعد الكارثة
بعد ما يقرب من الشهرين على الكارثة، عادت جبهة إدلب للتسخين عسكرياً، إذ تبادل الجيش السوري القصف مع "جبهة النصرة" عند أكثر من موقع على خطوط التماس، مما يعني أنّ قواعد الاشتباك القديمة لا تزال هي نفسها الحاكمة للتوازنات هناك، على الأقل بالنسبة لدمشق التي تشترط خروج القوات التركية المحتلة من هناك ﻹكمال سيطرتها على جيب المعارضة الأخير في سوريا.
تركيا اليوم، وهي أهم عنصر فاعل إقليمي في مناطق إدلب وشمال غرب حلب، تسعى جاهدة للتعافي من تبعات الزلزال وعلى عتبة انتخابات رئاسية وبرلمانية، عدا عن أنّ شعبها بات يناوئ إلى حد كبير وجود ملايين اللاجئين السوريين الذين شردتهم الحرب فيها، ولهذا بلغ عدد السوريين الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا ذروته العام 2022. مع كارثة الزلزال المدمر، سيحاول مزيد من السوريين الوصول إلى أوروبا أو مناطق أخرى أكثر أماناً خاصة في ظل استمرار تردي الأوضاع الداخلية في البلاد.
هل من أحد يريد الحل في سوريا؟
30-12-2020
حتى الآن، يبقى وضع إدلب - اﻹنساني والإغاثي - غائباً كلياً عن سلّم أولويات المجتمع الدولي أو تركيا، وتترك مرة ثانية لوحدها كي تعيش مصيرها الذي عقدّته صراعات متشعبة في تلك المنطقة. بالأصل، كان الوضع هناك مفعماً بالتشاؤم وكاد يبلغ مرحلة الانهيار. يقول جو إنغليش الناطق الرسمي باسم اليونيسيف: "كان الوضع في سوريا مريعاً تماماً قبل الزلازل، وكدنا أن ننساه نظراً لمرور اثني عشر عاماً عليه، على الرغم من أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت ذروتها خلال العام المنصرم"، ويظهر أنّ هذا الوضع سوف يستمر حتى وقت غير معلوم...