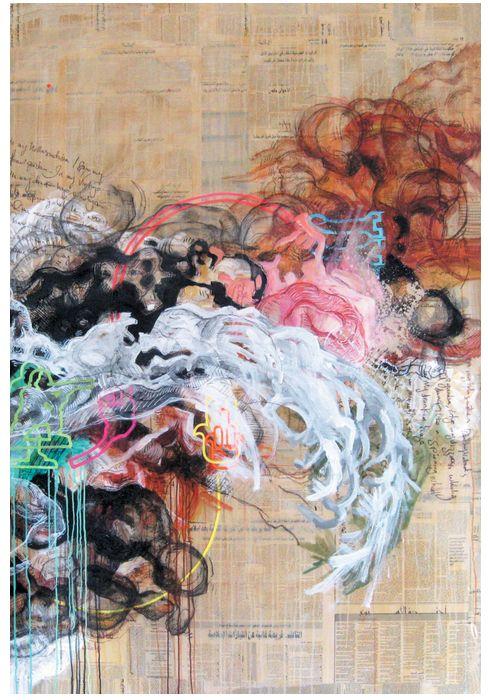الطريق من دائرة الجوازات إلى الفندق كان مسافة أخرى في المتاهة، مسافة أخرى في النزوح. كل خطوة في بغداد، وكل وجْهةٍ وجِهة، وكل شارع، امتداد لهذا النفق، ووقت مهدور من هذا العمر الذي أحاول الهرب بما بقي منه. لكنني حيثما اتجهت به يكون مثل لعبة رمي السهام (Darts)، يصوب الموت نباله نحوي، ولا أدري بأي رمية سأُقتل.
بائع الفلافل في مدخل شارع السعدون كان يرتدي قميصاً وبيجاما سوداوين. هنا في بغداد، الأسود هو لون هذه الأيام. إنها عاشوراء، العاشر من محرم وفق التقويم الإسلامي، اليوم الذي قُتل فيه الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، حين قُطع رأسه في كربلاء.
أبناء البكاء
يقف بائع الفلافل خلف قاطع من الزجاج مقسم إلى أجزاء صغيرة، يوضع في كل واحد منها: الفلافل، البطاطا المقلية، الباذنجان المقلي، السَلَطَة، ومقبِّلات أخرى تجعل السندويشة لذيذة في البلد المر. ومن زاوية في الدكان وعلى غير العادة في هذه المنطقة الصاخبة باللطميات وقراءات المقتل الحسيني، تتسرب مثل خيط من الماء أغنية لمهند محسن، أعرفها جيداً وأحبها، إنها أُغنية "الاشتياق"، تشبه تهويدة عن البلاد، وعن الاغتراب: "مشتاق اطير ويه الهوا وأوصل على بلادي.. ويه أذان الفجر شكد حلوة بغدادي.. مشتاق للماي العذب.. عطشان تعبني الدرب.. والقلب آه القلب.. ظل باسمِك ينادي.." إلى آخر هذا الحزن العراقي الذي لا آخر له.
كنتُ متعباً من الدروب، وأقف خلف ثلاثة زبائن بانتظار دوري للحصول على سندويشة فلافل بعد نهار طويل ورديء. ولم أكن بحاجة إلى تلك الأغنية لأبكي مرة أخرى، لكن، ها أنا أسمعها الآن، وأداري البكاء بأكمامي والتفاتات عشوائية إلى جهات لا أحب النظر إليها.
لفَّة فلافل مع "عمبة" (مخلّلات عراقية)، قلتُ لصاحب القميص الأسود، فلم يتأخر بتحضيرها، أخذت السندويشة وأعطيته 750 دينار عراقي، لكنه قبل أن يمسكها قال: إذا ما عندك خليها. ربما ظنَّ أنني لا أملك المال لشراء سندويشة فلافل، ودلَّه على ذلك احمرار عينيَّ من أثر البكاء، والتعب في وجهي، فشكرت كرمه اللطيف، وتبادلنا البيع، وواصلت السير إلى الفندق.
كنتُ أمشي وتتبعني الأغنية: "محتاج للسهرة وسوالف ألف ليلة وليلة.. مشتاق للموال يشكيلي واني ابكي له.. مليت من هذا البعد.. ما بيَّه حيل اصبر بعد.. مشتاق يا أجمل بلد للجبل والوادي". في العراق نحن نسمع الأغاني الحزينة ونحبها، وجودة الأغنيات وجمالها يرتبطان عندنا بمدى قوة الحزن فيها، سواءٌ في الكلمات أو اللحن أو الصوت الذي يغني هذا البكاء. لذا نشتهر بغناء "الفراقيات" واللطميات التي هي فنٌ قائم بذاته مثل فن المقامات، له رواده ومؤدوه وجمهوره الذي لا يقتصر على الشيعة فقط، كونه ينتمي للأدب الحسيني.
الحزن انفعال بشري، قوي وبسيط، مثل الفرح، لكنَّه في العراق تحوَّل عبر آلاف السنين، نتيجة الحروب، والاحتلالات، والكوارث الطبيعية، وخراب المدن، وزوال الحضارات، تحوَّل من كونه انفعالًا يزول بزوال مسبباته، إلى متلازمة في الشخصية العراقية. فالعراقي دائم الحزن بطبعه، وحينما يُخبِرنا شعبٌ ما عن صفة تُمَيِّزُه، فإننا في العراق نقول: نحن شعب يحب الحزن. في أحد ألواح مدينة أور (4000 ق.م.) ذُكر أنَّ الملك جوديا قابل الإله بعد أن هدأ قلبه بسماع الأغاني الحزينة من المغني "كالا" وعزفه على القيثارة. والـ "كالا" هو واحد من نوعين من المغنين عند الشعوب السومرية القديمة، متخصص بأغاني الرثاء، وترافقه في حفلاته الجنائزية آلة القيثارة (بلانك). وتشير الألواح السومرية إلى أن «كالا» اتسع مجال تخصصه في الغناء خلال العهد السومري الحديث (2116- 2004ق.م.) عندما كثر خراب المدن بالغزو، أو الكوارث الطبيعية، إذ صارت من مهامه الرئيسية التجول بين الناس، وأداء الأغاني الحزينة التي تدفع السامع إلى البكاء بشدة ليرتاح ويهدأ قلبه الحزين.
البكاء المموسق.. ورقة الحزن العراقية الخضراء أبداً
09-06-2017
هستيريا العراق وأغانيه الجديدة
27-06-2017
في كتابه "شخصية الفرد العراقي" يذكر علي الوردي أن طالباً عراقياً في إحدى الولايات الأمريكية ذهب لزيارة صديقه الذي يسكن مع عائلة أمريكية في ولاية أخرى فلم يجده في البيت، وجلس ينتظر مجيئه، فقصَّت ربة البيت القصص عن أدب هذا الطالب، وأخلاقه، وذكائه، واندماجه معهم، لكنَّها لم تستطع فهم شيء واحد في شخصيته، وهو أنَّه كلَّما دخل الحمام بدأ بالبكاء! وحين جاء هذا الصديق قصَّ عليه صديقه ما سمعه من ربة المنزل، فأخبره بأنه لا يبكي، لكنه حين يدخل الحمام يغنّي "الأبوذية".
والأبوذية هي أحد أطوار الغناء العراقي الذي يبرع فيه أهل الجنوب شعراً وغناءً. ومغنو هذا الطور كثيرون، أشهرهم سلمان المنكوب وحضيري أبو عزيز وداخل حسن، وهذا الأخير يُروى أنَّهُ بدأ الغناء عندما كان فتى يرعى أبقار أهله، فذاع صيته في الحي، وأرادت أمُّه منعه من الغناء فأعطته عقاراً لتخريب حنجرته، لكن ذلك تسبب له ببحَّة حزينة في صوته، جعلته متفرداً في أداء هذا الطور البكائي.
الحزن انفعال بشري، قوي وبسيط، مثل الفرح. لكنَّه في العراق تحوَّل عبر آلاف السنين، نتيجة الحروب، والاحتلالات، والكوارث الطبيعية، وخراب المدن، وزوال الحضارات، تحوَّل من كونه انفعالًا يزول بزوال مسبباته، إلى متلازمة في الشخصية العراقية.
هكذا، نشعر دائماً بالفقد. نشتاق إلى العراق ونحن فيه، ونبكي عليه، مثل اليتامى، نربّي حزننا حتى يكبر، ويصير ذئباً يعوي في صدورنا، ثم يفترسنا. "مو حزن لكن حزين"، هذه الجملة الشعرية لمظفر النواب تلخيص إبداعي لحياة العراقي، ونمط حياته اليومية، إنّه شخص دائم التشكي والانفعال، حزين على ما فات، حزين لما سيأتي، سريع البكاء. ولعلَّ هذا السلوك – البكاء - هو أكثر دلائل الحزن وضوحاً في شخصية الفرد العراقي، أو هوية المجتمع الوطنية في سمتها الجمعية. كذلك فإنَّ العراقي شريك جيد في الحزن، ويُعرف ذلك في العزاءات الكثيرة، فلا أحد يحزن وحده، ولا تكاد تميز صاحب المصيبة لكثرة الباكين حوله. وللعراقي مواسم حزن مقدسة، تظهر فيها عادته الأبرز. لنا أعياد كثيرة، نحتفي خلالها بالحزن، ونلبس من أجله الأسود، ونقيم السرادق في الشوارع، ونمشي في مواكب وقوافل نحو المراقد والمقابر، ونضرب رؤوسنا بالسيوف، وظهورنا بسلاسل الحديد، ونقيم حفلاتٍ جماعية للبكاء.
أسقط في رأسي
على بعد أمتار قليلة من الفندق هنالك مرآب للسيارات، عند مدخله حفرة بقطر ثلاثة أمتار تقريباً، حين مررنا بها أنا وصديقي علي أول مرة، قال لي إنها من أثر سيارة مفخخة انفجرت هنا، وقتلت تسعة أشخاص. لكنني في تلك المرة الأولى كنتُ ممتلئاً بصور القتلى على الطريق، وذاكرتي بها خدر من جرعة الموت الزائدة في ذلك اليوم الذي وصلت فيه إلى بغداد، لذا لم تأخذ الحفرة مكانها في رأسي مثلما حدث هذه المرة. إنها لحظة مناسبة لأسقط فيها، فوقعتُ في رأسي، أتحسس المكان لحظة الانفجار، وأتخيل أشلاء القتلى هنا وهناك، وامتلئُ بالصراخ والدم والنيران، وأمد أصابعي في الثقوب التي تركتها الشظايا على الجدران، وأعمدة الكهرباء، والأجساد.
"الله يساعدك" قالها لي شخص اقترب مني فأخرجني من رأسي. انتبهت أنني لم أكن في المكان، كنتُ في ماضيه، فرددت عليه التحية، وبادرني بالسؤال: مضيّع شي؟ محتاج شي؟ فشعرت بالورطة:
- لا والله بس أخذتني الصفنة، قلتها وضحكت،
- الله يكون بالعون، بس لا تصفن هنا، الناس تخاف من الغريب، أنت جديد هنا؟
- اي والله، آني طالب وسكنت بفندق زوزك
- مبين عليك، آني أخوك مصري، بس هسه عراقي، صارلي 40 سنة هنا واشتغل بهاي الكَهوة
- حياك الله، على راسي
بأسلوب مهذب دعاني لشرب الشاي في المقهى الشعبي الذي يعمل فيه، ففهمت منه أنَّ عليَّ الانصراف من المكان قبل أن تلاحظني العيون، فأنا مثلما قال، غريب، والمكان خطير، ومن يعش أربعين سنة هنا، يعرف ما قد يحدث لشخص مثلي، فشكرته وأكملت طريقي إلى الفندق.
ليست هذه المرة الأولى التي أسقط فيها برأسي. يحدث هذا كثيراً، ومنذ زمن بعيد لا أتذكره، لكنني أتذكر مرةً أنني توقفتُ فجأة أمام نقطة تفتيش للجيش الأمريكي في مدينة الرمادي، كان ذلك بعد "مجزرة حديثة"، التي قتل فيها الجنود الأمريكيون 25 مدنياً عراقياً، بينهم 10 نساء وأطفال، عندما اقتحموا عدة منازل في مدينة حديثة غربي العراق وأعدموا من فيها.
حينها لم أنتبه أنني أقف قبالة قناص أمريكي. كنتُ ضائعاً في التذكر، واسترجاع مشاهد عشوائية لا يربطها ببعضها سوى العنف الذي يشبه صوراً معلقةً على خيط الزمن: مشهد دخول أول رتل عسكري أمريكي إلى مدينة الرمادي عام 2003، قصف منزل بطائرة F16 ومقتل 19 شخصاً (ثلاث عوائل كانت تسكن فيه)، ومشهد دفنهم في تسعة قبور بسبب اختلاط أشلائهم واختفاء بعضها. أبي وهو يضربني أمام الركّاب لأنني ذهبتُ إلى السوق خفيةً منه، وحين رجعتُ ركبنا مصادفةً في الكوستر (الباص) نفسه، سقوط قذائف الهاون في المرآب الذي كنتُ أعمل فيه محاسباً وسط مدينة الرمادي، جنازة الحاج ذهب ودفنه في المقبرة التي أشيع أن فيها شجرة على هيئة إنسان يرفع يديه بالدعاء، ويُسمع منها صوت بكاء في الليل.
بأسلوب مهذب دعاني لشرب الشاي في المقهى الشعبي الذي يعمل فيه، ففهمت أنَّ عليَّ الانصراف من المكان قبل أن تلاحظني العيون. فأنا مثلما قال، غريب، والمكان خطير، ومن يعش أربعين سنة هنا، يعرف ما قد يحدث لشخص مثلي. فشكرته وأكملت طريقي إلى الفندق.
أعادني إلى وعيي ضوء الليزر الذي وجهه القناص إلى رأسي، وصرخاته التحذيرية: Go.. goooo ، فانتبهت أنني أقف في موضع موتي، فأسرعت هارباً إلى البيت. وأنا مذّاك، كلَّما تذكرت ذلك الشرود، شعرت بحرارة الضوء الأحمر على وجهي، الذي كان يمكن أن يكون رصاصة.
صندوق الموت
في بغداد، كان شعور الخوف يقبض على قلبي دائماً، ويتحول إلى حالة من الهلع حين أمشي في الأماكن المزدحمة، الشوارع المكتظة بالباعة والناس والمركبات. كانت هذه الأماكن هي هدف تنظيم "القاعدة" المفضل، ومن ثم تنظيم "داعش" لتنفيذ العمليات الانتحارية، سواءٌ بسيارات مفخخة أو بإرسال الانتحاريين يفجّرون أنفسهم وسط الحشود. وعادةً ما يتَّبع التنظيمان تكتيك التفجيرات المزدوجة: يحدث الانفجار الأول، وعندما يحتشد الناس لإسعاف الجرحى يقع الانفجار الثاني، لإيقاع أكثر عدد من القتلى، وإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر.
حي البتاويين في بغداد: بؤس قاع المدن
23-04-2017
كنتُ أمشي ورأسي مشوش بالتخمينات وانتظار ما سيقع بأية لحظة. إنه وضع يشبه المشي في حقل ألغام، أو أرض فخاخ، لا أدري ماذا سيحدث في الخطوة التالية. وكان هذا الجنون بعينه. من حوَّل بغداد إلى مصيدة؟ وصندوق مغلق للموت؟ الناس هنا غاضبون، ومتشنجون، وحذرون، ومستفزون دائماً، ومعتادون على الضجيج. كل شيء في بغداد ينتمي إلى الصخب، ويأخذك من حيث تدري ولا تدري إلى مناطق التشويش: أسلوب قيادة السيارات في الشوارع، الحوارات بين الأشخاص في المقاهي والدكاكين وعلى الأرصفة، طريقة الباعة والحمالين في جذب الزبائن. إنها تعذيب حقيقي، صراخ لا يتوقف. وبطبيعة الحال، الأغاني واللطميات، وأصوات المولدات الكهربائية، سواءٌ تلك الصغيرة على الأرصفة، أو الكبيرة في المناطق السكنية والتجارية، إنها مدينة تشبه المصنع الكبير.
أعادني إلى وعيي ضوء الليزر الذي وجهه القناص إلى رأسي، وصرخاته التحذيرية: Go.. goooo ، فانتبهت أنني أقف في موضع موتي، فأسرعت هارباً إلى البيت. وأنا مذّاك، كلَّما تذكرت ذلك الشرود، شعرت بحرارة الضوء الأحمر على وجهي، الذي كان يمكن أن يكون رصاصة.
في الليل يهدأ كل شيء، مثل المصنع تماماً، ينطفئُ، لكنَّ التعب يظل في المكان، أشعر بذلك من الطريقة التي يمضي بها الوقت، ويتغير بها مزاج المدينة، وألوانها، وحركة الناس. في بغداد، الجزء يشبه الكل، والعكس صحيح. أستطيع اشتقاقَ حديثٍ عن شارع ما، أي شارع، أو بناية، أو مشهد، أو مجموعة من الناس، وأنا بذلك أعني كل الحياة في المدينة، تماماً مثل التفاضل والتكامل في الرياضيات، يمكن تطبيق مفهوميهما "نظرياً" على بغداد.
كان عليَّ أن أنام مبكراً لأستيقظ مع الفجر، وأعود إلى مدينة الرمادي لتجديد الجنسية. لكن ما سأواجهه في الرحلة أقضَّ مضجعي، وأرّقني للحد الذي لم أستطع فيه النوم أبداً. كنت أعرف الطريق، والطريقة التي سأصل فيها - إن وصلت - إلى هناك، إلى المدينة التي تتآكل يومياً، ويسيطر عليها تنظيم "داعش" شيئاً فشيئاً.
اتخذت قراراً بأنني لن أعود إلى بيتنا، ولن أخبر أهلي بما حدث، ولن أراهم مرةً أخرى. لم أرد رؤية أمي وهي تبكي ثانيةً، ولا استعادة لحظات الوداع تلك. هذا الحزن كثير وثقيل عليَّ لأحتمله في يومين. كذلك لم أرد العودة إلى المكتبة. لن أفتح الباب الذي أغلقته للمرة الأخيرة. أردت للنهاية أن تظل مناسبةً مثلما اخترتُ تفاصيلها الهامشية الصغيرة، لا كما أنا مجبرٌ على القيام به في هذه المحاولة الخطيرة.
كنتُ أمشي ورأسي مشوش بالتخمينات وانتظار ما سيقع بأية لحظة. إنه وضع يشبه المشي في حقل ألغام، أو أرض فخاخ، لا أدري ماذا سيحدث في الخطوة التالية. وكان هذا الجنون بعينه. من حوَّل بغداد إلى مصيدة؟ وصندوق مغلق للموت؟ الناس هنا غاضبون، ومتشنجون، وحذرون، ومستفزون دائماً، ومعتادون على الضجيج. كل شيء في بغداد ينتمي إلى الصخب..
اتصلت بصديقي حيدر، وأخبرته بالقصة، ومثلما يفعل دائماً معي، عرض المساعدة بلا تردد، وأخبرني أنَّ خاله محمد يعرف ضباطاً في مديرية الجنسية، ولن يستغرق تجديدها أكثر من ساعة ربما، واتفقنا أنني سأمكث عنده في البيت، لحين تجديد تلك الجنسية عديمة الفائدة، وأعود مرةً أخرى إلى بغداد.
الدخان: جدائل مدينة تغرق في المدى والحروب
في كراج العلاوي، أشرقت الشمس وأنا أجلس في مقعد "الكيَّا" الخلفي، انتظر "تقبيطة الركاب" (امتلاء الباص) ليتحرك السائق بنا إلى معبر بزيبز مرة أخرى، ومنه أعبر إلى محافظة الأنبار، بالطريقة ذاتها التي جئت بها. لا أدري ماذا سيحدث، لكنني أعرف أن بانتظاري ساعات طويلة من الخوف، وطريق مليء بالجنود وحواجز التفتيش والموت الذي قد يظهر بأية لحظة، تماماً مثلما خبرت كل هذا في المرة الأولى.
لم يتغير شيء. الوقوف عند الحواجز الأمنية ذاتها، وأسئلة الجنود المعتادة: من وين جاي؟ ووين رايح؟ تفتيش وأسلوب فظ يذكرك دائماً أنك في مكان شديد الخطورة، وأن عليك الهرب بأسرع ما تستطيع من هذا كله، قبل أن تصبح جزءاً منه، قاتلاً أو مقتولاً، أو البقاء نازحاً، مثلي على أقل تقدير. وهذا هو الجحيم بعينه وفمه.
تشريح العزلة.. بورتريه لرجل خائف ووحيد
19-03-2020
قطعت معبر بزيبز مشياً على الأقدام (وهي الطريقة الوحيدة لعبوره)، وكان النازحون يقطعونه قوافلَ باتجاه بغداد، الجميع يحملون معهم الحقائب، بعضهم يجرها خلفه، وآخرون استأجروا الحمالين الصغار المنتشرين على جانبي الجسر لجرِّ الحقائب الكبيرة بالعربات الحديدية. اخذني المشهد بعيداً، 15 سنةً إلى الوراء، عندما كنتُ حمَّالاً بعمرِ هؤلاء الصغار، وكانت لدي عربة حديد أيضاً، أجرَّ بها الحصة التموينية للعوائل أيام الحصار، مقابل أجرٍ لا يتعدى الدولارين خلال النهار.
اتخذت قراراً بأنني لن أعود إلى بيتنا، ولن أخبر أهلي بما حدث، ولن أراهم مرةً أخرى. لم أرد رؤية أمي وهي تبكي ثانيةً، ولا استعادة لحظات الوداع. كذلك لم أرد العودة إلى المكتبة. لن أفتح الباب الذي أغلقته للمرة الأخيرة. أردت للنهاية أن تظل مثلما اخترتُ تفاصيلها الصغيرة، لا كما أنا مجبرٌ على القيام به في هذه المحاولة الخطيرة.
دائماً أصل عندما ترحل الشمس إلى جهة الغروب، قلتُ هذا وأنا أرى بوابة مدينة الرمادي التي لم تكتمل بعد، وتوقف العمل بها عندما بدأت العمليات العسكرية، مثلما توقف كل شيء هناك، سوى الموت، الذي ينمو في الشوارع والبيوت، ويتصاعد على هيئة دخان أراه الآن يرتفع عالياً، كأنَّه جدائل مدينةٍ تغرق في المدى والحروب.
نوفمبر.. موعد للرحيل أو الهرب
15-04-2021
بغداد.. مدينة القتلى والظلال الطويلة
22-04-2021
سأموت هنا.. في العراق
13-05-2021