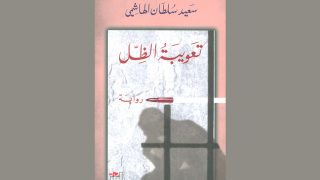(1)
هرجٌ محتدم، حشدٌ كبير يمور بالاشتعال، صخب أعمى ينفلت بتسارع، بوادر عراك عنيف بالأيدي. خلاف بين فريقين نتج عن المطالبة بمحاسبة رموز دينية تدور عليها شُبهات فساد مالي وإداري. فريق يرى بأنه الأقرب إلى الله والأحق به، لذا فإن رموزه فوق أي شبهة أو تهمة. وفريق آخر لا يُقرّ بذاك الامتياز وتلك القُربى، ويرى أن البشر أحرار في علاقتهم بربهم، وأن الفريق الأول لا يحق له أن يتمتع بأي استثناء من مساءلة أو محاسبة مهما كانت ألقاب اصحابه، أو مسمياتهم، أو أنسابهم، أو درجاتهم أو وظائفهم.
صوت هادئ، عميق يخترق ذاك الضجيج، يأتي في التوقيت المناسب، مستلّاً الإقناع والإعجاب والحسم في آن واحد.
صوت عبد الله حبيب: "يا جماعة، يا جماعة، كلنا نحب الله. الفرق أن هناك من يحبه بلحية، وهناك من يحبه بدونها".
الزمان: نبسان/ إبريل 2011
المكان: ساحة الشعب ــ مسقط
(2)
القاضي: "هل كتبت هذه العبارة ضمن عبارات أخرى على حسابك الشخصي في وسيلة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): كل هذي التهاني بالجوع والعطش والرائحة الكريهة للفم ونقص الغلوكوز في الدم وموائد العشاء التي يكفي نصف ما يُلقى منها في الزبالة لإطعام نصف الشعوب الجائعة في أفريقيا..".
عبدالله حبيب: "نعم يا فضيلة القاضي، كتبتُ هذه العبارات، وإذ اعترف بأني استخدمتُ عبارات كهذه قد تكون حساسة للبعض، ومنفرّة للبعض الآخر، وبلغة حادة، إلا أني اعتذرت للجميع في الوسيلة ذاتها، وفي حينه، وأكرر اعتذراي هنا، أمام هيئة المحكمة. أنا أؤمن بالله وأحبه، وأريد أن أؤكد بأن ما نشرته لا يخرج عن نطاق ما يدور ويتم تداوله من جدل فقهي واختلافات في الرأي والتفسير، لا أكثر، وأن نقدي كان مُصوباً لأفعال الناس وللقائمين على إدارة الشأن الديني وليس موجهاً للدين نفسه".
القاضي: "حكمت المحكمة حضورياً بإدانة عبد الله حبيب بجنحتي التجديف على العزة الإلهية والتطاول على المعتقدات الدينية، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والمساس بالقيم الدينية، وقضت بسجنه ثلاث سنوات (ينفذ منها ستة أشهر) وتغريمه ألف ريال عُماني..".
الزمان: نيسان/ إبريل 2018
المكان: ساحة المحكمة ــ مسقط.
(3)
السجن لإنسان وشاعر وسينمائي وكاتب ومثقف بحجم ومقام عبد الله حبيب، أكبر من خسارة وأعمق من عجز. أخطر من هدر وأوضح من قهر. السجن لرجل قضى عمره كله (55 عاماً) في نحت الزمن وتعمير الفضاءات بالفن، بالشعر، وبالعمل الشاق، وبالنضال الراعف لأجل أن يكون إنساناً وكفى (وأي نضال أشقّ من أن يكون الإنسان إنساناً، قيمةً عليا في ذاته؟). سجن إنسان كعبد الله حبيب بمثابة اضرام النار في واحة بهيجة وسط صحراء مقفرة. علامة من علامات اختلال الموازين. وإلا فكيف لذاتٍ حرّة، نموذج عضوي متقد الهمّة، حالة ثقافية دائبة، تحفر بأظفارها مسالك معارفها وتفكّراتها، نفسٌ كريمة، عاشقة للأرض وأشجارها وأحجارها وأناسها.. كيف أن تودع في غياهب السجون؟ ثم يسعنا الفضاء لندّعي بأننا دولة "لا تصادر الأفكار"؟ كيف لروح مستقلة تتلاحم وتتشابك بالأمشاج الحميمة مع كل ضعف وتوتر وهشاشة واكتئاب وأرق وقلق العالِم أن تُحبس بمعية من خرّبوا العقول والأحلام بالمخدرات والسرقة والتسلل، وفي العنبر ذاته؟ ثم نجرؤ على رفع عقائرنا بمقولات "القانون" و"العدالة الناجزة"! كيف لقلب كبير فائض بالعذوبة وبالصدق وبالوفاء كقلب عبد الله حبيب يسكنه حبٌ حارق للبلاد، للتراب، للثورات، للأمهات، لمريم إبراهيم، للشهداء، للمنسيين، للراحلين، لذاكرة البحر والحنين، لتعّوب الكحالي.. كيف لقلب كهذا أن تحاكم نواياه وتُفتش إيمانياته طوال ما يقارب السنتين؟ ثم ننشر، على أوراقنا الصقيلة وبلغات العالم المختلفة عن ريادة تجربتنا في "التسامح" و"التعايش" و"حوار الأديان وتجانس المذاهب"؟
كيف لذاتٍ حرّة، نموذج عضوي متقد الهمّة، حالة ثقافية دائبة، تحفر بأظفارها مسالك معارفها وتفكّراتها، نفسٌ كريمة، عاشقة للأرض وأشجارها وأحجارها وأناسها.. كيف أن تودع في غياهب السجون؟
عبد الله حبيب الذي قُدّ من نسمة، ورضع من عاصفة. عبد الله الذي رفع الغرام في الوقت الذي وقع الجميع في الغرام. عبد الله الذي عشق عزلته واشتراها بأبهظ الأثمان.. لا يستحق منّا هذا كل العقاب الممعن في الأذى. بل هو حقيق بالتكريم والإعزاز.
روحه المعلقة على كل نجمة تحرس الليل. دمه الذي يغلي من جور الأقدار على عامل النظافة الذي يكنس شارع مسقط السريع كل صباح. شِغافه التي تلامسها أدق نملة تسرق من كيس السكر المندلق على أرضية مطبخه المهجور. العبدُ لله الذي أصغى لحدسه باكراً، وصدّق ولعه والتباساته فتجذّرت روحه بالرقة الصلبة وبالقساوة العذبة ليكون جديراً بإنسانيته التي لا تشبه أحداً سواه.
من كل تلك التناقضات يتزوّد عبد الله حبيب، بمادته السرية، جمرته المختبئة في أحشائه. فإذا ما هبّت رياح الظلم وحاصرت الضعفاء والمهمشين والمتروكين، تورّدت تلك الجمرة، احمرّت، اشتعلت، ليس قولاً فحسب، ولا تنظيراً مُحمّلاً بأفكار ألمع من فَهِم العالم وفقط، بل ذوباناً في الميدان، وسخاءً بالأموال والأوقات. توحداً مع المظلوم وفضحاً للظالم. وهو الذي ما طفق يردد بيننا مقولته: "لك يوم يا ظالم، أما المظلومين فلهم كل الأيام".
أزيد عن عشرة كتب، أوسع من خمسة أفلام سينمائية، وفوقها أكثر من ثلاثة عقود بأيامها ولياليها ولحظاتها من الحضور الكثيف والتفاعل المحموم بالروح واللحم والدم والعظم مع قضايا الإنسان: شاعراً وناقداً وباحثاً وملتقطاً وحافراً وساخراً وراسماً وكاشفاً وباكياً وعامراً بالحب والفقد والفلسفة والسينما والموسيقا والنشيج. هذا الفرد الهائل المسكون بكل هذه الإنسانية يقف اليوم وحيداً في زنزانته. سجيناً يختبر فينا كلمات، عبارات نكررها كل يوم، نلوكها كل لحظة، ننتهكها في كل حين، من دون أن يكون لها معنى. كلمات من قبيل "القانون والعدالة"، "الإيمان والتدين".
إن سجن إنسان كعبد الله حبيب يُعرّينا أمام حقيقتنا. يكشف لنا إلى أي مدى نحن أقرب إلى عبادة النصوص، ترديد الكلمات، تكرار التفسيرات، حفظ القوالب. ثم يصدمنا إلى أي منفى نحن قد أبعدنا روح الشرائع. تلك الشرائع التي لا تتقدم إلا بتقدم وعي الضمائر البشرية بذاتها، ولا تتطور إلا بمواجهة تناقضاتها، الارتطام بأسئلتها الحرجة، اجتراحها مساحات وفضاءات تفكير كانت تخاف الاقتراب من حدودها، تخشى ارتياد محيطها، ملامسة عمقها، بالكلام ابتداءً، ثم بالنقاش الجماعي وأدب الجدل الرفيع، تُتبعه بعدئذ اجتهادات صبورة ومثابرات دؤبة في البحث والتقصي والحفر المنهجي. فأي وزن لنص لا يكترث لفكرة العدالة ولا يخدم سيرورتها في تقدم الإنسان وحفظ كرامته؟ أي قيمة لقانون لم يُساءل ضمائرنا إنْ كانت مطمئنة لحق البشر في أن تتكلم وتختار وتُجرّب الطريقة التي تعبّر فيها عن أفكارها وتصوراتها للحياة والوجود؟
ألا ندرك خطورة أن يتضائل أناس كهؤلاء من حياتنا؟ ألا نكترث لعواقب انسحابهم من مهمة شحذ ضمائرنا، تذكيرها لنا بأن ثمة اختلافات تجعل الحياة أجمل بعيداً عن التماثلات وعقليات "لا أريكم إلا ما أرى".
يأتي سجنٌ كهذا ليرفع الغطاء عن شهوة عصابية مصابون بها حتى النخاع: الشق عن قلوب البشر والتلذذ في إصدار أحكامنا الأبدية حول درجات قربهم وبعدهم من الإله. مطلقين الحق لأنفسنا في منح صكوك البراءة أو الإدانة وفق خبراتنا المحدودة لمعرفة أمر غير محدود ولا ملموس كالإيمان. وإلا كيف يمكن أن تقيس إيمانك الخاص بك؟ ومتى بمقدورك الاعتراف بأنك وصلت الدرجة الكافية منه؟ ثم هل الطقوس والعبادات التي تؤديها وحدها كفيلة لفعل ذلك؟ أم شهادة المحيطين حولك قادرة على إلباسك بُردة الإيمان؟ وإلى متى؟ ثم أين المروءات التي تحفظ حرمة الإنسان في غيابه وعجزه عن الرد والحوار ومقارعة الحِجاج؟
إن سجن عبد الله حبيب يثوّر كل هذه التساؤلات فينا، يُعيدنا إلى مخاوفنا البدئية من العصبويات المنفلتة، من كراهياتنا المختمرة في أقفاصنا الصدرية تجاه المختلفين عنا في خيارات الحياة، يحبس أنفاسنا خوفاً من بلادة القوالب الجاهزة، والتلقينات المُرسلة، والينبغيات المعلبة، والمسلمات المرعبة، التي تتحكم في اليومي والمعاش من حياتنا القصيرة. هذه المنتجات، هذه السلع الرائجة والمحمية، غير المُختَبرة، وغير المساءلة من الضمائر الحية باستمرار، والتي تحوّلت سريعاً إلى تشريعات وقيود وسجون ومعتقلات أبدية تلتهم أولئك الذين تجرؤوا على التفكير، على التساؤل في الفضاء العام، تغتال كل محاولة لخلق جدال متمدن علني لفرز الأفكار واختبارها. تحبس رجل كعبد الله حبيب، تؤذيه، تتوعده بالويل والعذاب، لا لشيء سوى أنه لم يكن منافقاً ولا خائناً لمعتقداته ولا لأفكاره. بسطها في الحيّز العام كما يُحدّث بها نفسه، وكما أوضحها لقضاة التحقيق والقضاة الذين أيدوهم بالحكم النهائي. ألا ندرك خطورة أن يتضائل أناس كهؤلاء من حياتنا؟ ألا نكترث لعواقب انسحابهم من مهمة شحذ ضمائرنا، تذكيرها لنا بأن ثمة اختلافات تجعل الحياة أجمل بعيداً عن التماثلات وعقليات "لا أريكم إلا ما أرى". إنهم يلوذون بالصمت، ينطفئون بجراحهم النازفة، يبتلعهم شعور متعاظم باغتراب مُركّب يتعمّق جراء التوحش المحيط، المتدرع بالكثرة، واللائذ بالنصوص المكرورة، والمحمي بالقوة المُطْبِقة على الأنفاس.
"لا يستطيع كل أحد أن يرى الحقيقة، ولكن كلّ أحد يستطيع أن يكونها" (كافكا ــ ترجمة عبد الله حبيب نفسه).