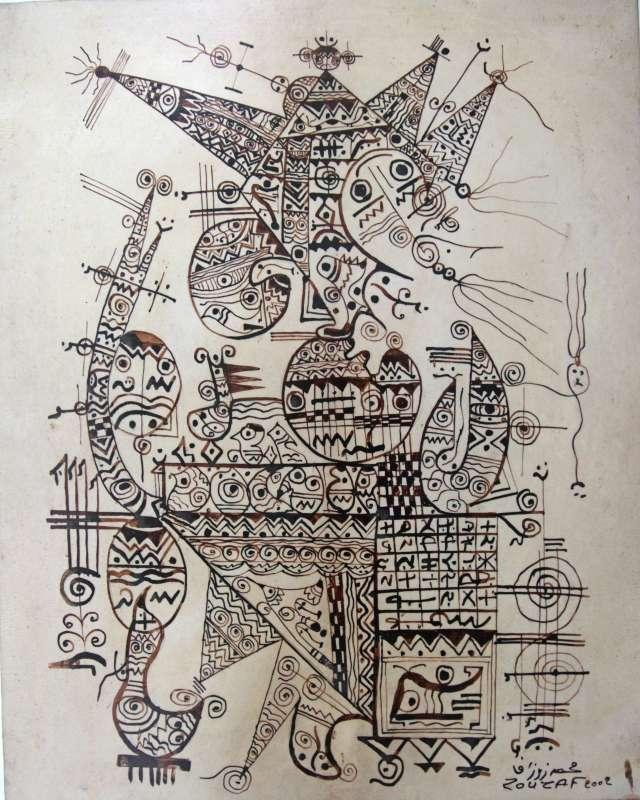كانت لحظة تشبه إجلاء المصاب إلى وحدة طبية، بعيداً عن المعركة، بعيداً عن الموت، والإحساس الدائم بالنهاية، ومحاولات القتال (بكل أشكاله) للنجاة. كنت متعباً للحد الذي شعرت بالثقل الهائل للعبء الذي ألقيته عن كاهلي الآن، جسدي منهك من الحياة/الحرب، وكل خلية فيه تريد أن تتوقف وحسب.
هكذا استسلمت لهذا التفكيك الفيزيائي الذي يحدث الآن في جسدي، ورأسي خالٍ من أي فكرة، هو الآخر يريد أن يهدأ. رأس متعب من الذاكرة والناس والحياة، والحرب، لا أبحث عن شيء الآن سوى البقاء هكذا، أتحسس الخدر الذي يسري بكل ذرة من هذا الجسد، خدر يشبه تسرب الماء في شقوق الطين اليابس.
تمارين روحية
قبل ليلتي الأولى في إسطنبول، قبل هذه اللحظة التي يحدث فيها كل هذا، كنت قد جربت شعوراً مماثلاً بالخدر، لذلك فأنا أعرفه. الأمر يشبه كثيراً تدخين الماريوانا عندما تجربها في أوقات متباعدة، وتأخذك إلى الأعلى، ثم بعد فترة ما، طويلة على الأغلب، تحصل على نَفَسٍ ثمين، فيسري خدر يبدأ من أعصابك، تتحسسه ينتقل في الخلايا، يمر بالعظام كأنه يمسح عليها بيد ناعمة، فيتركها رخية وهادئة، ثم يتحول إلى غيمة في الرأس، ترتفع وترتفع حتى يدخل كل الكون في جمجمتك، نجوم ومجرات وغبار كوني ومادة مظلمة، تتسع حد أن تتوحد مع ذرات الوجود.
عن ذهب العارفين وعبقرية السالكين
27-12-2017
هذا الشعور كنت أجربه في المكتبة في الرمادي، في ليلها العميق، وهدوئها الذي يلقي على كل شيء صفة الجلال، ويجذبني نحوه كأنه هالة سحرية. كنت أغتسل بالماء البارد وأضع العطر الذي أشتريه من العطار السوداني، وأذهب إلى ركن المكتبة الأيمن، كنت أسميه "ركني الآمن" أقف هناك وحدي، أصلي وأبكي، ثم أجلس طويلاً أجرب الخشوع وأحواله، واستشعار الكون، كان الأمر يشبه تمريناً روحياً، أو رحلة تأخذني إلى منطقة أعلى. كنت أشعر أنها أعلى، والوصول إلى هناك يشبه الأوركازم، حتى جسدياً. منطقة كنت أسميها التناغم مع الكون، واستشعار كل ذرة فيه، وكان الدعاء المحبب إليَّ: اللهم أجعل كل ذرة في جسدي تستشعر عظمتك، ووجودك. وكان هذا الدعاء هو الذي يردده أمين المكتبة الشيخ خليل باستمرار.
الزمن والإدراك
قرأت مرة، أن دراسة أجريت على مجموعتين منفصلتين من الفئران، مجموعة كان العلماء يحقنونها – بانتظام - بمادة تحفز "الدوبامين" في الجسم، والمجموعة الثانية، يحقنونها خلال فترات متباعدة بالمادة نفسها، فكانت النتائج أن المجموعة الثانية كانت أجسامها تتفاعل بقوة مع تلك المادة، ومستويات الدوبامين فيها تكون عالية. فالانقطاع (زمنياً) يجعل الجسد يتعامل مع الأمر على أنه تجربة جديدة، وهذا تفسيره أن الجسد لم يكوِّن تقنية التوقع بعد، إذاً فهما الزمن والإدراك.
الزمن: بعد تجربة المكتبة لم أحظ بأوقات جيدة، عملت في مجال الهندسة المدنية، تحديداً في تصميم الخلطات الإسفلتية المستخدمة في تعبيد الطرق. وكانت الأيام عادية، أذهب إلى الوظيفة وأعود إلى البيت، والتقي بالأصدقاء وأشارك في التظاهرات، ثم الاعتصامات التي استمرت سنة كاملة، وأكتب قصائد وطنية مترهلة بسبب أورام الحماسة الزائدة. وصرت أنسى نفسي للحد الذي كنت أخرج في تظاهرة – مشياً على الأقدام - لمسافة 12 كيلومتر، وأنا أهتف حتى تتمزق حبالي الصوتية، وتتورم قدماي من المشي. كنتُ أريد بأي طريقة جعل الحياة الجماعية مثالية، وكان هذا فخ وقعت فيه وأنا أعرف ألاّ نجاة جماعية، أو على الأقل هي تتكئ على النجاة الفردية، فإن تداعت هذه سقطت تلك، لكنني كنتُ عنيداً، وصلباً بما فيه الكفاية لأكسر.
مرت الأيام وجاءت الحرب، وتداعى كل شيء، وضعت في النجاة من الموت، لا أدري أي السبل آمنة، وأيها يختبئ فيه الموت، فجربت النزوح متنقلاً بين الأحياء والمدن والقرى، وصارت فكرة الحصول على السلام الداخلي مثل الحصول على "فيزا شنغن" إلى مدينة أمستردام وأنت نازح تعيش في خيمة فارغة من أي شيء تماماً، في مدينة صغيرة محاصرة من قبل تنظيم داعش، ولا تمتلك فيها أجرة التاكسي للخروج إلى أي مكان.
بعد 26 سنة، جربت للمرة الأولى وسائل النقل العام: الباص، المترو، التراموي، السفن، وحتى التلفريك. في الرمادي لا وجود لأي وسيلة نقل من هذه. في إسطنبول لا يضيع المرء أبداً، فحتى وإن نسي وجهته، تدله اللافتات، وأناس طيبون يقترحون عليك ماذا عليك أن تفعل لتصل بأمان. وهذا كله كان جديداً علي، أعني أن تعيش في مدينة.
هكذا من نزوح إلى نزوح، ومعركة إلى معركة، ومن سقوط مدينة إلى أخرى، والهروب من الدمار الذي كان فماً للموت يلتهم الناس والأرض. انشغلتُ عن النجاة بأسبابها، وامتلأت بالهواجس والكوابيس، وصرتُ بعيداً عني، كنت أشعر بالتغيير يجري في داخلي، واسمع الصخب في رأسي: صخب القصف والرصاص وصراخ ذوي القتلى، الذين كانوا يسقطون كل يوم، وبينما كنت ممتلئاً بكل هذا، نسيت الأوقات الجيدة، نسيت تلك التمارين الروحية، والرحلة إلى الأعلى، خِلْواً بنفسي من الناس، أجرب الأحوال واستشعر خدرها اللطيف.
الإدراك: لذا عندما استلقيت على السرير أول مرة في إسطنبول، ورميت عبء النجاة من الحرب، وتحررت من كل شيء، كان قد مرّ على شعوري بالأمان زمناً طويلاً، وحين استشعرته جاء قوياً بما يكفي لأتلذذ بخدره وأغيب في وجهي الذي يظهر أمامي في خمس مرايا صغيرة معلقة على الحائط كأنها ورقة عباد الشمس.
والصبح إذا تنفس
الصبح في إسطنبول لا أجد له وصفاً مناسباً سوى الآية القرآنية: والصبح إذا تنفس. إنه يتنفس بالفعل، النوارس تحلق في سماءات الشوارع الفرعية، والأحياء هادئة، والعصافير آمنة على الشرفات، وهناك أشجار في كل مكان، تقف للمارة وتمنحهم الأخضر والظل. الصباح في هذه المدينة يشبه موسيقى معزوفة "فالس الربيع" (Spring Waltz).
لاجئو تركيا: وضع "الضيافة" المؤقتة
15-12-2020
كل شيء يلفت الانتباه في إسطنبول. لكن اللافتات كانت تثير انتباهي جداً، لافتات كبيرة ومضيئة، ألوان وصور وتصاميم ولغة، الحياة الحديثة معروضة لك على جدران هذه المدينة الجميلة، لكن اللافتات كانت تأخذني إلى مناطق بعيدة في الذاكرة، للحظة ما، تعيدني إلى تلك الجدران في مدينة الرمادي التي تحولت إلى مساحات إعلانية للموت: لافتات سوداء، مكتوب عليها باللون الأصفر الكئيب عزاءات طويلة لأشخاص قتلوا في الحرب. ولافتات أيضاً تدعو إلى القتال، معلقة على الجدران القديمة والأعمدة الكهربائية، كتبت عليها عبارات التعبئة للمعارك، وقتال تنظيم داعش. ولافتات على جدران منازل معروضة للبيع، وأخرى لمرشحين وسياسيين لا يأتونها إلا في مواسم الانتخابات، وعندما بدأت الحرب، هربوا مع عوائلهم إلى المدن الآمنة خارج العراق.
لا أدري إن كانت هذه سخرية القدر أم لا، لكنني رأيت لافتة الكترونية مضيئة، فوق أحد المتاجر باسم IS IS مع وجود فراغ وسط الكلمة، حينها كنت رفقة أصدقاء لهم تجربتهم مع الحرب، ضحكنا ووقفنا أمام المتجر طويلاً ونحن نعقد المقارنات، ونؤلف النكت على الفرق بين الـ IS IS في إسطنبول والـ ISIS هناك، في العراق.
بعد 26 سنة، جربت أخيراً وللمرة الأولى وسائل النقل العام: الباص، المترو، التراموي، السفن، وحتى التلفريك. في العراق لا وجود لأي وسيلة نقل من هذه، في إسطنبول لا يضيع المرء أبداً، حتى وإن نسي وجهته، هنالك لافتات تدل على كل شيء، وأناس طيبون يقترحون عليك ماذا تفعل لتصل إلى وجهتك في أمان، وهذا كله كان جديداً علي، أعني أن تعيش في مدينة. لم أعرف هذا التناغم من قبل، كنت أعرف التشويش، والصخب، وحروب الشوارع داخل الأحياء.
كل شيء يلفت الانتباه في إسطنبول. لكن اللافتات كانت تثير انتباهي جداً، لافتات كبيرة ومضيئة، ألوان وصور وتصاميم ولغة، الحياة الحديثة معروضة لك على جدران هذه المدينة الجميلة. لكن اللافتات كانت تأخذني إلى مناطق بعيدة في الذاكرة، تعيدني إلى تلك الجدران في مدينة الرمادي التي تحولت إلى مساحات إعلانية للموت.
في السنة الأولى سكنت في يني بوسنا. هنالك حيث مقر "قناة الفلوجة" الجديد، كذلك هي منطقة قريبة جداً من مطار أتاتورك عندما كان مطاراً دولياً. الناس هناك طيبون جداً، وبسطاء، والحي جميل وهادئ، لدي الكثير لأحكيه عن يني بوسنا، لكني أريد الحديث عن شريف، صاحب المطعم الصغير في شارع الحي الرئيسي، الذي صار صديقي فيما بعد.
هو أول من تعلمت منه الكلمات التركية، وعلمني الأرقام، من الواحد إلى العشرة، أتذكره الآن، يرفع أصابعه ويفردها واحداً واحداً ويبدأ بالتهجئة: bir، iki، üç، dört، beş، altı، yedi، sekiz، doku، on، وكان لا يملُّ من تكرارها عليَّ كأنه يعلم طفلاً صغيراً الأشياء الأولى. كثيراً ما كنا نضحك على طريقتي في نطق الصوت باللغة التركية، كان لطيفاً ومرحاً، وكان كردياً من ديار بكر، من الجنوب التركي، جاء مع عائلته بحثاً عن الحياة في إسطنبول.
في مطعم شريف، الطعام بسيط لكنه لذيذ، الدجاج المشوي والرز كان أكلتنا المفضلة أنا ومهند، عندما نخرج من القناة ليلاً نمر على شريف، يستقبلنا من بعيد بالتلويح والفرح، ونجلس عنده قليلاً ثم نأخذ عشاءنا ونمضي إلى البيت.
ساعة تلفزيونية على طريقة حزب البعث
لم تمرَّ فترة طويلة حتى كرهت أكلتي المفضلة، الدجاج والرز، (أو بيلاف تاووق) كما تسمى باللغة التركية. وهذا الكره سببه مدير قناة الفلوجة، شاعر صدام حسين كما يحلو لو أن يُنادى أو يُعرَّف، لؤي حقي، البعثي الأكثر لزوجة من أي حيوان برمائي على وجه البسيطة.
في طريق عودتنا من استراحة الغذاء تأخرنا لسبب ما خمس دقائق. وعندما دخلنا إلى القناة، استقبلنا أحد الموظفين بأوراق A4 فارغة وأقلام، طالباً منا كتابة تقرير "مفصل" لتوضيح هذا التأخير. وكان هذا طلباً شخصياً من المدير، يريد أن "يقرأ" لماذا تأخرنا خمس دقائق. كنت أفهم ذلك لو إننا نعمل في مصنع، لكن أن يحدث هذا في قناة لا يوجد فيها شيء نفعله في حينها، فلم أفهمه سوى أنه تصرف بعثي.
كان لؤي حقي قد قرر أن وقت استراحة الغداء هي ساعة تلفزيونية، 45 دقيقة، حينها لم يكن هناك بث، ولا استوديوهات ولا كادر ولا معدات، ولا مكان مناسب يمكن أن تنطلق منه القناة للبث. لكنه كان بعثياً وعليه أن يدير المكان كما لو كان فرقةً حزبية. وهكذا أعاد إحياء عادة البعثيين السيئة، كتابة التقارير، كان الأمر حرفياً وعلانيةً. بعض الموظفين الذين اختارهم ليكونوا في دائرته المقربة أو حرسه الشخصي كانوا يحملون دفاتر صغيرة وأقلام ويتمشون بيننا، يكتبون ما يحدث في الغرف من أحاديث بين الموظفين.
"شعر" الخاكيين الجدد في العراق
11-02-2021
مرةً ذهبنا لنأكل ال"بيلاف تاووق" من عربة قرب محطة مترو يني بوسنا، في شارع بعيد نوعاً ما عن القناة. حينها كنا نأكل على حسابنا الشخصي، لذا كان علينا اختيار مكان رخيص، وكان صاحب العربة يقدم الطعام الجيد والرخيص، وهذه الاكلة مشهورة في تركيا، وهي من الأكلات الشعبية في الشوارع. وفي طريق عودتنا تأخرنا لسبب ما خمس دقائق، وعندما دخلنا إلى القناة، استقبلنا أحد الموظفين بأوراق A4 فارغة وأقلام، طالباً منا كتابة تقرير "مفصل" لتوضيح هذا التأخير، وكان هذا طلباً شخصياً من لؤي حقي، يريد أن "يقرأ" لماذا تأخرنا خمس دقائق. كنت أفهم ذلك لو إننا نعمل في مصنع، لكن أن يحدث هذا في قناة لا يوجد فيها شيء نفعله في حينها، فلم أفهمه سوى أنه تصرف بعثي.
بعد هذه الحادثة كرهت البيلاف تاووق، ولم آكله بعدها أبداً. وكلما مررت بعربة أو دكان يقدمها تذكرت لؤي حقي، لكن هذه المدينة فيها من الجمال ما ينسيني البشاعات. أقول لنفسي دائماً وأواصل المشي في شوارع إسطنبول.
"عندما غادرتُ البلاد.. كنتُ أضع الحرب في حقيبتي"... سلسلة نصوص تروي العراق اليوم بعيون شاب من مدينة الرمادي غرب البلاد، حين اضطر لمغادرتها مكرهاً.
نوفمبر.. موعد للرحيل أو الهرب
15-04-2021
بغداد.. مدينة القتلى والظلال الطويلة
22-04-2021
سأموت هنا.. في العراق
13-05-2021
الجنود يحرسون الحرب
04-06-2021
أبي يحب الله ويكره رجال الدين
10-06-2021
لا شيء يجلب الحب في بغداد
02-07-2021
لقد نجوت!
15-07-2021
يوم عمل أول مع شاعر صدام حسين
29-07-2021