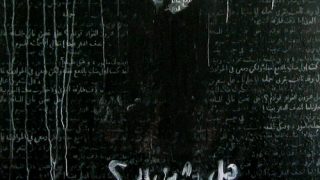ليس عاديا أن يتخطى مؤخرا معدل مشاهدة حلقة برنامج مصري عن الجن والعفاريت حد الثلاثة ملايين على الانترنت، ناهيك عن عدد مشاهدي التلفزيون، مع استثمار برامج إعلاميين آخرين هذا الشغف بالسير على المنوال نفسه، واستحضار دجالين وحالات للتحدث عن تجربتها مع مس الجان أو من يقرأون الطالع ويقدمون نبوءات للعام الجديد، وسط هجوم واسع من القراء على أستاذ طب نفسي شهير كأحمد عكاشة على أحد المواقع الإخبارية حين أنكر تأثير الجن على البشر، واعتبر أن للأمر سببا نفسيا فحسب.
فلهذه المعطيات دلالتها على ترسخ الخرافة في العقل الجمعي المصري، واتخاذها موقع القداسة، خاصة حين يتم الاستدلال بآيات من القرآن على وجودها، وأن من يقوم بالتعاطي مع هذه الأمور أو بالأحرى فك السحر أو إخراج أبناء العالم السفلي من جسد رجل أو امرأة، بعضهم ممن يحسبون على المشايخ أو القساوسة.
ويتم النظر إلى مثل هذه البرامج على أنها تأتي بتوجيه سلطوي لحرف الأنظار عن مشاكل قائمة وتقليل الاهتمام بالهم السياسي لدى الرأي العام، غير أن خطورتها الأكبر في أنها في الوقت ذاته تفعل فعلها في تكريس مفاهيم مغلوطة وتغييب العقل وتفسير الظواهر بالذهاب للغيبيات، وأن البديل للطب والصيدلة هم الدجالون، وذلك مقابل ضمان نسبة مشاهدة عالية تحقق إقبالا إعلانيا ومكاسب مالية ضخمة.
وفي الوقت الذي يتم الحديث عن خطط للنهوض المجتمعي وتجديد الخطاب الديني، نجد أنه لا يوجد توجه حقيقي لمحاربة الأمية التي تقارب نسبة 40 في المئة من عدد السكان، وأن معدل الإنفاق على البحث العلمي أقل بكثير من نسبة ما يُنفق على الدجل والشعوذة، وأن ثمة نصوصاً يتم تدريسها في الأزهر الذي يقدم نفسه كمنارة للعلم والوسطية ومحاربة التطرف، وفتاوى ودعاة هم جزء من ترويج ثقافة التخلف، ما يصب في الأخير في خانة تكريس عالم الخرافة.
وليس مستغرباً أن ترصد بعض التقديرات حجم ما ينفق على هذا العالم الخرافي بما يزيد عن 20 مليار جنية مصري سنويا، وأن تقدر دراسة منسوبة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عدد الدجالين في مصر بقرابة 350 ألفا، وأن 40 في المئة من النساء يقبلن على التعاطي مع أعمال الدجل في المدن أو القرى، ونسبة لا بأس بها كذلك من أصحاب التعليم العالي والمشاهير من فنانين ولاعبي كرة وغيرهم.
ويعكس هذا الإقبال الواسع في مصر من كل الطبقات والمستويات التعليمية، سواء على مشاهدة برامج الشعوذة أو اللجوء لدجال، أن التعليم في مصر قشرة خارجية، وأنه لا يعني التنوير والإيمان بالعلم وقيمته في الحياة، ما يعكس قوة تأثير الثقافة المتوارثة، فضلا عن التدين الشكلي والتأويلات الدينية والفتاوى الرجعية التي تماشي الخرافات كالعلاج بشرب بول الإبل وما إلى ذلك.
وهذا المناخ تفضله الأنظمة الاستبدادية وتشجعه باستمرار، كنوع من الإلهاء والتغييب، كما أن التجهيل والثقافة السطحية تضمن عدم النقد والمراقبة والمحاسبة للأنظمة، فضلا عن سهولة التأثير على الجماهير وتوجيهها بخطابات دعائية سلطوية.
من جهة أخرى، وكما يؤكد خبراء الطب النفسي في أكثر من مناسبة، فهناك زيادة في نسبة الاكتئاب في المجتمع، واليأس والإحباط وعدم الاستقرار والخوف والقلق من المستقبل، ما يجعل الناس تبحث عن حلول لمشاكلها عند الدجالين الذين يبيعون لهم الأوهام أو الأمل الكاذب، خاصة أن المريض النفسي أو من وصل لدرجة القنوط، يكون مهيئا للتوجيه والتأثير من شخص يظهر له أنه أقوى وصاحب معجزات، ويهرب من عيادة الطبيب النفسي التي يعني الذهاب إليها اجتماعيا وصمه بالجنون.
وفي الأخير، فإن مجتمعا يصدق السحر والشعوذة ويهتم بقراءة الطالع ومسايرة المنجمين، ويعيش بأفكار القرون الوسطى، لا يمكن بأي حال أن ينهض، ولن يكون ثمة مستقبل لبلد بدون توجه للارتقاء بالتعليم والثقافة وتكريس المنهج العلمي في التفكر والعقل النقدي عند كل الأعمار والمستويات التعليمية والاجتماعية ومنذ الطفولة، وأن يعي الإعلام وظيفته التنويرية، وإيجاد حلول علمية وواقعية للمشاكل القائمة، خاصة ما يتعلق بمحاربة البطالة والأمية والفقر والمرض، مع بث الأمل واحتواء أجواء اليأس والإحباط.