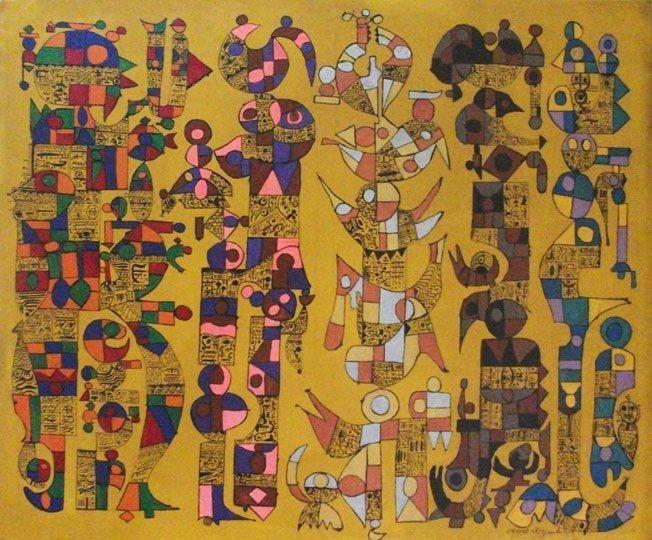لم يعد الطلاق في المغرب حدثاً فردياً يخصّ أسرة واحدة، بل صار علامة زمنية على تبدّل عميق في البنية الاجتماعية، وفي تمثّل الناس لمعنى العائلة نفسها. ولعل هذا ما توضحه الأرقام التي نشرتها وزارة العدل المغربية حديثاً لسنة 2024، التي رصدتْ أن أكثر من 400 حالة طلاق تُسجَّل يومياً، ولا تعني فقط ارتفاعاً كمياً في الانفصال، بل تشير إلى تغيّر في الوعي الجمعي، وإلى مسار بطيء يعيد تعريف "العيش معاً" كقيمة وكخيار، وأنها ليست مجرد زيادة في الملفات القضائية، بل انعكاس لتحوّلات اقتصادية وثقافية ونفسية، تمسّ أعماق المجتمع المغربي، الذي ظلّ طويلاً يُعرّف تماسكه من خلال صلابة الروابط الأسرية.
الطلاق، في صيغته الجديدة، ووفق المعطيات الرسمية نفسها، لا يحمل ملامح القطيعة الدرامية التي عرفتها الأجيال السابقة، إذ يتمّ في أغلب الحالات بالتراضي، بهدوء إداري بلا صخب ولا عار، وكأنّ المجتمع بدأ يطبِّع الانفصال كما طبَّع الزواج باعتباره إجراءً قانونيّاً، يندرج ضمن مسار حياة عادية. لكنّ هذا "الهدوء" الظاهري يخفي هشاشة رمزية عميقة، تكمن في صورة الأسرة كضمانة استقرار، وفي القيم التي كانت تُؤَطر فكرة "البيت" باعتباره فضاء للتضامن لا للاختبار. لم تعد النهاية وصمة، ولا الإخفاق عاراً، بل خياراً يُبرّره المنطق الاقتصادي، وضغط الواقع اليومي، وتراجع المساندة العائلية.
لكن خلف الأرقام الرسمية تُطلّ طبقات أعمق، فالفئة الأكثر تمثيلاً في ملفات الطلاق هي تلك التي تتراوح أعمارها بين 45 و49 سنة، أي جيلٌ عاش تحوّلات المغرب من الريف إلى المدينة، ومن الجماعة إلى الفرد، وهو الجيل الذي حمل على كتفيه مشروع التحديث العائلي والاقتصادي، ليكتشف في منتصف العمر أن هذا المشروع لم يعد قادراً على حمايته من الانهيار.
وراء كل هذا تبدو التوترات البنيوية حاضرة بوضوح، بما فيها هشاشة سوق العمل، وتضخّم تكاليف المعيشة، وتآكل الطبقة الوسطى، وغياب السياسات العمومية التي تؤمّن الحد الأدنى من الرفاه. ومع تقلّص شبكات الدعم العائلية، واندثار "البيت الكبير"، لم يعد الزواج مؤسسة محمية بجماعةٍ ممتدة، بل صار عقداً هشّاً بين فردين يواجهان اقتصاداً قاسياً ومدناً متسارعة. من هنا يصبح الطلاق ليس تمرداً على القيم، بل ردّ فعل على العزلة الحديثة.
الحب في مرآة الأنثروبولوجيا
16-02-2023
ويُضاف إلى هذا التحوّل صعود الحضور الرقمي كقوة خفية، تعيد صياغة التصورات عن السعادة والحب والنجاح. فالمنصّات لا تكتفي بمقارنة العلاقات، بل تُنتج نموذجاً جديداً للحميمية، بما فيها عواطف مؤقتة، رغبات معلّقة، وصور مثالية تُغذّي الشعور بالنقص، ومعها يتآكل الصبر والقدرة على "العيش في العادي"، وتغدو الرغبة في البدء من جديد أكثر إغراءً من محاولة الإصلاح.
لذلك، يقرأ الطلاق كجزء من حركة أعمق يعيشها المجتمع المغربي والعربي معاً، وهي حركة انتقال من زمن "الواجب" إلى زمن "الاختيار"، ومن الأسرة كقدرٍ اجتماعي إلى الأسرة كعقدٍ تفاوضي هشّ. وفي هذه الحركة الطويلة، يُعاد تعريف مفاهيم كبرى كالمسؤولية، والاستقرار، والحبّ، والتضحية.
منح إصلاح مدونة الاسرة في 2004، المرأة حقّ طلب الطلاق، ووسّع رقعة المشاركة في القرار العائلي، غير أن هذه الحرية القانونية لم تجد دائماً ما يساندها على الأرض. أي أن هشاشة العمل، وتفاوت الدخل، وندرة السكن، جعلت الاستقلال المادي شرطاً صعب المنال، وبدونه تبقى المساواة نصاً أكثر منها واقعاً.
كشف مرور عقدين مذّاك، عن أن النصوص يمكن أن تتغيّر بسرعة، بينما الذهنيات والبنى الاجتماعية والاقتصادية تتحرك ببطء شديد. وهكذا، ظلّ التطبيق أسيرَ منطقة رمادية، يتقاطع فيها ما هو قانوني مع هو ثقافي واقتصادي. فالقانون تَقدّم خطوة، لكن المجتمع لم يسايره في الخطوة التالية.
والمغرب، شأنه شأن بلدان عربية أخرى تشهد الارتفاع نفسه في نسب الطلاق، يقف اليوم أمام سؤال وجودي صامت: كيف يمكن لمجتمعٍ أن يحافظ على تماسكه الرمزي، فيما تتفكك داخله أصغر وحداته وأكثرها حميمية؟ وهل يمكن للأسرة أن تظلّ مرجعاً في زمن الفردانية، أو أنّنا ننتقل إلى أشكال جديدة من العيش المشترك لم نمنحها بعد اسماً؟ وربما لا تملك الأرقام الإجابة، لكنها تقول شيئاً واحداً بوضوح: إنّ الاستقرار لم يعد يعني البقاء، بل القدرة على الفُرقة من دون انهيار. وهنا يبدأ المعنى الحقيقي لهذا التحوّل، الذي يطبع المغرب المعاصر في صمته الاجتماعي البليغ.
بين القانون والواقع.. الطلاق كمؤشر
منذ دخول مدوّنة الأسرة حيّز التنفيذ سنة 2004، والمغرب يعيش تجربة قانونية غير مسبوقة في العالم العربي، إذ حاول الإصلاح الذي أطلقه الملك محمد السادس آنذاك، أن يزاوج بين المرجعية الإسلامية وروح العصر الحقوقي، وكان الهدف المعلن هو تحقيق المساواة في الأدوار الأسرية، وفتح الباب أمام المرأة لتملك حقها في القرار، سواء في الزواج أو في إنهائه.
لكن مرور عقدين تقريباً، كشف عن أن النصوص يمكن أن تتغيّر بسرعة، بينما الذهنيات والبنى الاجتماعية والاقتصادية تتحرك ببطء شديد. وهكذا، ظلّ التطبيق أسيرَ منطقة رمادية، يتقاطع فيها ما هو قانوني مع هو ثقافي واقتصادي. فالقانون تَقدّم خطوة، لكن المجتمع لم يسايره في الخطوة التالية.
المغربيات.. يحميهنّ القانون ويظلمهنّ الواقع
02-01-2022
لقد منح هذا الإصلاح المرأة حقّ طلب الطلاق، ووسّع رقعة المشاركة في القرار العائلي، غير أن هذه الحرية القانونية لم تجد دائماً ما يساندها على الأرض. أي أن هشاشة الشغل، وتفاوت الدخل، وندرة السكن، جعلت الاستقلال المادي شرطاً صعب المنال، وبدونه تبقى المساواة نصاً أكثر منها واقعاً. وبذلك تحوّل الطلاق، في كثير من الحالات من مأزق شخصي إلى أداة للدفاع عن الكرامة في ظلّ غياب العدالة الاجتماعية، ومن مسألة أخلاقية إلى مؤشّر بنيوي، يعكس ما يصيب المجتمع من تعبٍ عميق في قدرته على التوازن.
لم يعُد الزواج كما كان في العقود السابقة، شبكة حماية من الفقر، بل صار في حالات كثيرة عبئاً جديداً داخل اقتصاد متقشّف. العبارات التي تتكرر في محاضر المحاكم هي: "عدم التفاهم"، "استحالة العشرة"، "غياب الانسجام". والمحاكم تُسجّل هذه الكلمات في سجلاتها اليومية، لكنها في الواقع تُدَوّن سردية أكبر، حول كيف يختبر المغاربة اليوم معنى العائلة، وحدود الصبر، وإمكانية الحبّ وسط دوامة اقتصادية خانقة.
الطلاق بهذا المعنى يصبح ترجمة اجتماعية لانسدادٍ اقتصادي ونفسي، يطال شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما في المدن الكبرى، حيث تتكثف الضغوط وتتقلّص المساحات الخاصة. ولعلّ المفارقة الأشدّ دلالة هي أنّ الدولة التي أرادت من مدوّنة الأسرة عام 2004 أن تُعلن عن تحديث اجتماعي من داخل المرجعية الدينية، تجد نفسها اليوم أمام جولة ثانية من الإصلاح لم تكتمل بعد.
ففي نهاية 2024، دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة شاملة لمدوّنة الأسرة، بعد أن توصّل تقرير اللجنة الملكية إلى أكثر من مئة مقترح تعديل، بعضها يمسّ جوهر التوازن بين المرجعية الشرعية والحقوق المدنية.
الملك دعا الحكومة إلى فتح نقاشٍ وطني موسّع، وأحال المسائل ذات البعد الفقهي إلى المجلس العلمي الأعلى. لكن، وإلى حدود اليوم، لم يتحوّل التقرير إلى مشروع قانونٍ فعلي، ولم تُحَدَّد له آجالٌ تشريعية واضحة. وهذا التأخر لا يُقرأ فقط كتعثّر إداري، بل كاشفٍ لثقل الموضوع في ميزان الهوية المغربية. فمراجعة مدوّنة الأسرة ليست مجرّد تحديثٍ قانوني، بل مفصلٌ ثقافيّ يعيد ترتيب العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع.
يُقرأ الطلاق كجزء من حركة أعمق يعيشها المجتمع المغربي والعربي معاً، وهي حركة انتقال من زمن "الواجب" إلى زمن "الاختيار"، ومن الأسرة كقدرٍ اجتماعي إلى الأسرة كعقدٍ تفاوضي هشّ. وفي هذه الحركة الطويلة، يُعاد تعريف مفاهيم كبرى كالمسؤولية، والاستقرار، والحبّ، والتضحية.
أصبح الطلاق ترجمة اجتماعية لانسدادٍ اقتصادي ونفسي، يطال شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما في المدن الكبرى، حيث تتكثف الضغوط وتتقلّص المساحات الخاصة. ولعلّ المفارقة الأشدّ دلالة هي أنّ الدولة التي أرادت من مدوّنة الأسرة عام 2004 أن تُعلن عن تحديث اجتماعي من داخل المرجعية الدينية، تجد نفسها اليوم أمام جولة ثانية من الإصلاح لم تكتمل بعد.
التأني هنا ليس خوفاً من الإصلاح، بل خشية من أن يُولَد النصّ في فراغ اجتماعي، أو أن يُصاغ بعيداً عن الأرض التي يُفترض أن يُطبَّق عليها. والإصلاح القانوني يحتاج إلى بنية قادرة على احتضانه، وهنا الحديث عن قضاة مكوَّنين، آليات وساطة فعّالة، فيما غياب هذه العناصر يجعل كل تعديلٍ محتمل عُرضةً للتأجيل، تماماً كما حدث في دول عربية أخرى، حين اصطدم التغيير التشريعي بحدود الممكن الاجتماعي.
تعديلات ملحة أمام مدونة الأسرة في المغرب
15-02-2024
غير أن هذا البطء في تنزيل الإصلاح، وسط موجة طلاقٍ تتسع يومياً، يطرح سؤالاً سياسياً واجتماعياً حاداً: هل يمكن لمجتمع أن ينتظر اكتمال النصّ بينما تتفكك داخله مئات الأسر كل يوم؟ وهل الإصلاح القانوني قادرٌ وحده على احتواء ظاهرة تتجاوز حدود القضاء إلى عمق الاقتصاد والمخيال الاجتماعي؟ وما يحدث في محاكم المغرب ليس فقط إحصاء للانفصالات، بل توثيق صامت لمرحلة يعاد فيها تعريف التوازن بين النصّ والواقع، بين الدولة والعائلة، بين الحقّ والقدرة على ممارسته.
الطلاق بالتراضي
في السنوات الأخيرة، صار الطلاق بالتراضي هو القاعدة الجديدة للعلاقات المنتهية في المغرب. فمن بين أكثر من أربعين ألف حالة طلاق سُجلت سنة 2024، تشير معطيات وزارة العدل إلى أن حوالي تسعة من كل عشرة أزواج اختاروا إنهاء زواجهم بطريقة ودّية.
تقول الباحثة في علم الاجتماع، فاطمة الزهراء المرابط، المتخصصة في قضايا الأسرة والهجرة، إن "الطلاق بالتراضي لا يعني بالضرورة أن الأزواج يعيشون نهاية سلمية، بل أنهم يبحثون عن الخروج بأقل الخسائر الرمزية".
في المقابل، يرى أستاذ القانون الأسري بجامعة محمد الخامس، عبد الكبير الحياني، أن هذا الانتشار الكبير للطلاق بالتراضي "لم يأتِ فقط من تيسير المساطر القضائية، بل من تبدّل مفهوم الصبر والزواج نفسه"، ذلك أن "الأجيال الجديدة لا ترى في الزواج التزاماً غير قابل للرجوع بل تجربة يمكن إعادة صياغتها، وهذا لا يقلّل من قِيمة الزواج بقدر ما يُعيد تعريفه في زمنٍ تتقدّم فيه الفردانية على الطاعة الجماعية".
بين هذين الرأيين تتقاطع ملاحظةٌ أعمق، أن ما يُسمّى بـ"الطلاق الهادئ" هو في الواقع نهاية هادئة لعقد اجتماعي صاخب. لقد تغيّر ميزان القوى داخل الأسرة، وصار الحوار حول الانفصال جزءاً من الحياة اليومية في المدن الكبرى، لا فعلاً طارئاً.
في المقاهي، وفي عيادات الطب النفسي، وعلى صفحات تطبيق "إنستغرام"، يُستعاد الحديث عن "الحق في السعادة" أكثر من "واجب الصبر"، وهكذا يتغيّر معنى التضحية من فضيلة اجتماعية إلى عبءٍ شخصيّ، لا أحد يريد حمله بعد اليوم.
ويقول الباحث سعيد بن مسعود، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل: "يعيش المغرب ما يمكن تسميته بالحداثة الصامتة للأسرة. فنحن أمام أزواج يتبنّون سلوكيات جديدة دون أن يُعلنوا عن ثورتهم، والطلاق بالتراضي ليس سوى تعبير قانوني عن حداثةٍ اجتماعية لم يُصغها أحد بعد في خطابٍ واضح".
إن ما يصفه بن مسعود يتجلى بوضوح في المدن الكبرى، التي تمثل مختبراً لتغيّر القيم، فالزواج فيها صار خياراً فردياً أكثر منه واجباً اجتماعياً، ومجالاً للتجريب أكثر منه للتوريث، والأسر الممتدة تتراجع، والروابط العائلية التي كانت تؤطر القرار تختفي، لتحلّ محلها شبكات رقمية من الصديقات أو الزملاء، تُشكّل "المرجع الجديد" في اتخاذ القرار. وهكذا لم تعد الأم أو العمة هي من تنصح، بل المؤثرة على "إنستغرام"، ولا يُستشار الفقيه، بل خبير العلاقات على "تيك توك". إنها صورة مكثفة لما يسميه الباحثون "تحوّل المرجعية من النصوص إلى التجارب، ومن الجماعة إلى الذات".
هذا الانزياح ينعكس حتى في لغة القضاء. فالمحاكم التي كانت تشهد في الماضي مواجهات محتدمة، صارت اليوم تَعرف جلسات قصيرة، صامتة، تُوقّع فيها وثائق الطلاق كأية معاملة إدارية، والمحامون أنفسهم يتحدثون عن "هدوءٍ غريب"، يلفّ قضايا الأسرة في السنوات الأخيرة، وكأنّ المجتمع اختار التطبيع مع الانفصال كجزء من دورة الحياة.
وفي هذه التفاصيل الصغيرة، أي: الهدوء في القاعات، وغياب الانفعالات، وتبادل نظراتٍ متعبة... تتجسّد ملامح التحوّل الاجتماعي الأعمق: الأسرة المغربية لم تنهَر، لكنها تغيّر جلدها من دون ضجيج.
ومع هذا التحوّل، بدأت مفاهيم جديدة تتسلّل إلى اللغة اليومية، "زواج مؤقت"، "علاقة ناضجة"، "انفصال راقٍ"، وهي كلها مؤشرات على تفكيك المعجم القديم، الذي كان يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة.
حتى في الإعلام، لم يعد الحديث عن الطلاق محاطاً بالحرج نفسه، بل يُناقَش كظاهرة اقتصادية وسوسيولوجية، وقد صرّح أحد القضاة في محكمة الأسرة بالدار البيضاء للسفير العربي قائلاً: "أغلب من نراهم في الجلسات ليسوا خصوماً بل شركاء سابقون أنهكتهم الحياة المشتركة حين يتحدثون إلينا، لا يتجادلون حول من أخطأ، بل حول من سيتحمّل مسؤولية الأطفال والمصاريف، إنه طلاق الإدراك لا طلاق الغضب".
____________
من دفاتر السفير العربي
رصدٌ لسيرورات معارك النساء الكبرى
____________
وهنا تتقاطع التجربة المغربية مع ما يجري في المجتمعات العربية الأخرى، التي تشهد ارتفاعاً مماثلاً في نسب الانفصال، بما فيها تونس، مصر، الأردن، وحتى بعض دول الخليج. ومع ذلك، تبقى للمغرب خصوصيته، فالمجتمع الذي كان يفاخر بانخفاض نسب الطلاق في العقود الماضية، صار اليوم يعيش مفارقة صامتة، فكلّما ازداد الوعي بالحقوق، ازدادت هشاشة الروابط، وكلّما اتسعت مساحات الحرية الفردية، ضاقت مساحة التعايش داخل البيت الواحد. وفي هذه المسافة الرمادية، بين ما هو مقبول وما هو حاصل، تولد التحوّلات الكبرى عادة، بصمت لا يلتقطه أحد في لحظته. وهكذا يتبدّى الطلاق، لا كخلل في المنظومة الأخلاقية، بل كإحدى أدواتها الجديدة، أي وسيلة لإعادة توزيع التوازنات، وتصحيح المسافات، بين الرغبة والواجب، بين الممكن والمفروض.
في نهاية 2024، دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة شاملة لمدوّنة الأسرة، بعد أن توصّل تقرير اللجنة الملكية إلى أكثر من مئة مقترح تعديل، بعضها يمسّ جوهر التوازن بين المرجعية الشرعية والحقوق المدنية.
كانت المحاكم تشهد في الماضي مواجهات محتدمة، بينما صارت اليوم تَعرف جلسات قصيرة، صامتة، تُوقّع فيها وثائق الطلاق كأية معاملة إدارية، والمحامون أنفسهم يتحدثون عن "هدوءٍ غريب"، يلفّ قضايا الأسرة في السنوات الأخيرة، وكأنّ المجتمع اختار التطبيع مع الانفصال كجزء من دورة الحياة.
في النهاية، لا يعبّر ارتفاع نسب الطلاق عن انحلال أخلاقي كما يُحبّ البعض أن يراه، ولا عن انتصارٍ فردي كما يتصوّره آخرون، بل عن إعادة تفاوض داخل المجتمع حول معنى الكرامة والحبّ والعيش المشترك. وهي مفاوضة طويلة، لا تجري في قاعات المحاكم فقط، بل داخل البيوت، وفي لغة الأبناء، وفي النقاشات الصغيرة التي تملأ المقاهي والمكاتب والهواتف. وحين تُكتب هذه التحوّلات في كتب علم الاجتماع مستقبلاً، لن تُقرأ بوصفها أزمة في الزواج، بل بوصفها لحظة من لحظات تحرّر المجتمع من صوره القديمة عن نفسه.
إنّ المغرب، وهو يتأرجح بين المدوّنة القديمة وتلك المرجوة التي لم يتم تنزيلها بعد، يعيش اليوم لحظة مراجعة جماعية غير معلَنة، تتجاوز النصوص إلى الذهنيات. وحتى لو تأخر الإصلاح القانوني، فإنّ الإصلاح الرمزي قد بدأ فعلاً في الوعي اليومي للناس في نظرتهم إلى الأسرة، وفي مطالبتهم بالاعتراف بحيواتهم الخاصة، وفي قدرتهم على القول إنّ "الاختيار" قد يكون أكثر صدقاً من "الاستمرار". وبهذا المعنى، لا يُختزل الطلاق في رقم أو محضر قضائي، بل هو سرديّة مجتمع بأكمله، وهو يعيد التفاوض مع نفسه.
مجتمعٍ يتعلّم ببطء أن الكرامة قد تكون شكلاً آخر من أشكال الحبّ، وأنّ نهاية العلاقة ليست نهاية العاطفة، بل بداية زمن جديد من الصراحة الاجتماعية، زمن يُعاد فيه تعريف المودّة، لا بوصفها دوامة بل كقدرة على الرحيل بسلام.