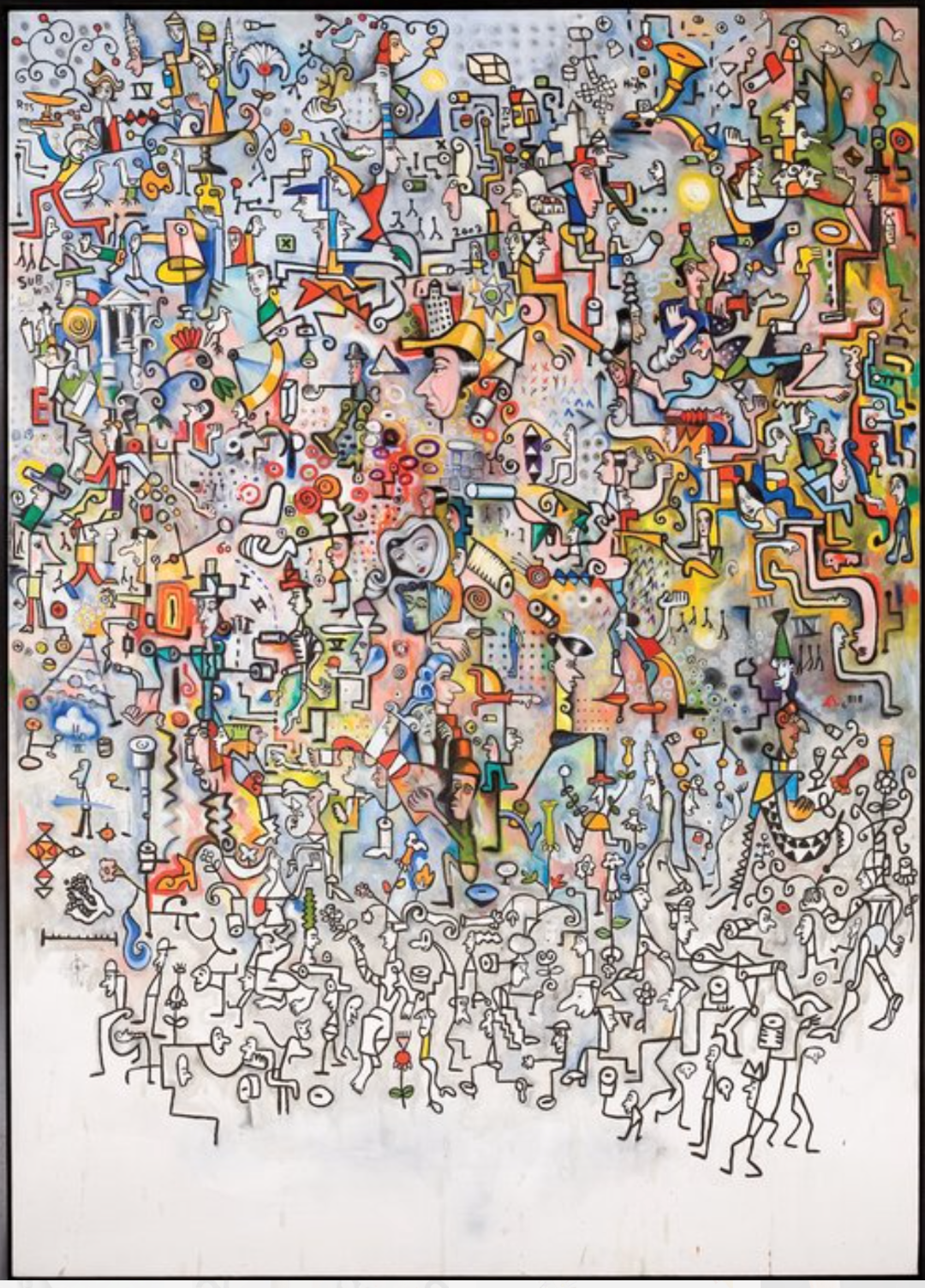هل هناك حملات مجتمعية تحض على العنف والكراهية ضد النساء في مصر؟ هل هي منظّمة؟ سؤال يتبادر إلى الذهن عند متابعة منشورات منصات التواصل الاجتماعي بتمعن، تلك التي تحمل في باطنها تحريضاً ضد النساء، وتراجعاً لتقدير دورهن في المجتمع، بدءًا من لوم الناجيات في قضايا العنف والتحرش، وحتى ضحايا القتل، خاصة لو كان الجاني من أفراد عائلتها، وكانت الضحية من الفقراء، هذا غير النقد الحاد لمنشورات رفض الختان وتعدد الزوجات والعنف الأسري، والمنشورات الساخرة التي تلصق بالمرأة العاملة سوء السلوك، وبالمطلقة الانفلات الأخلاقي، وترفض ذهاب النساء إلى عيادات الأطباء الرجال... فما الذي جلب ذلك كله؟
في دراسة[1] صدرت عام 2020 حول العنف الإلكتروني ضد النساء، شملت آراء عينة من 400 امرأة مصرية، عبر استبيان إلكتروني، خلصت إلى أن 41.6 في المئة من المشاركات تعرضن لعنف رقمي خلال عام 2019، أي نصف العينة، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر الوسائل التي تعرّضت من خلالها النساء للعنف الرقمي، بنسبة 72.8 في المئة من الحالات. أما مرتكبو العنف فكانوا مجهولين من الضحايا بنسبة 92 في المئة.
ففي عصر تُكبّل فيه حرية الصحافة والتعبير والحراك السياسي بكافة أشكاله، وتزداد فيه الإحباطات من التضخم وارتفاع الأسعار، صار النقد اللاذع الموجه إلى النساء هو الأمر الأكثر رواجاً، والمتاح لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع غياب قوانين رادعة، وخطاب نسوي قوي، وشخصيات فاعلة مؤثرة، تستطيع إعادة التوازن، وتقديم نماذج إيجابية عن دور المرأة، حتى لو كانت كليشيهات كما كان يحدث في عصر مبارك، تحت وصاية زوجته السيدة سوزان، التي حاولت خلق دور اجتماعي في الدفاع عن القضايا الخاصة بالنساء، فظهرت قوانين إيجابية، كان أهمها قانون "الخلع"[2] عام 2000، الذي أتاح للمرأة الحق في تطليق نفسها من خلال إجراءات مُيَسرّة، بدلاً من استغراق سنوات في المحاكم في قضايا الطلاق، وهو بالمناسبة القانون نفسه الذي يواجه انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي باعتباره مخالفاً للشرع، في موجة من الآراء الدينية العشوائية، التي لا يستطيع أحد منعها أو السيطرة عليها.
ماذا حدث للمصريين؟
حلّل كتاب[3] صدر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، للدكتور جلال أمين، التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين. استعرض الكتاب بشكل سريع ما تمتعت به المرأة من إقبال على التعليم وتحصيل الدرجات العلمية في التسعينيات، والالتحاق بسوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي، مع استمرار المحافظة على دورها كأم وراعية للبيت، واستمرار الزوج في التحكم في مقاليد الأمر، فالمجتمع لم يغيِّر نظرته التقليدية إلى المرأة!
وكانت سنوات عهد مبارك قد شهدت بروز شخصيات نسائية، في الوزارات والإعلام وعلى مقاعد البرلمان، وكانت تابعة للحزب الحاكم، وتميزت بمستوى تعليمي جيد، وتبنت إجمالاً قضايا المرأة. كما ظهرت أصوات معارِضة في مجال الصحافة والإعلام والكتابة والعمل النقابي والحقوقي أيضاً، على رأسها نوال السعداوي التي، على الرغم مما أثارته آراؤها من انتقادات، إلا أنه كان لها دور بارز في مواجهة الأفكار المغلوطة حول ختان الإناث في مصر، وتصدت بمعرفتها العلمية كطبيبة، لأسماء بارزة من رجال الدين خلال التسعينيات من القرن الماضي، ما أدى في النهاية إلى تجريم الختان، بداية من صدور القرار رقم (261) لسنة 1996، من وزير الصحة، بمنع الأطباء والممرضين من إجراء الختان في المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة، ثم بصدور قانون يجرم ختان الإناث عام 2008، وأُدرجت مادة في قانون العقوبات المصري (المادة رقم 242 مكرر). وفي عام 2016 تمّ تشديد العقوبة.
جاء قرار منع الختان على الرغم من مواقف التيارات الإسلامية المتشددة، التي كانت لها سطوتها خلال تلك الفترة، فأسهم في نجاة آلاف من الفتيات، من الطبقة المتوسطة على الأقل، من ذلك الفعل العنيف، الذى يهدف في الأساس إلى كسر روح النساء، وإخضاعهن لسلطة ذكورية، حتى يبقين في حالة خضوع، مهما حصدن من نجاح على المستوى العلمي والمادي.
بعد نوال السعداوي، التي تصدت بفعالية لختان الفتيات، ما أدى في النهاية إلى تجريمه، برز جيل من النسويات الحقوقيات، وظهرت مبادرات تمكين اقتصادي وحقوقي، مثل خريطة التحرش الإلكتروني، التي كانت تتلقى بلاغات الناجيات من التحرش، وتمثِّلها على خريطة جغرافية، منذ تأسيسها عام 2010 إلى عام 2020، حين توقفت لأسباب تمويلية وتنظيمية، إضافة إلى الضغوط القانونية والاجتماعية التي واجهت فريق العمل.
"صوت المرأة ثورة وليس عورة"، شعار رفعته المشارِكات في أكبر مظاهرة نسائية مصرية حاشدة خلال القرن الحالي، خرجت في شهر آذار/ مارس من عام الثورة 2011، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. بعدها نشطت دعوات احتجاجية نسوية، إثر تعرض النساء للتحرش في ميدان التحرير بغرض إسكاتهن، وتوقيع كشوف العذرية على ناشطات بعد القبض عليهن.
ثم بعد نوال السعداوي، ظهر جيل من النسويات الحقوقيات، اللاتي نجحن في إلقاء الضوء على قضايا المرأة المهمَّشة، مثل منال الطيبي، وعزة كمال، فظهرت مبادرات تمكين اقتصادي وحقوقي بالتزامن مع صعود المجتمع المدني، مثل خريطة التحرش الإلكتروني، التي كانت تتلقى بلاغات الناجيات من التحرش، وتمثِّلها على خريطة جغرافية، منذ تأسيسها عام 2010 إلى عام 2020، حين توقفت لأسباب تمويلية وتنظيمية، إضافة إلى الضغوط القانونية والاجتماعية التي واجهت فريق العمل.
"صوت المرأة ثورة ليس عورة"، شعار رفعته المشارِكات في أكبر مظاهرة نسائية مصرية حاشدة خلال القرن الحالي، خرجت في شهر آذار/ مارس من عام الثورة 2011، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك للمطالبة بالمساواة، والتمثيل المناسب للمرأة في جميع المجالات. بعدها نشطت دعوات احتجاجية نسوية، إثر تعرض النساء للتحرش في ميدان التحرير بغرض إسكاتهن، وتوقيع كشوف العذرية على ناشطات بعد القبض عليهن. وعلى الرغم من قسوة تلك الحوادث، إلا أنها زادت النساء قوة للمشاركة في الحراك الثوري، وبدأ الحديث عن ابتكار وسائل وتدابير للدفاع عن النفس والحماية.
لكن كافة تلك الجهود تراجعت مع تراجع كافة أشكال حرية الرأي والتعبير، وتضييق الخناق على العمل العام، على الرغم من زوال خطر الحكم الديني على مصر بسقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين. إلا أن ذلك لم يفتح المجال للحراك النسوي، وتراجعت المبادرات والتيارات التنويرية عموماً، ومعها تراجع دور الهيئات الحكومية المعنية بشؤون المرأة. وتجلى ذلك في قضية القبض على شاهدات في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت عام 2020، على الرغم من تعهد المجلس القومي للمرأة[4] حينها بتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي لهن، وهو ما أثار انتقادات واسعة لجدية مؤسسات الدولة في حماية الناجيات والمبلِّغات عن العنف الجنسي.
"قيم الأسرة المصرية"
تمّ تفعيل المادة رقم (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018، والمعروفة بتهمة "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية" في عام 2020، لتبرير سلسلة من الملاحقات القضائية بحق عدد من الفتيات الناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهن حنين حسام ومودة الأدهم.
هاتان الفتاتان، اللتان اشتهرتا بمقاطع راقصة وغنائية على تطبيق "تيك توك"، تمثلان نموذجاً لجيل من الفتيات ينجذبن إلى عالم الشهرة والربح السريع عبر المنصات الرقمية، مع عدم وجود بدائل. وعلى الرغم من صغر سنهما ومحاولاتهما استعطاف القضاء، إلا أنه لم يراعَ ذلك في الأحكام الصادرة ضدهما.
تربتْ كثير من النساء في مصر على كتمان أسرار البيت، حتى لو تضمنت عنفاً أو إساءة من الشريك، فالموروث الاجتماعي يطالب الزوجة بالصبر، وانتظار أن يُصلح الله حال زوجها، مما يدفع كثيرات إلى الاستمرار في علاقات سامة، يتعرضن فيها للعنف من دون شكوى، حتى ينتهي الأمر أحياناً بالقتل، وهو ما يحدث بشكل متكرر.
تكرر الأمر مع العديد من الفتيات اللاتي استخدمن الرقص أو الأداء التعبيري كوسيلة للانتشار السريع، إذ صار الرقص الرقمي سبباً كافياً للاعتقال والمساءلة، على الرغم من أنه ليس مجرماً في الثقافة المصرية. فالرقص النسائي دائم الحضور في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الشعبية في المدن والقرى المحافِظة، ولا يخلو منه حتى المشهد السياسي، إذ كثيراً ما بثت مقاطع لنساء يرقصن خلال الانتخابات، من دون أن يتعرضن لأية مساءلة، ما دُمْنَ يعبرن عن دعمهن للنظام.
وعلى الرغم من تعدد القبض على فتيات الإنترنت، جاءت قضية "سوزي الأردنية" — واسمها الحقيقي مريم أيمن (18 عاماً) — لتشكَل حالة خاصة. فهي صانعة محتوى فقيرة، بدأت صفحتها من منزل متواضع، عبر مقاطع مرحة وعفوية لا تخلو من روح الدعابة، وأحياناً الألفاظ الجارحة. ومع ازدياد شهرتها وتحوّلها إلى الإعلانات المدفوعة، تغيّر نمط محتواها وهيئتها، ليبدأ سيل من الكراهية الإلكترونية ضدها. ردت الفتاة في عفوية بعبارت غاضبة، تنم عن الخبرة المحدودة والفقر المعرفي، لتجد نفسها في مواجهة اتهامات بنشر "محتوى خادش للحياء"، و"التربح غير المشروع"، و"غسل الأموال"، على الرغم من إنكارها لهذه التهم، وتأكيدها أن محتواها ترفيهي ودعائي.
سوزي لم تكن مناضلة نسوية، لكنها تعبِّر عن وجه جديد من نساء الهامش الرقمي، اللواتي سعين إلى تحسين أوضاعهن المعيشية عبر أدوات التكنولوجيا، فوجدن أنفسهن في مواجهة قانون يجرِّم صعودهن الاجتماعي، من دون تقديم مقابل من التكافل والدعم المجتمعي.
لوم الضحية
في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أربعة شباب يستقلون سيارات ملاكي، يطاردون سيارة تقل فتيات بقصد المعاكسة وإجبارهن على التوقف، قبل أن تصطدم سيارة الفتيات بسيارة نقل كانت على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابتهن بجروح وكدمات.
وبعد القبض على المتهمين، صدر حكم بالسجن أربع سنوات مع النفاذ في محكمة أول درجة، وغرامة مالية كبيرة على كل منهم، إلى جانب تعويض مدني للضحايا. وبمجرد صدور الحكم، اندلعت حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، غير منظمة غالباً، ألقت اللوم على الفتيات، ووصمتْهنّ بـ"الانفلات"، محمِّلة إياهن مسؤولية ما جرى، بسبب خروجهن في وقت متأخر وملابسهن، بل وجلوسهن في مقهى مختلط!
تمّ تفعيل المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018، التي اشتهرت بتهمة "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية" في عام 2020، لتبرير سلسلة من الملاحقات القضائية، بحق عدد من الفتيات الصغيرات الناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي، قمعاً لبرامج كُنَّ يقدمنها على تطبيق "تيك توك"... وقد تعرضن للسجن.
جاءت قضية "سوزي الأردنية"، واسمها الحقيقي مريم أيمن (18 عاماً)، لتشكَل حالة خاصة. فهي صانعة محتوى فقيرة، بدأت صفحتها من منزل متواضع، عبر مقاطع مرحة وعفوية لا تخلو من روح الدعابة، وأحياناً الألفاظ الجارحة. ومع ازدياد شهرتها وتحوّلها إلى الإعلانات المدفوعة، تغيّر نمط محتواها وهيئتها، ليبدأ سيل من الكراهية الإلكترونية ضدها.
والبشع أن بعض النساء شاركن في هذه الحملة، بما يقوض الجهود التي بُذِلت خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الناجيات من التحرش على اللجوء إلى القضاء واتباع المسار القانوني. وانعكس هذا الهجوم على سير القضية! ففي مرحلة الاستئناف، قدم كلٌّ من دفاع المتهمين والمجني عليهن تصالحاً، وتراجعاً للناجيات عن أقوالهن!
ظاهرة لوم الضحية أو الناجية، تتكرر باستمرار في قضايا العنف والتحرش ضد النساء، حتى في أشد الحالات مأساوية. فقصة نيرة أشرف مثال واضح: طالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تبلغ من العمر 21 عاماً، تعرضت في حزيران/ يونيو 2022 للذبح على يد زميلها محمد عادل، بعد أن رفضت الارتباط به. وُثِّق الحادث المروع بعدسات الموبايل، والمرعب أنه وقع أمام بوابة جامعة المنصورة.
"نكدية".. الحيلة المخيفة لتكميم أفواه النساء
16-12-2021
كشفت التحقيقات أن عادل خطط للجريمة مسبقاً، فأُحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وصدر بحقه حكم بالإعدام شنقاً، ونُفِّذ الحكم في حزيران/ يونيو 2023. وعلى الرغم من فداحة الجريمة، وتوثيقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، شن البعض حملات على تلك المواقع لإدانة نيِّرة، متهمين سلوكها وملابسها بأنها "استفزت" القاتل، ومطالبين بتخفيف العقوبة عنه مراعاة "لظروفه النفسية". بعد ذلك تكررت الحوادث، وظهرت شهادات لفتيات أخريات، تحدثن عن محاولات ابتزاز وتهديد، لكن ذلك لم يوقف موجة لوم الضحية المستمرة.
العنف الأسري
تربتْ كثير من النساء في مصر على كتمان أسرار البيت، حتى لو تضمنت عنفاً أو إساءة من الشريك، فالموروث الاجتماعي يطالب الزوجة بالصبر، وانتظار أن يُصلح الله حال زوجها، مما يدفع كثيرات إلى الاستمرار في علاقات سامة، يتعرضن فيها للعنف من دون شكوى، حتى ينتهي الأمر أحياناً بالقتل. يدعم هذا الصمت خطاب ديني واجتماعي محافِظ، إذ لا تزال بعض الرموز الدينية تبرر العنف ضد الزوجة، على الرغم من تبني مؤسسة الأزهر نفسها في السنوات الأخيرة خطاباً يبدو أكثر اعتدالاً. غير أن الآية القرآنية "واضربوهن" من سورة النساء، لا تزال تُستخدم لتبرير "حق الزوج في تأديب زوجته"، مع محاولات للتخفيف من الفعل العنيف، بوصفه "ضرباً غير مبرِح، أي لا يكسر عظماً ولا يترك أثراً، ويأتي كحل أخير"!
جرت مطاردة فتيات من قبل شبان متحرشين، فاصطدمت سيارة الفتيات بشاحنة، ما أدى إلى إصابتهن بجروح وكدمات. صدر حكم بالسجن أربع سنوات مع النفاذ على المتحرشين، وغرامة مالية كبيرة، وتعويض مدني للضحايا. فاندلعت حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت فيها بعض النساء، ألقت اللوم على الفتيات ووصمتهنّ بـ"الانفلات"، محمِّلة إياهن مسؤولية ما جرى، لخروجهن في وقت متأخر، بل وجلوسهن في مقهى مختلط!
بعض النساء شاركن في هذه الحملة، بما يقوض الجهود التي بُذِلت خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الناجيات من التحرش على اللجوء إلى القضاء واتباع المسار القانوني. وانعكس هذا الهجوم على سير القضية! ففي مرحلة الاستئناف، قدم كلٌّ من دفاع المتهمين والمجني عليهن تصالحاً، وتراجعاً للناجيات عن أقوالهن!
لكن بعض الرجال يتخذون من هذا التبرير غطاء لممارسة عنف مطلق، كما في واقعة مأساوية بمحافظة الغربية، حين تعرضت فتاة قاصر فقيرة لم تتعدَ الخامسة عشرة، للضرب المبرح والتعذيب على يد زوجها، قبل أن يلقي بها من سطح المنزل، لأنها أكلت طبق مكرونة من دون علمه، فيما كشف تقرير الطبيب الشرعي عن آثار ضرب مبرح وكي بالنار، وقالت والدتها في تصريح إعلامي[5]: "الدكتور قالي مضروبة بالشومة على دماغها وجسمها فيه آثار كي بالمكواة". الأمر الأكثر إيلاماً في قصة فاتن، أن الأم نفسها كانت تتعرض للضرب من زوج ابنتها، ورفضت التدخل لإنقاذ فاتن في يوم قتلها خوفاً منه! وعلى الرغم من بشاعة الجريمة، حُكم على القاتل بالسجن سبع سنوات فقط، بعد تخفيف التهمة إلى "الضرب المفضي إلى الموت".
وفي واقعة مشابهة، كانت منال، وهي أم مسيحية لأربعة أطفال، ضحية لعنف زوجي استمر سنوات. كان زوجها يضربها ويهينها رغم أنها المعيلة الأساسية للأسرة. وحين قررت الانفصال، اعتدى عليها بعنف مبرِح أدى إلى كسر جمجمتها، ودخولها في غيبوبة لشهر كامل قبل وفاتها.
أكد الأبناء والجيران خلال التحقيقات أن الزوج كان يهددها بالقتل، وسبق تقديم بلاغ رسمي ضده، لكن من دون حماية فعالة. صدر الحكم على الزوج بالسجن سبع سنوات فقط، مع تهديده لأبنائه بالانتقام منهم، ما دفع الأبناء إلى إطلاق حملة بعنوان "حق ماما منال لازم يرجع"، مطالِبين بإعادة محاكمته بتهمة القتل العمد، وتشديد العقوبة، لحماية ضحايا العنف الأسري.
يبدو أن العنف ضد النساء في مصر لا يزال يجد بيئة تسمح باستمراره، ما دامت شكاوى النساء مهمشة، وتحقيق العدالة لصالحهن غائباً، واستمرار حملات الكراهية الإلكترونية ضدهن بلا رادع. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تشديد العقوبات على جرائم العنف المنزلي، وتوسيع هامش الحريات، وتمكين النساء من الوصول إلى هيئات حماية رسمية أو مدنية، ذات مصداقية وقدرة على اتخاذ إجراءات حقيقية وسريعة. وربما يتطلب الأمر تفعيل العمل العام.
- “Cyber violence pattern and related factors: online survey of females in Egypt”, Egyptian Journal of Forensic Sciences، 2020, https://shorturl.at/yC3lU ↑
- قانون رقم (1)، لسنة 2000 https://h1.nu/1i4ev ↑
- جلال أمين. ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصري في نصف قرن (1945–1995). القاهرة: دار الشروق، 1998. ↑
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب "المجلس القومي للمرأة" بحماية المُبلِّغات والشهود في "قضية فيرمونت" https://h1.nu/1djZS ↑
- قصة مأساوية من مصر.. قتل زوجته القاصر بسبب "طبق معكرونة" https://h1.nu/1djZi ↑