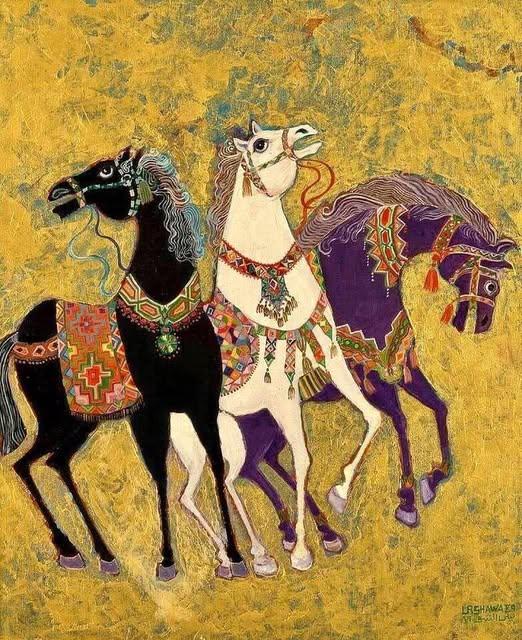أنجز هذا المقال ضمن أنشطة شبكة المواقع الاعلامية المستقلة حول العالم العربي، والتي تضم علاوة على "السفير العربي"، "أوريان 21"، "مدى مصر"، "حبر"، "ماشاالله نيوز"، "المغرب الناهض"، "نواة"، و"باب المد".
كما المعتاد، عدتُ من عملي الصحافي كما يعود الجندي من مهمة تتركه أقل امتثالاً وأكثر كسراً. لا أذكر أنني قط حملت معي إلى البيت ما أحمله الآن من ثقل. ليس ثِقَل الدرع الصحافي الذي يتخطى 35 كيلو جراماً، بل ثِقَل الوجوه التي رأيتها، الضمائر المُثقلة بالقلق، والوداعات التي لا تُحكى إلا في العيون. وقفتُ أمام باب بيتنا أبحث عن طمأنينة لم أجدها. أختي وزوجها قد اتخذا قرار النزوح إلى الجنوب، بدافع البقاء. تركوا ما تبقى من أثاثٍ، وحنين البيوت، وذاكرة الشارع التي حملت طفولتنا، وَراكموا خوفهم داخل حقائب صغيرة ظنوا أنها كافية. هم محقون. أيُّ إنسان يريد أن يَحيا لا أن يُسجّل في إحصاءات الضحايا. هذا عقلٌ بسيط لا يقبل المجادلات.
معايشة الحرب في "غزَّة" - شهادة
13-06-2024
مدرسة إعلاميّي غزّة: وترٌ وحيدٌ.. يُقاوِم
26-10-2023
كان زوج أختي ينتظر بصبرٍ مرير أن يحين دوره مع صاحب السيارة الذي سينقله. وكأن الانتظار نفسه اختبارٌ قاسٍ لقدرة الإنسان على تحمل المجهول. من حي الدرج حتى خان يونس، المسافة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل عبوراً من حياة إلى أخرى، من بقايا بيتٍ مهدّم إلى مأوى مؤقت، لا يحمل يقين الغد. في تلك اللحظات، كنت أراقب أختي وأطفالها، أقرأ في وجوههم أسئلة أكبر من أعمارهم: هل الرحيل خلاص أم بداية ضياع؟ تساءلتُ في داخلي عن إن كان يحق لي التدخل، لكني آمنتُ بأن خيار الرحيل أو البقاء لا يُفرَض، بل يُعاش بثمن الروح والإرادة.
لم يكن الانتظار وحده هو المأساة، بل الثمن الباهظ الذي يفرضه الواقع على كل خطوة نحو النجاة. أجرة السيارة التي ستقلّهم من حي الدرج إلى خان يونس، بلغت ما لا يقل عن 600 دولار، وهو مبلغ يكفي لإعالة أسرة كاملة لشهور في زمنٍ طبيعي، لكنه في زمن الحصار والنزوح تحوّل إلى مجرد بطاقة عبور. وحتى بعد الوصول، فإن النزوح لا يعني امتلاك مأوى، بل شراء وهمٍ اسمه "خيمة"، بسعر لا يقل عن 500 دولار، خيمة لا تصمد أمام برد الليل ولا مطر الشتاء، لكنها تُمثّل سقفاً من قماش يحمي العائلة من العراء. ولم تقف الحسابات عند ذلك. فالحياة في أرض النزوح لا تستقيم بلا مساحة جغرافية صغيرة تُقام عليها الخيمة، وهذه بدورها تُشتَرى بثمنٍ لا يقل عن 400 دولار، وكأن الأرض نفسها صارت سلعةً نادرة تُباع لمن يملك القدرة على الدفع. ثم يطلّ سؤال الماء، وهو أبسط مقومات الحياة، لكن الحصول على خزان يكفي العائلة، يحتاج إلى 600 دولار أخرى، أما إنشاء حمامٍ متواضع يضمن شيئاً من الكرامة فيتطلب 700 دولار. أمام هذه الأرقام التي تنهش الروح قبل الجيب، بدا الرحيل كأنه قفزة من هاوية إلى أخرى، حيث كل شيء يُدفع بالدولار، حتى حق البقاء على قيد الحياة.
كنت أودّعهم وأنا أحاول أن أبقى صحافياً صلباً، أعطي للوداع شكله الموضوعي: أحتضن، أتبادل عبارات المواساة، أظهر التعاطف، وأنهي المشهد بابتسامة لا تصل إلى العين. الهوية الصحافية أحياناً تظهر أكثر مما يليق: أترجم الألم إلى تقرير، أتلو على نفسي نصوص الواقعة وكأنها مادة للتحقيق. اليوم لم أستطع. صوتي خنقني قبل أن يُسجَّل على جهاز التسجيل، ويداي ارتعشتا وأنا أضع الحاجات في صندوق السيارة. رأيت في وجه أختي خطوط الانهيار، التي لا تُرى إلا لمن عاشوا ما نعيش. تساؤلها الصامت عن مصير أطفالها كان ثقيلاً كأحجار البنيان التي انهارت على رؤوس آخرين. حاولتُ أن أكون الشخص الذي يُعطي الطمأنينة، لكن الطمأنينة لا تُعاش بالحديث وحده، هي مساحة تُبنى بأمان ملموس — متى سنستطيع أن نعيد تلك المساحة؟
أُدرك أن عملي يتطلب مني أن أكون شاهداً لا متواطئاً، وأن أحفظ سرد الحدث من دون أن أغرق فيه. لكن هناك فرقاً بين الحفظ والتجريد. حين أودع أحبائي، لا أستطيع أن أحوّله إلى مجرد مادة باردة لصالح مقال. ألحظ تفاصيل صغيرة: يد ابنة أختي التي تتمسك بحبل الحقيبة، لعبة نصف مكسورة تحتضنها كأنها آخر سلاحٍ ضد النسيان، وسواد الليل الذي يلتهم ما تبقى من ضوء. هذه التفاصيل تلاحقني في الميدان وتلاحقني في البيت. أصنع منها جملاً، أكتبها في دفتر ملاحظاتي ثم أمحوها، لأنني أرفض أن تظل حياتهم مجرد سطور تُنشر وتُقرأ ثم تُنسى. هو نفس القهر — أن ترى الناس يُعاملون كأرقام في تقرير، بينما كل رقم خلفه اسم، وجه، قصة، وحلمٌ صغير لا يتجاوز مساحة قدح من القهوة.
لحظات الوداع كانت أقصر مما تستحق. الزمن هنا مضطرب، يختزل الساعات في دفقات من القلق. عند الباب، تبادلتُ مع أختي الأخيرة كلمات، يبدو أن المعنى الحقيقي لها لن يُحكى إلا بعد أن يمرَّ بنا الزمن: "اعتنوا بأنفسكم"، "ارسل لنا كل خبر"، "لا تتأخر عن الحضور إن احتجت". كلمات اختصرت الخوف والرجاء في آن. وأنا أعود إلى عملي، أحمل في قلبي قهراً لا أستطيع إخراجه بكلمات التحقيق، لأن الصحافة هنا ليست مجرد نقل وقائع، إنها واجب إنساني على من يملك صوتاً أن يمنحه لمن لا صوت له. لكن كيف أؤدي هذا الواجب وأنا أعلم أن كل كلمة قد تكون الأخيرة في لسان أحدهم؟ كيف أكتب بحيادية مهنية وأنا أرى وجوه أحبائي تبتلعها غيوم الانفجار؟
الصحافي في الحرب لا يملك رفاهية الانفصال عن الميدان. يُطلب منه أن يرى وأن ينقل، وأن يبقى إنساناً. هذه المهمة تضاعف الألم: أنت تشهد، توثّق، وتعود لتودع. الفرق أن الوداع في زمن الحرب له طقوس بديلة: لا زهور، لا موائد طويلة، بل حقائب متواضعة، ووعود بالكلام عبر الهاتف إن كان هناك هاتف. كنتُ أظن أن احترافيتي ستهذِّب عواطفي، لكن الواقع قاسٍ: المهنية هنا تُجرح وتُجبر على إعادة تعريف نفسها. كيف تفرضَ سرداً متوازناً على تقرير، بينما قلبك يصرخ أن لا شيء في هذا التوازن طبيعي؟
غزة فوق العالم
09-09-2025
أخواتي، أقاربي، أصدقائي الذين غادروا إلى الجنوب لن يختزلوا الذكريات، ولكنهم سيحملون معها جزءاً من هويتنا. أحياناً أخاف أن يتحول النزوح إلى عُبورٍ إلى نسيانٍ بطيء، نسيان تفاصيل المكان الذي صاغنا. كصحافي، أخشى أن تتحول مادة تحقيقاتي إلى لائحة من المآسي المبسوطة التي تقرأ ثم تُطوى. لذا أفكر في أن الطريقة الوحيدة للمقاومة هي أن أجعل من كتابتي شاهداً حياً: أن أكتب عن أسماء الأشخاص، عن أصواتهم، عن ضحكاتهم، عن الأشياء الصغيرة التي تُشكِّلهم. أن أكتب كيف تقف أمّ في زاوية وتقبِّل آخر لعبة لطفلها قبل أن يُركِبوها السيارة. هذا ليس فقط توثيقاً، إنه محاولة لإبقاء إنسانيتهم حاضرة في نص لا يذروه النسيان.
الألم الذي أعيشه ليس شخصياً، ولا وحيداً. إنه ألم مجتمع كامل، يتوزع على مساحات المنازل المهدَّمة وطوابير الغذاء والانتظار على بوابات المستشفيات. ولكني أؤمن أن لكل ألم شكل مقاومة. وداعي لهم لم يكن استسلاماً، بل قراراً عملياً: أن يبقوا حيث تتاح لهم فرصة أقل للموت. لم أعد أستطيع أن ألوم رغبتهم في الحياة. وما أتمناه هو أنني بعملي أستطيع أن أُعيد إليهم شيئاً من الكرامة، أن أكون مرآة تعكس قصصهم بصدق، لا مجرد عدّادات ونسب. هناك فرق بين أن نقول إن "مئة منزل دمر" وأن نقول إن "عائلة كذا فقدت سرير طفلها الذي كان هديته الأولى". الأولى إحصاء، الثانية إنسانية.
حين أغلقت باب بيتهم، لم يكن لديّ سوى وعدين: الأول أن أعود معهم إذا استطعت، الثاني أن أكتب عنهم بقدر ما تستحقّ حياتهم من كلمات. لا أضمن أن هذه الكتابة ستحوِّل الواقع، لكنها تبقى فعل شهادة ومقاومة. في عملي، أتعلم أن الصياغة المهنية لا تشيخ حين تمتزج بالألم الإنساني، بل تكتسب واقعيتها من صدقها. أرفض أن أستسلم لقهرٍ يَسرق الأسماء، لذلك سأكتب عن أختي، عن أطفالها، عن امرأةٍ ربطت وشاحها ثلاث مرات لترضي العالم. سأكتب لِما يظل فينا إنسانياً حتى في أحلك الساعات.
هذه قصتي
01-10-2025
وانا لم أنفك عن التفكير بين كيفية إنقاذ أمي وإخوتي الباقين معي في المدينة وما علي من واجب مهني، أمام مشهدية الواقع الذي أعيشه، كالباقين في قلب المدينة، فهذا الواقع يفرض عليّ أن أكون مزدوجاً: صحافياً يحترم قواعد المهنة، وإنساناً لا ينسى أن وراء كل حدث بشراً يُحبّون ويخافون. قد أعود كل يوم إلى لحظة الوداع تلك، وهي محمولة في ذاكرتي، كمرساة تمنعني من أن أكون مجرد ناقل أخبار بارد. سأحمل هذا القهر وأجعله وقوداً لتأكيد واحدٍ بسيط: أن للبقاء وجهاً إنسانياً يجب أن يُكتب ويحفظ، وإلا سنخسر أكثر من بيوتٍ وطرقات، سنخسر أحبابنا المشتركين، الذين يجعلون منّا مجتمعاً يعترف ببعضه البعض.