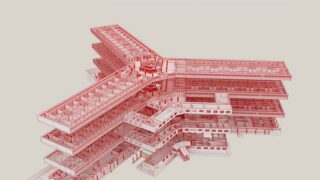الملفت في الغضب الشعبي الذي يجتاح الآن عدة أماكن من سوريا ويتخذ أشكالاً مختلفة، أنه انطلق من الكتلة الموالية للنظام، خاصة في الساحل السوري، قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى ومنها "السويداء". في الأشهر الأخيرة، ارتفع منسوب الغضب ضد السياسات الحكومية، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على الموالين الذين توقعوا أن تكون مكافآتهم على مواقفهم و"تضحياتهم" غير ذلك، وحلّت لديهم خيبة أمل عريضة من "الأمل بالعمل" (شعار الرئيس السوري الانتخابي)، و"التضحيات" التي قدّمتها الكتلة الموالية لبقاء النظام، ولكل "الصبر" الذي تحمّلته على مدار سنوات الجمر السورية السابقة. وفوق ذلك ساد إحساسٌ جماعيٌ بأنّها كانت عرضة للاستغلال، فظهرت كأنها "أضحوكة" لدى الكتل السورية الأخرى، المعارضة والحيادية، بغياب منطق مقبول لديها دفاعاً عن موقفها. وبات الحديث عن العقوبات الأميركية على سوريا ـ مثلاً ـ غير مقنع للموالين الذين يلمسون يومياً كيف تفْتك العقوبات بهم وتتفاداها سلطتهم وتمارس فوقها عقوبات إضافية بحقهم.
قبل شهرين، نشرنا في السفير العربي عن توقع أميركي بانهيار اقتصادي وشيك في سوريا خلال ستة أشهر كحد أقصى. ويبدو أن هذا التوقع في طريقه للتحقق في وقت أقل، إذ أنّ عوامل التضخم المتضاعِف يومياً، وتسارع انهيار العملة، والتخبط الاقتصادي والسياسي، هي عوامل تجعل البلاد على حافة الانفجار، دون قيام الحكومة، ومن فوقها النظام، بأية إجراءات إسعافية للانتقال بالأزمة السورية المستعصية إلى عتبة جديدة قد تخلق آفاقاً للحل.
ماذا يجري في الساحل السوري؟
سجّل الساحل السوري نسبة تأييد عالية لسياسات نظام دمشق على الرغم من انطلاق الحراك في العام 2011 من بعض مناطقه. ولم يعد خافياً أنّ هذا التأييد، سواء عبر المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو أجهزة الدولة العميقة في سوريا، أو عبر الكتلة الشعبية في الساحل (العلوية أساساً)، هو ما ساعد النظام على البقاء على قدميه على رأس الدولة، مستفيداً داخل البلاد وخارجها من شبكة علاقات محسوبية وزبائنية، وماهراً في إثارة السوريين ضد بعضهم البعض.
في الأشهر الأخيرة، اتسعت الاعتراضات على سياسات الحكومة (الخدمية) التمييزية ضد أبناء الساحل وارتفع الصوت ضدها، متسببةً، كعامل مباشر، في انزياح نسبة من الكتلة الموالية عن نقطة التأييد الأعمى لسياسات النظام. ظهر ذلك بوضوح على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، التي عجّت بالغضب تجاه السياسات الحكومية الأخيرة المتركزة بشكل أساسي على إلغاء دعم السلع الضرورية مثل الوقود. ويمكن ملاحظة أنّ هذه النوعية من الاحتجاجات في الفضاء الافتراضي كانت الأكثر حضوراً لدى بيئات الموالاة منذ سنوات، وتشمل الاحتجاج على "عدالة التقنين الكهربائي" إلى الاعتراض على "سوء توزيع مياه الشرب"، و"ارتفاع أسعار المواد والسلع" في الأسواق دون حسيب ولا رقيب. وبمجملها فهي مطالب خدمية بحتة، خلت من الاحتجاج السياسي.
فيما سبق، حمّل الناشطون مسؤولية تردي الخدمات الحكومة التي تنفّذ تعليمات "البنك الدولي" (غير المعلنة رسمياً حتى الآن). على أنّ الموجة الأخيرة من الاحتجاجات تجاوزت تلك الدائرة واقتربت من نقاط سياسية حساسة يسميها السوريون "الخطوط الحمراء" التي تضم الرئيس والأجهزة المرتبطة به، أمنياً واقتصادياً، مثل المطالبة بإجراء تغييرٍ حقيقي في النظام يوقف العقوبات المفروضة على البلاد ويسمح بتدفّق الموارد من أجل إعادة الإعمار، بما يشير ضمناً إلى أنّ البروباغندا السلطوية في تحميل مسؤولية الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون الدول الغربية التي تفرض عقوباتٍ على دمشق، لم تعد مقنعة للسوريين.
أيّد الساحل السوري سياسات نظام دمشق على الرغم من انطلاق الحراك في العام 2011 من بعض مناطقه. وهذا التأييد، سواء عبر المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو أجهزة الدولة العميقة، أو عبر الكتلة الشعبية في الساحل (العلوية أساساً)، ساعد النظام على البقاء على قدميه، مستفيداً داخل البلاد وخارجها من شبكة علاقات محسوبية وزبائنية، وماهراً في إثارة السوريين ضد بعضهم البعض.
ظهرت هذه الاتجاهات في منصات التواصل على حسابات موالية حقيقية، كما رفع السوريون سقف الكلام الشفوي في الشارع، وانتشرت تعبيراتٌ علنية من مؤيدين للنظام تنتقد سياساته التي أوصلت البلاد إلى وضعها الأسوأ في تاريخها، حيث شهدت مدن وبلدات ساحلية سورية للمرة الأولى في تاريخها كتابات على الجدران في مسقط رأس آل الأسد ("القرداحة") تندد بالحكم، كما ظهرت في مناطق أخرى، في "سهل الغاب" و"مصياف" و"عين الكروم" و"البودي" وغيرها، مع تمزيق صور الرئيس وأخيه في مناطق الحرائق شمال "اللاذقية"، فيما قامت مظاهرة خجولة من عشرات الأشخاص في مدينة "جبلة" قمعتها السلطة بعنف موقعةً عدداً من الجرحى، وفق شهادة محلية من المدينة، مع ملاحقة أمنية شرسة لمحاولات نقل الوقائع إلى الشبكات الاجتماعية، فيما تعرّض محافظ "طرطوس" للضرب من قبل مواطنين غاضبين على خلفية إصرار مجلس المحافظة على فرض أعضاء بعثيين على مجلس بلدية "دوير رسلان" التي فاز فيها مستقلون بانتخابات الإدارة المحلية مؤخراً.
الأكثر لفتاً للانتباه حركة أطلقت على نفسها اسم "حركة 10 آب"، أصدرت بيانيَن مطلبيّين على "فيسبوك" ووزعت مناشير في عدد من مدن الساحل و"دمشق" و"حمص".. ولا تتوافر معلوماتٍ حول هذه الحركة وفيما إذا كانت موجودةً بالفعل وتضم أعداداً من السوريين داخل البلاد أم لا، ولم يتضح مدى تنظيمها.
خلال ساعات قليلة، تعامل مستخدمو "فيسبوك" السوريون، خاصةً المقيمين في مناطق النظام، بجديةٍ مع البيانَين، خاصة الأول، وأعلن قسم منهم موافقتهم على صيغته التي "تطالب الحكومة السورية بإعلان جدولٍ زمني لاتخاذ إجراءاتٍ توقِف تدهور الأحوال المعيشية".
"طرطوس" مدينة الفرص الضائعة
13-07-2016
وكان لافتاً في البيانين أنّ المطالب لم تقتصر على الجانب المعيشي، فقد تحدثت عن المعتقلين السياسيين والمعتقلين من النساء والأطفال، وعن ضرورة وقف تجارة المخدرات والقضاء على تجارة "الكبتاغون". وهذه مواضيع تضرب على خطوط النظام الحمراء وتبعاتها عادةً الاعتقال والإخفاء القسري.
تجاوزت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات المطالب الاجتماعية واقتربت من "الخطوط الحمراء"، التي تضم الرئيس والأجهزة المرتبطة به، أمنياً واقتصادياً، مثل المطالبة بإجراء تغييرٍ حقيقي في النظام يوقف العقوبات المفروضة على البلاد ويسمح بتدفّق الموارد من أجل إعادة الإعمار، بما يشير إلى أنّ البروباغندا السلطوية في تحميل مسؤولية الأوضاع السيئة للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على دمشق، لم تعد مقنعة للسوريين.
شهدت مدن وبلدات ساحلية سورية للمرة الأولى في تاريخها كتابات على الجدران في مسقط رأس آل الأسد ("القرداحة") تندد بالحكم، كما ظهرت في مناطق أخرى، في "سهل الغاب" و"مصياف" و"عين الكروم" و"البودي" وغيرها، مع تمزيق صور الرئيس وأخيه في مناطق الحرائق شمال "اللاذقية"، فيما قامت مظاهرة خجولة من عشرات الأشخاص في مدينة "جبلة" قمعتها السلطة بعنف.
وفي رد فعل متوقع اعتقلت السلطات الأمنية ناشطين ظهروا بقوة مؤخراً، مثل "فراس غانم"، وهو بالمناسبة عنصر أمن متقاعد حديثاً، و"أحمد اسماعيل" وهو موظف وناشط من الساحل السوري (ولا علاقة لهم بحركة 10 آب/أغسطس) فيما أثار فيديو محاولة اعتقال "لمى عباس"، وهي ناشطة مجتمعية مقرّبة من النظام، إثر احتجاجها على الأوضاع المعاشية في البلاد، لغطاً شديداً وأسئلة للمرة الأولى لدى الموالين بشأن عدم قانونية عمليات الاعتقال هذه. وفي آخر التوترات، منعت السلطات الأمنية اجتماعاً مدنياً لـ"حركة التغيير السلمي" في بلدة "بسنادا" (من أحياء "اللاذقية") وأحاطت بالبلدة، وفي الوقت نفسه تعاطت مع المدنيين بنوع من المرونة تفادياً للتصعيد الاجتماعي.
ومع شراسته في قمع بواكير الاحتجاجات وانتباهه الكبير تحسباً لتحولها إلى موجات بشرية، عمد النظام والحكومة معه إلى محاولة تحسين الواقع الخدمي في مدن وقرى الساحل السوري، ولو على حساب سوريين آخرين، إذ عادت الكهرباء إلى الوصل لمدة ساعة ونصف كل ست ساعات في "اللاذقية" و"طرطوس" بعد أن قضى الساحل أكثر من ست سنوات على إيقاع كهرباء لساعتين يومياً، كما ربطت بعض مضخات المياه بخطوط كهرباء دائمة ("ساخنة" كما تسمى) سمحت بحلٍ جزئيٍ لمشكلة غياب مياه الشرب. ولكنّ سياسة الرشوة هذه، ووفقاً للظاهر حتى الآن، مؤقتة وسبق حدوثها، ويعي الناس ذلك بوضوح، وبأنها محاولة ﻹسكات صوت الغضب في ظل تردي الواقع الاقتصادي والسياسي.
من هم هؤلاء المحتجون؟
على مدار عقد من الكارثة السورية، انقسم السوريون بين كتلة مؤيدة للنظام وأخرى معارضة له وثالثة غائبة حيال الكارثة، ونعني كتلة "الحياديين". وهناك بالضرورة في كل كتلة تفاوت في نسبة التأييد أو المعارضة، ولكن الانهيارات الاقتصادية المتتابعة مؤخراً في قيمة الليرة السورية (15 ألف ليرة لكل دولار) وارتفاع الأسعار الجنوني وارتفاع نسبة التضخم إلى حدود غير معقولة (في بعض السلع بلغ الارتفاع مئة ضعف) خلخلت تركيبة ومواقف الكتلة الموالية التي تعيش ضياعاً حقيقياً. وهذه الأوضاع الاقتصادية السيئة لم تستطع حتى الآن توحيد الكتل السورية في رؤية واحدة لمستقبل البلاد، فما تزال الجغرافيات السورية تعيش أوجاعها كلّاً على حدة، ويلاحظ ذلك بوضوح في حوارات "الطرشان" على منصات التواصل الاجتماعي بين السوريين وتبادل اتهامات "الشماتة"...
عمدت الحكومة إلى محاولة تحسين الواقع الخدمي في مدن وقرى الساحل السوري، ولو على حساب سوريين آخرين، إذ عادت الكهرباء لمدة ساعة ونصف كل ست ساعات في "اللاذقية" و"طرطوس" بعد أن قضى الساحل أكثر من ست سنوات على إيقاع كهرباء لساعتين يومياً، كما ربطت بعض مضخات المياه بخطوط كهرباء دائمة ("ساخنة" كما تسمى) سمحت بحلٍ جزئيٍ لمشكلة غياب مياه الشرب.
لا تختلف تركيبة الكتل السورية وهي قائمة في العالم الافتراضي عن بعضها إلا في موقفها السياسي من النظام السوري، فهي طبقياً واجتماعياً تضم الفلاحين/ات والعمال والطلاب وموظفي/ات الدولة والمنتفعين من الجهاز الحزبي البعثي أو الأمني أو الميليشياوي، بغياب واضح للطبقة الوسطى والعليا، وتكاد تخلو من كافة أنواع النخب. ويمكن الإشارة إلى أنّ الموقف السياسي نفسه موضع تبدّل وناتج في حالات منه عن الجغرافيا، بمعنى أنّ مناطق دمشق تضمّ معارضة غير ظاهرة نتيجة القمع السياسي والأمني المتجذر، وتضم مناطق المعارضة موالاة مخفية نتيجة القمع أيضاً.
سوريا بين جمهوريتين
30-04-2015
بالنسبة للكتلة الموالية، ونتيجة للوضع العام، إضافة إلى ممارسات تمييزية خدمية بشكل أساسي، فإنها شعرت بالغبن، مع أخبار متلاحقة عن استحواذ رجال النظام وقادته على الامتيازات والأموال والأراضي، وفرض إتاوات على البضائع المنقولة في مناطق البلاد المختلفة. مؤخراً وبغاية تخفيف الانتقادات الموجهة للنظام أُزيل عدد من الحواجز العسكرية بين المدن الرئيسية، ولكن سرعان ما اتضح أنها خطوة لا قيمة لها بسبب ترك حواجز الفرقة الرابعة التي تسيطر على طرق حيوية في مناطق سيطرة دمشق، وتفرض إتاوات على نقل البضائع.
هل نتجه إلى "ثورة" جديدة؟
ولكن وسط هذا الغضب المكبوت/ الظاهر لا تبدو الأمور وكأنها ذاهبة إلى ثورة جديدة ولو بلبوس مطلبي، إذ أنّ مسألة الثورة أو الاحتجاج ـ في حدوده الواسعة ـ ليست أمراً متاحاً بسهولة في بلاد حرثها نظامها بكل أنواع المؤامرات والأسلحة والتدخلات العسكرية والسياسية، وتعيش فراغاً سياسياً منذ نصف قرن ولم تنجح معارضاتها في بناء سياسي ذي مغزى.
في مقالٍ له حول أزمة الحياة السياسية في سوريا، العام 2009، كتب المعارض السوري العتيق والمختفي قسرياً، "عبد العزيز الخيّر": "إنّ الديكتاتورية قد نجحت في تذرير المجتمع السوري منذ ثمانينات القرن الماضي، وزرعت فيه رهاباً عميقاً من العمل السياسيّ". وقد أدّت هذه السياسات التراكمية القمعية إلى نتائج كارثية سواء لجهة النظام مع تحوّل منظوماته السياسية الأحادية إلى ظلٍ للأجهزة الأمنية، أو لجهة المعارضة بعد العام 2011 حين سقطت سياساتها في وحول التجاذبات الإقليمية والدولية بالضد من المصلحة السورية.
يضاف إلى ما سبق جملة عوامل نافذة واقعياً تؤثر على وحدة وكيان الدولة السورية وتكاد تطيح بهما في مهاوي التقسيم بعد أن تمترست قوى الأمر الواقع وراء قوى إقليمية ودولية متعارضة المشاريع في سوريا. وهو أمر تستفيد منه السلطة السورية في تعزيز صورة ضرورة بقائها لدى الموالين لها وبأشكال مختلفة.
ففي غياب الطرح السياسي، لن تجد هذه الحركات الغاضبة أنصاراً آخرين ممن "أكلوا الفلقة" سابقاً، ولم تتضامن معهم الموالاة ولو في الشق اﻹنساني.
كما أن رفع سقف الكلام الشفوي وبوادر الاحتجاجات الخفيفة الأثر، والأفرادية بشكل كبير، سوف يتبخر عند أول اختبار عملي للتظاهر أو التنظيم الجماهيري، ليس فقط ﻷنّ الكتلة الموالية - والسوريين كلهم - تواجههم آلة قمعية هائلة ذات خبرة ما تزال سليمة من الانشقاقات والتهتكات، وغياب مشاركة الفاعلين العسكريين والأمنيين حتى الآن، بل لأنّ تركيبة المحتجين لا تتضمن ناشطين أو قادة أو سياسيين قادرين على التعاطي مع هذه الخبرة الأمنية في إثارة السوريين وإرهابهم، يضاف إلى ذلك أن هذه الجموع المنتمية إلى الطبقة الوسطى سابقاً لا تمتلك حاملاً سياسياً وليس لديها خطاب بديل جامع.
من جانب آخر، هذه الكتلة وإن كانت تتشارك حالياً الآلام نفسها مع السوريين الآخرين، فإنّها تفتقد لداعمين يمكن التعويل عليهم، سواء داخلياً من قبل السوريين الآخرين، الذين ينظرون بعين الشماتة أو الريبة إلى هذه الكتلة، أو خارجياً، حيث لا أحد مهتم بمصيرها. وهذا ما يجعل الذهاب نحو الأمام في الاحتجاج مسألة محفوفة بمخاطر كبيرة.
في خصائص النظام
إضافة إلى ما سبق، هناك الانهيار الاقتصادي الماثل للعيان، مع توابعه الاجتماعية، وهو يطال بنية الدولة السورية ومؤسساتها وناسها دون أن ينال من مؤسسات النظام باعتبار الأخير أسّس عبر تاريخه الطويل (نصف قرن) لمؤسسات موازية يقودها ويشرف عليها عبر أجهزة إدارية خاصة وعلاقتها بمؤسسات الدولة السورية هي علاقة تبعية ذات اتجاه واحد.
حتى الآن تستمر هذه الإشكالية بالعمل لصالح مؤسسات النظام بالضد من الانهيار المتتابع لبنى مؤسسات الدولة والمجتمع السوريين، بمساهمة ناجحة من الحكومة الحالية عبر إجراءات ليبرالية مثل تعويم الليرة السورية وتحرير الأسواق والأسعار من الرقابة بكل أنواعها، بالتزامن مع حد أدنى من محاولة تهدئة الشارع الغاضب عبر وعود بتحسين رواتب الموظفين مقابل رفع الدعم عن السلع المدعومة ومنها الخبز الذي يتوقع رفع الدعم النهائي عنه قبل نهاية العام الجاري.
إنّ اقتصاد النظام الخاص العميق الأذرع في قلب الدولة السورية محمي إلى حد كبير من الانهيارات لأنه اقتصاد نفعي يقع فوق الدولة، مبني على "الدولرة"، ويتابع التغيرات الحاصلة ويتجنب الوقوع في فخها. فقد رفعت أسعار الاتصالات المملوكة للنظام عدة مرات ومعها الإنترنت، في وقت تستمر فيه تجارة وصناعة الكبتاجون بالازدهار على مستوى البلاد، ولعلها الصناعة والتجارة الوحيدة المزدهرة في سوريا هذه الأيام.
لا تختلف تركيبة الكتل السورية عن بعضها، وهي قائمة في العالم الافتراضي، إلا في موقفها السياسي من النظام السوري، فهي طبقياً واجتماعياً تضم الفلاحين/ات والعمال والطلاب وموظفي/ات الدولة والمنتفعين من الجهاز الحزبي البعثي أو الأمني أو الميليشياوي، بغياب واضح للطبقة الوسطى والعليا، وتكاد تخلو من كافة أنواع النخب.
هناك الانهيار الاقتصادي الماثل للعيان، مع توابعه الاجتماعية، وهو يطال بنية الدولة السورية ومؤسساتها وناسها دون أن ينال من مؤسسات النظام باعتبار الأخير أسّس عبر تاريخه الطويل (نصف قرن) لمؤسسات موازية يقودها ويشرف عليها عبر أجهزة إدارية خاصة وعلاقتها بمؤسسات الدولة السورية هي علاقة تبعية ذات اتجاه واحد.
يقودنا ما سبق إلى أن النظام يعيش لوحده ويحاول الدفاع عن مواقعه وأنه لا مشكلة لديه في استخدام القمع والعنف ضد الكتلة الموالية متى اقتضى الأمر ذلك، وأنه على استعداد للتضحية بالخط الدفاعي الثالث أو الرابع مقابل تدعيم الخطوط الأولى والثانية، وفي الوقت عينه حماية نفسه عبر تقديم تنازلات على المستويات الإقليمية والدولية، بمعنى أن احتجاجات الكتلة الموالية قد لا تشكل فرقاً إلا في حال اتساعها وهذا محتمل بعد أن ذهبت الحكومة بوقاحة إلى رفع كامل الدعم وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 100 في المئة، وهي لا تغطي نسبة 10 في المئة من قيمة التضخم الحاصل. ولكن بالمقابل، لن تتردد الآلة القمعية في الذهاب إلى أقصى المواجهة، ونموذج العراق المشابه للنموذج السوري كثيراً ماثل في المشهد أمام النظام وأمام المحتجين المحتملين.
الاستنفار يعم البلاد
بينما كان الرئيس السوري يتحدث عن "وقوف غالبية الشعب السوري" إلى جانبه أثناء حديثه مع قناة "سكاي نيوز" الإماراتية، حاولت قوة أمنية في مدينة "بانياس" الساحلية الوصول إلى كاميرات المراقبة في عدد من محطات الوقود إثر توزيع مناشير لـ"حركة العاشر من آب" في المدينة، فيما قامت جهات أمنية بحملات لاعتقال ناشطين في "جبلة" و"اللاذقية" و"حمص"، في حين أنّ مدناً سورية انضمت إلى قوائم الاحتجاج بما يشبه أجواء العام 2011.
أغلبية السوريين، ونتيجة المعاناة والظلم والتدهور المستمر في حيواتهم، لم يعد لديهم ما يخسرونه. وبقدر ما يدفع هذا للرغبة والاستعداد للعمل من أجل التغيير، بقدر ما تحضر سيناريوهات العام 2011 الكارثية، كأكثر تعبير عن اليأس. واليأس إما أن يدفع الناس إلى الشارع بشكل غير مدروس وخطير، أو يقودهم إلى الانكفاء والعزوف عن التغيير... ويبقى الأفق مجهولاً!