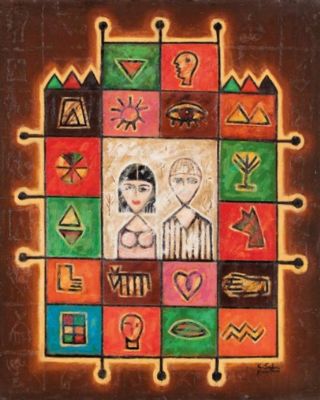"ثمّة أماكن محدّدة للقاء، والآن باتت جميعها مكشوفة"، يقول سائق تاكسي وكأنه أحد تجّار الممنوعات وهو يتحدَّث عن صعوبة لقائه بحبيبته في متنزّهات بغداد. تكاد قصص الحب في العاصمة تتلاشى أو تتحوّل إلى حكاياتٍ محزنة بدلاً من أن تكون مُفرحة وباعثة على الحياة في عراق اليوم، وقد تلاشى حيزه العام الذي لم يعد يصلح للسياسة، فكيف إذاً للحب؟ يعيش الشباب إناثاً وذكوراً مفارقات مؤلمة كالوجود في شارع واحد من دون أن يكونوا قادرين على التواصل إلا عبر المواقع الإلكترونية، في ظل انغلاق تام للمجتمع وانحسار حيزه العام المتمثل في متنزهات بغداد، القليلة بكلّ الأحوال، إذ تقتصر على ثلاثة أماكن في الرّصافة هي حدائق شارع أبي نواس، أو متنزّه الزوراء في الكرخ، وبينهما متنزّه الجزيرة السّياحية الذي يقع في أطراف العاصمة، إلّا أنه ليس مُفضّلاً لبُعد مسافته، وبسبب السمعة التي لحقته في الأعوام الأخيرة كون المحبيّن فيه ليسوا "عُذريين" تماماً.
الحب بالسكايب
المُحبُّ، سائق التاكسي، في بداية العشرينيات من عمره، ظلّ طوال الطريق الذي استغرق نحو نصف ساعة وهو يجول شرايين بغداد يتبادل الرسائل القصيرة وصور السيلفي مع حبيبته، ولم يصبر قبل أن يُهاتفها ويُلقي عليها تحيّة الصباح ويمازحها بأبيات شعر عامي. تحوّلت اللقاءات بين الشابين إلى الفضاء الالكترونيّ، فهما يعيشان الحب عبر الهاتف المحمول وبرنامج سكايب و "فيسبوك"، على الرغمّ من أنّهما يسكنان على مقربة من بعض في منطقتين ملاصقتين. هي أنهت الجامعة العام الماضي ولم يَعُدْ أهلها يسمحون لها بالخروج إلا نُدرة، وهو يظلُّ مُتلهفِّاً لها، بيد أنه لا يُريد أن "تُفضَح" أو أن يُساء إلى سمعتها إذا ما التقيا، وهو الأمر الذي قد يجرّ إلى قتلها، أو بأقل الأحوال سوءاً تزويجهما، وهما غير جاهزين لهذا الخيار بعد.
بغداد البالغة مساحتها 4555 كيلومتراً مربعا تضيق بأهلها، وبالنساء على وجه الخصوص، إذ ما عاد متاحاً لهنّ الحضور في الحيز العام. تكاد المقاهي والمطاعم تُخصَّص للرجال بسبب انغلاق المجتمع على نفسه لأسباب عدّة، منها الوضع الأمني المنفلت الذي جعل العائلات تخاف على بناتها من الانفجارات والخطف، فيحدّ من خروج النساء. إلى ذلك كله يُضاف صعود مدّ الأعراف العشائرية التي تزيد من المحافظة وتضع المرأة على رفّ "العيب" وتحوّلها إلى "مشكلة" حتّى يتمّ زواجها و"التخلّص" منها ومن "الأخطاء" التي "قد" ترتكبها، وهذه الأخطاء تتلخّص بتعرفها على ذكور والالتقاء في الأماكن العامة. وبالطّبع لا يمكن إغفال تصاعد الخطاب الديني، الذي يُشهِّر ويعرِّض بالمرأة وملبسها، ويُدين الاختلاط، ويُحرِّم العلاقات خارج مؤسسة الزواج. وأخيراً العسكرة في المجتمع، التي تتيح للميليشيات والقوّات الأمنية المنتشرة في المُدن التصرف على أساس أنّهم أوصياء على "الشرف" و"الأخلاق". كل هذه الخلطة من الرقابات أثّرت على تصرّف السكّان، والرجال منهم على وجه التحديد، وحوّلتهم إسفنجات تمتص الخطابات، وصيّرتهم أوصياء على تصرّفات الجميع.
.. ظهور المرأة بحدّ ذاته، سواء لوحدها أو بصحبة آخر، تحول إلى فعل محرّم وممنوع، يُلاحق اجتماعياً ويُمارس قمعه، في الواقع وكذلك في الفضاء الافتراضي كحيز عام بديل. هكذا وفي وقت انشغل العالم بـ "وثائق باناما" كان العراقيون منشغلون بـ "وثائق" من نوع اجتماعي و "أخلاقي" أثارت الكثير من الجدل ما دفع وسائل الإعلام إلى الركض خلفها، علماً بأن "وثائق باناما" ثبتت تورّط أياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، بغسيل أموال وهو الذي أعلن قبلها بأسابيع ـ متحديّاً ـ بأنه "لا يأخذ أموالاً حتّى من الله". تركّزت "وثائق بغداد" على نشر صور لشبّان وشابات على مواقع التواصل الاجتماعي التُقطت لهم في غفلة منهم وهم يتمشّون في المتنزّهات أو جالسين على مصاطب الحدائق العامّة، أو يتبادلون قبلة سريعة. المُلتقطون لم يكن همّهم سوى التشهير بهؤلاء ووصمهم بأقذع العبارات التي تصل إلى إباحة دمائهم، وهو ما قد يحدث إذا ما كانت إحدى الفتيات تنتمي إلى عشيرة كبيرة من عشائر العراق. وإن لم تكن هذه الظاهرة بجديدة على عراق الألفيّة الثالثة، إلا أنّها كانت ضيّقة وتُتداول بين أشخاص قلّة على الهواتف المحمولة، ومن ثمّ على صفحات مغلقة على موقع "فيسبوك" بعد أن انتشرت التكنولوجيا في العراق. الظاهرة أخذت بالاتساع منذ أعوام قليلة وجرَّت إليها فئات متنوّعة، مضيفة بذلك أسبابا إلى إلغاء المجال العام بعد أن صار مُراقباً ومُحاطاً بهواتف محمولة بكاميرات متطوّرة، وبعد أن أُريد للمجتمع أن يكون كلاً واحداً في طرائق عيشه.
السلطة تُنتج المجتمع!
وعلى العكس مما يروّج له سياسيون بل ومثقّفون في العراق، بأن "السلطة هي نتاج المجتمع"، فإن السلطة كان لها دور أساسيّ ومحرِّض في وصول المجتمع إلى هذا الانغلاق، أي منع الاختلاط وتحويل المرأة إلى عيب. فهي أنتجت خطاباً رجعياً، وتحاول تلطيف التوصيف باعتماد مفردة أنها "محافِظة". النظام السلطوي الحالي كان قد ورث أرضيّة جاهزة عن نظام صدّام حسين الذي عمل مطلع التسعينيات على ترييف المدينة سوسيولوجيا وقيمياً، وصبغها بالإيمان، بعد أن أفلس تماماً من كل شعارات القوميّة والاشتراكية، وبعد أن تبنّت غالبية دول المنطقة الخطاب الإسلامي. وهو أيضاً كان ردّة فعل على انتفاضة الجنوب العراقي التي كان طابعها إسلامي. هكذا عممت مفاهيم منها تلخيص الحب (بسذاجة) على أنه علاقة جنسيّة محرّمة فحسب. وسرعان ما استغلت الأحزاب الطائفية التي وصلت إلى سدّة الحكم بعد احتلال بغداد في نيسان / أبريل 2003 هذه الأرضيّة لتزيد إليها الأهوال والفظائع. فمنذ 2004 وحتّى الآن لم تنفك الأحزاب الإسلامية عن تقديم مقترحات لفصل الجنسين في المدارس الابتدائية (تقوم نائبة بجولات على المدارس الابتدائية لتوزيع الحجاب على الطالبات) بعد أن نجحت، في الكثير من الجامعات بتطبيق هذا الفصل، ضاربة عرض الحائط بتظاهرات الطلبة الرافضة له.
ترافق كل هذا بدأب وسائل الإعلام في هذه الأحزاب، من صحف وفضائيات، على حثُّ المرأة من دون كلل على الحجاب. "عفافكِ يا فتاة.. هو طُهرك" وهو شعار مجتزأ من "دعوة" مطوّلة ليس فقط إلى الحجاب، وإنما لتعديل شكله بحيث يغطّي أغلب الوجه، علاوة على لافتات تحريم "التبرّج" التي تنشر في كلّ مكان، حتّى وصلت إلى حرم أعرق جامعات العراق مثل جامعتي المستنصرية وبغداد.
وبطبيعة الحال، لا يُمكن فصل خطاب رجال الدين الذين أخذت الشاشات تنقل محاضراتهم عن هذه الظاهرة. فبالإمكان رصد مئات المحاضرات التي تتحدّث عن فصل الجنسين، وإلزام المرأة بالتشبّه بـ"أخلاق" زوجات النبي والصحابة، والحثّ على تزويجهن بعمرٍ صغيرة، والعمل على تشريع "قانون الأحوال الشخصيّة الجعفري" الذي يسمح بزواج الفتاة عند بلوغها تسعة أعوام هلاليّة، ويُخضع القانون المرأة لرغبات زوجها كون المعاشرة الزوجية "حق أصيل"، ويحوّل القانون الزواج من "رابطة للحياة المشتركة"، إلى عقد نكاح شرعي فقط!
لا تبدو نتائج هذه المفاهيم المفروضة على المجتمع من الأعلى بقوّة السلاح و/أو بقوّة الخطاب، مستغربة أبداً، فالتعاضد بين الديني والعشائري والسلطة السياسيّة أدّى إلى اتساع ظاهرة الزواج المُبكّر، حيث أكدت وزارة التخطيط في العام 2013 أن 23.4 في المئة من النساء العراقيّات تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً، وأن 5.5 في المئة تزوجن قبل سن 15 عاماً. وارتفاع عدد المتزوجين بهذا الشكل لم يكن ليؤدي إلى انفجار سكّاني، كمّا شكى وزير التخطيط الأسبق، وإنما عنى أيضاً تفككاً أسريّاً، وولادة جيل من الأبناء بين آباء صغار مطلّقين لم يخبروا التعامل مع الحياة ليخبروا التعامل مع أبنائهم. وبلغ عدد حالات الطلاق نحو 516.784 خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهو ما يعني أن 20 في المئة من عدد الزيجات قدّ انتهت بالطلاق.
استطراداً، فإن المفاهيم الاجتماعيّة الجديدة التي أخذت تترسّخ داخل المجتمع العراقي لم تنتج عن حاجة المجتمع إليها، ولم تحصل بقرار منه، وإنما كانت سابقاً بفعل سلطة ديكتاتورية. والآن أخذت تُفرض المفاهيم بقرارات وتشريعات وعمل دؤوب لسلطة مشوّهة، لم تعمل على تبشيع السياسة وضرورة ممارستها فقط، وإنما على تحويل المجتمع إلى أكثر الأدوات طواعية من أجل استغلاله للاستمرار في سيطرتها على الغنيمة.
بيد أن النظام الاقتصادي الذي ترسيه السلطة ذاتها، أخذ يتعارض مع شكل الحياة الاجتماعية المنشود وتنميطه الذي تريد فرضه في الحيز العام كما في الخاص. فلم تعد الحاجة الاقتصادية للعراقيين (والشباب منهم الذين يشكلون نحو نصف المجتمع) تسمح للرجل وحده بأن يكون عاملاً، وهو ما يُجبره على الرضوخ لخروج المرأة للعمل، كما أن تفشّي حالات الطلاق وتناول تبعاتها في الحكايات اليوميّة، وصعوبة توفير متطلّبات الحياة الزوجيّة، تدفع شبّاناً إلى عدم الركون للقبول بزواج مُبكّر. إلى ذلك كله يُضاف دخول التكنولوجيا إلى المجتمع وتعرّفه على الحياة اليوميّة للمجتمعات الأخرى، ما يدفعه إلى البحث عن تكوين شكل اجتماعي آخر غير ذاك الذي يُراد له التحرّك فيه.
صحيح أن واقع الرفض هذا لم يصبح بالحجم الذي يمكن أن يكوّن انقلاباً على الواقع المفروض الآن، إلّا أن الصحيح أيضاً أن قوّة الرفض أخذت بالاتساع، وهو ما يجعل السلطة ليست بمواجهة مع رفضها سياسيّاً فحسب، وإنما رفضها اجتماعياً واقتصادياً أيضاً.