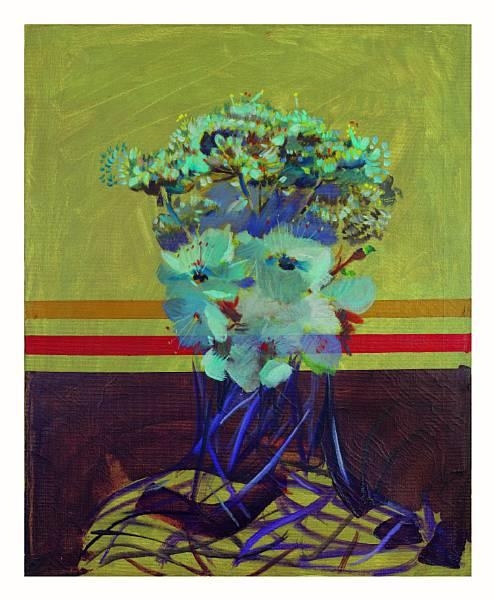لا تكتفي ثيمة "حقوق الإنسان" بأن تستفز الأنظمة الحاكمة في منطقة الخليج وحسب، ولكنها تواصل إثارتها للجدل عندما يعتري الناس، بسطاء الناس وعامتهم، الخوف منها ومن المجهول الذي يقف وراءها.
لِمَ ذلك؟ هل الأمر حقاً إلى هذه الدرجة من الخطر؟
كيف تتحول فكرة نبيلة كالمطالبة بالحقوق إلى شيء مُخيف، يهابه الناس ويتجنبون الحديث عنه؟
هل المسألة مرتبطة بـ "ذات" الفكرة أم بتاريخ تطورها وتاريخ علاقتها بالسياسة، السياسة عموماً، والسياسة التي تُمَارس بشكل أكثر تحديداً في منطقتنا؟ هل هذا الخوف عارض، عابر، آني، بسبب تخويف الأنظمة أم هو خوف متجذر، متصل بعوامل أكثر عُمقاً من الفكرة بذاتها؟
البديهيات
إذا كان صحيحاً أن بني البشر نادراً ما يثقون بالجديد من الأفكار، فإنه من الصحيح أيضاً أنهم يمكن أن يتعلموا من تجارب الشعوب والدول التي آمنت بمنظومة هذه الحقوق، وسيَّلتها على شكل قوانين وتشريعات ناظمة وحافظة لكرامة الإنسان وأمان معاشه. لذا، فالإنسان يملك مقدرة هائلة على تبنّي الأفكار ذات الفائدة المشتركة للإنسانية، خاصة أن هذه الأفكار متصلة ومرتكزة على المنظومة الأخلاقية ذاتها التي لا يُختلف على جدارتها واحتياج البشر لها بوصفها التوازن المعلوم والمُجَرّب للإنسان، لفهم وجوده وعلاقته بوجود الآخرين معه.
نحن نحتاج الحرية والعدالة والمساواة لا لأن شعوباً كثيرة ناضلت لأجلها، ودفعت في سبيل ضمانها الغالي والنفيس، ولا لأن اللغة الأعلى صوتاً اليوم في عالم الإعلام، والسياسة، والأكاديميا، والفن، والتجارة، والاتصال الدولي.. هي لغة تستخدم هذه الكلمات (وإن بشكل غير بريء تماماً ومشوّش في غالب الأحيان)؛ نحن نحتاج لكل ذلك لأجل حياة كريمة تضمن للإنسان العيش بسهولة ويُسر أيضاً. لأجل ألا يحتكر فرد أو قلة صغيرة من الأفراد مصائر بقية الناس، يسيطر ويتحكم بتفاصيل حياتهم وفرص آمالهم وأحلامهم وفق تقلّبات المزاج ورغبات الهوى.
لم تعد ثمة حاجة، اليوم على الأقل، لإقناع صيّاد سمك على سواحل عُمان بأن التعليم حق يستحقه أطفاله. كما أننا لا نحتاج لأدنى جهد لأجل أن يتفق معنا راعي إبل في سهوب نجران في مسألة ضرورية، ولها محوريتها في الحياة كالحق في العمل وبحُرّية تامّة. هكذا، وبكل بساطة، لا يحتاج الإنسان، أي إنسان، لأي حملات منظمة، سواء داخل الجغرافيا التي اتفق على أنها وطنه، أو خارج هذا الاتفاق الجغرافي، ولا ينتظر من أحد لكي يقول له بأن بديهيات كالحق في التعبير والتفكير والإيمان لا تحتاج لأن تأخذ إذناً من جهاز مركزي موجود في مكان ما ليمارس هذه الحقوق ويختبر قدراته الذهنية والجسدية عند فعله لها، وبالتالي، ومن خلالها، يشعر بأنه بخير ويطمئن على آدميته الطبيعية.
السلطة وليس المبدأ
بيد أن المسألة هنا لا علاقة لها بالرغبة والأُمنية البدائية، ولا بمصفوفة الحقوق والواجبات التي تتفق عليها أية جماعة بشرية صغيرة في العالم أو كبيرة، دولة أو منظمة تجمع تحت مظلتها مجموعة من الدول، بقدر ما للمسألة اختصاص ممنهج بالسلطة، السلطة بكل أنواعها ومستوياتها: الاجتماعية والدينية والسياسية.
لعل مفهوم ميشيل فوكو للسلطة بمقدوره أن يسعفنا هنا لمقاربة أثر السلطة العميق والمُخيف على دواخل البشر، فهو يرى بأن "السلطة ليست مؤسسة، كما أنها ليست قوة معينة وُهبت للبعض: إنه الاسم الذي نطلقه على وضعية إستراتيجية معقدة في مجتمع معين"، الكل ساهم في نسج شباكها حتى غدت عائقاً يحول دون الإنسان وتطور وعيه بحقوقه وممارستها بكل يسر وسلام. السلطة التي نستخدمها على أطفالنا عندما يخالفوننا في أمر لا يتناسب ورغباتنا. السلطة التي نتلذذ بفعلها على موظف بسيط في مصلحة عمومية في أقصى قرية في البلاد. السلطة التي نستخدمها لإقصاء فريق كرة أو لعبة شعبية للحي المجاور عن المشاركة في دورة مهملة من التاريخ والأنظار. السلطة التي تُسيّر مشايخ طائفة أو مذهب أو قبيلة ما لتهميش بقية الطوائف والمذاهب والقبائل. هذا النوع من السلطة الذي يتعايش معنا يومياً. هذا الصنف الذي نُربّيه ويتناسل برعايتنا حتى يغدو نظاماً مُحكَم البنيان، يتصاعد ويتضخم في الحجم، والقوة، والانتشار، والتأثير، يصبغ الدولة بصبغته، نبثه في قوانيننا وتشريعاتنا وأحوالنا الشخصية. من هذا النوع البسيط، غير المحسوس جداً، يبدأ المشكل الإنساني في وجه الوعي بالحقوق.
الداخل وضغطه
منذ منتصف الخمسينيات، على الأقل منذ أن أصبح النفط العصا الغليظة التي تتكئ عليها الأنظمة الحاكمة، رأينا كيف أمكن للإنسان في المنطقة، وبشكل فصيح ومثير للدهشة، التنازل عن استقلاله الفردي، وبالتالي عن حريته، في سبيل أن تقوم السلطات بأدوار أساسية لتسيير وتيسير حياته، تسييراً يكفل الاستدامة وتيسيراً يضمن الكرامة بحسب ما يتمنى ويأمل. غير أنه اكتشف بعد خمسين سنة من ذلك التنازل المفتوح، وعلى بياض، أنها ــ أي تلك السلطات ــ حوّلته إلى أداة استعباد لها، بدلا من أن تكون أدوات تحرر واستقرار له.
كل شيء بسيط تم ربطه بسلطة مركزية ما: من الميلاد حتى الوفاة. لا يُعترف بك كإنسان كامل الأهلية إلا بورقة "شهادة الميلاد"، وهذه الورقة بالذات هي ما تُبنى عليها كامل أهليّتك: جواز سفرك، بطاقة هويتك "الوطنية" أو جنسيتك، بيت تسكن فيه، فرصة لتتعلم القراءة والكتابة، مشفى لتعالج ما داهمك من أمراض وحوادث، عمل بسيط، باب رزق يسير يكفيك عن حاجة الناس، وهكذا... فأنت لا أحد بدون هذه الأوراق. قيمتك محل نظر وتقدير، وجودك محل أخذ ورد. من يُقرر هذه القيمة: سلطة مركزية واحدة. والتي "لم تعد أوراقاً شكلية بل مادة للتمييز" على حد قول حنة آرنت: تمييز اجتماعي وسياسي واقتصادي.
الاعتراض هنا ليس على الدور الوظيفي الذي تقدمه هذه الأوراق في حصر وتنظيم حركة الأنفس وتفاعلاتها اليومية في الحياة. بل على تحولها (الأوراق الثبوتية) إلى أدوات تعذيب وعقاب واستئصال تمارسه السلطات الخليجية اليوم، وبكل برود بحق الناس المُختَلف معهم من مواطنيها كسحب الجنسيات، المنع من السفر، ناهيك عن الإهمال المتقصد لقضايا الأشخاص عديمي الجنسية، الذين يتزايد عددهم وتتعمق في داخل أجيالهم أكوام من الكراهية جراء النبذ والحرمان.
المعتقد بدوره لم يسلم من مأسسة سلطوية. انتقل من كونه شأناً خاصاً، حميمياً يوفر للإنسان أماناً وسكوناً روحياً، غير مكترث لمكاسب عامة، وتوازنات جمعوية متغيرة، فإذا به يتحول إلى مؤسسة. هذه المؤسسة تراقب وتبث رؤية أحادية، جامدة، جاهزة، موجهة لعقول الناس، متحكمة بوعود النعيم وإنذارات الجحيم. أنتج كل ذلك خطاباً متسلطاً، يرفض الفردانية، بل ويشيطنها. يفرض الوصاية على العقول، وقدرتها على فهم العلاقة بين الخلق والخالق. حتى غدت الدولة (بمفهوم الحكومة هنا) تُبرّر لأجهزتها التدخل في مسائل الضمير، ومن الباب الواسع، ربما خوفاً من يقظته، وربما حرصاً على ترويضه.
الأسرة، ومن ورائها القبيلة، هي أيضاً تم ربطها ربطاً مُحكماً بالسلطة المركزية. تدور في فلكها، ولا تكاد تُقيم لنفسها وزناً وقيمة بدون القيمة التي تسبغها السلطة عليها. تمت إعادة إنتاج مفهوم جديد للقبيلة والقبلية. مفهوم يرتكز على الولاء للسلطة، لا الوفاء للوطن وجماعته المتمثلة في المواطنين.
في بيئة كهذه، تاه الإنسان عن إدراكه الفطري لحقوقه البدئية الفطرية. أصبح رهينة منظومة متشابكة المصالح، تبسط تأثيرها على وصوله الآمن والبسيط لفكرة حقوقه الأساسية، وبالتالي اختبارها بالممارسة، وإن تعذرت فبالمطالبة، فإن استعصت فبالنضال.
الخارج وأثره
هل ينتظر الفرد الذي يعيش في منطقة الخليج من المنظمات الحقوقية الدولية (المستقلة منها على الأقل) أن تقوم بتعريفه بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبالطبع بحقوقه المدنية والسياسية؟ في نظر الغالبية قد لا يحتاج لهذا الأمر. لكنه في الوقت ذاته أيضاً، فإن مناهج التعليم التي علّمته وتعلّم أجياله الحالية تفتقر إلى الجرعة الكافية من مبادئ حقوق الإنسان بشكلها المبسط والعميق والذي يربط وعي الفرد بمنظومة الأخلاق الإنسانية الكلية.
هذا الفرد، كذلك، واقع تحت تأثير خطاب إعلامي يُخيفه من الاقتراب من ثيمة "حقوق الإنسان" بل ويربطها بكل خراب حلّ بدول الجوار. كما أن عقله مستعد لقبول نظريات المؤامرة التي تحاك ضده وضد دينه ومذهبه وطائفته وعرقه ووطنه، وقائمة التخويف هذه تبدأ ولا تنتهي.
هذا الفرد، أيضاً، لا يستطيع التصريح بالمطالبة بهذه الحقوق وبصوت مسموع ومنظم. لا لأنه غير واعٍ بها، ولا لأنه غير محتاج لها بالضرورة، بل لأنه لا يأمن غضب حكومته، وعواقب تصنيفه من طرفها كمناوئ لها ولمخططاتها المستقبلية "الخيرّة" بالضرورة. ولا يستطيع أن يطلب من نقابته، إن وجدت، أن تعلن موقفاً صريحاً من ذلك. وبالطبع لا وجود لحزب ينوب عنه في هذه المطالب في البرلمان. كما أنه لا يستطيع أن يتظاهر أو يعتصم ليُبيّن موقفه هذا، لأن هذا الفعل ــ التظاهر والتجمع وقبل ذلك العمل الحزبي ــ مُجرّم بالقانون.
الخارج ليس نزيهاً بالضرورة. كما أن الداخل ليس مُنزّهاً بالمطلق. لم تكن الدول الاستعمارية الكبرى يوماً ذات سجل مُشرّف في حقوق الإنسان. حكومات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا كانت وما زالت من أكثر دول العالم استغلالاً للبشر وانتهاكاً لحقوقهم ونهباً لثرواتهم وآمالهم وأحلامهم. بيد أن ذلك لم يمنع الإنسان الفرد في هذه الدول من تأسيس هيئات إنسانية سعت إلى خير أناس كثر على هذه الأرض. بدأوا في نطاقهم الداخلي وتعهدوا مبادئهم بالعناية حتى تجاوزوا حدود جغرافياتهم السياسية، إيماناً منهم بأن الإنسان قيمة وجودية بذاته وليس مسألة حدودية. من هذه النقطة على وجه الخصوص يكتسب سؤال "الحقوق" راهنيته في قلب المشهد الخليجي.
الحقوق قضية تستحق اهتمام الإنسان في الخليج اليوم، ليست ترفاً بل حاجة، ليست عمالة مع الخارج بل ضرورة لإنسان الداخل. الصورة الذهنية عن دول الخليج في خيال العرب والعالم: موشّاة بالنفط والرفاه والوفرة، هذه الصورة ليست صحيحة، بمطلقها على الأقل.
السجون مليئة بشباب لم يحملوا سلاحاً ولم يدعوا إلى عنف. المحاكم تضج بقضايا المدعي فيها الحكومات والمدعى عليهم مواطنون، جُرمهم أنهم كتبوا مشاعرهم ورؤاهم في تغريدة أو كلمة أو صورة في وسائل التواصل الاجتماعي.
السلطات في الخليج اليوم لا تتوانى عن ممارسة العنف (المادي والمعنوي) بحق كل من يخالفها في الرأي. هناك: إقصاء لرأي العلم وعدم احترامه، عمّال تهضم أجورهم ويُهدر عرقهم، نساء يعانين من تمييز، أطفال يفتقدون الرعاية الآمنة، بعضهم سجناء سياسيون (وأطفال). أجيال من الشباب تهدر طاقاتها بمستويات هزيلة من التعليم. أصول لثروات طبيعية تنهب من قبل من بيدهم القرار دون حساب أو مراقبة. تراجع لثقافة النقد ورعاية الإبداع الحر، في مقابل شيوع ثقافة المُسلّمات التي تؤمن بالخرافة والـ "ينبغيات" التي تَطمْئن للطقوس المفروضة وفقاً لقوالب الطاعة والولاء والسكوت.
سؤال الحقوق ضرورة لإعادة التفكير في مركزية الإنسان من كل ما يجري من حوله، لأن الإنسان قيمة عليا في ذاته.