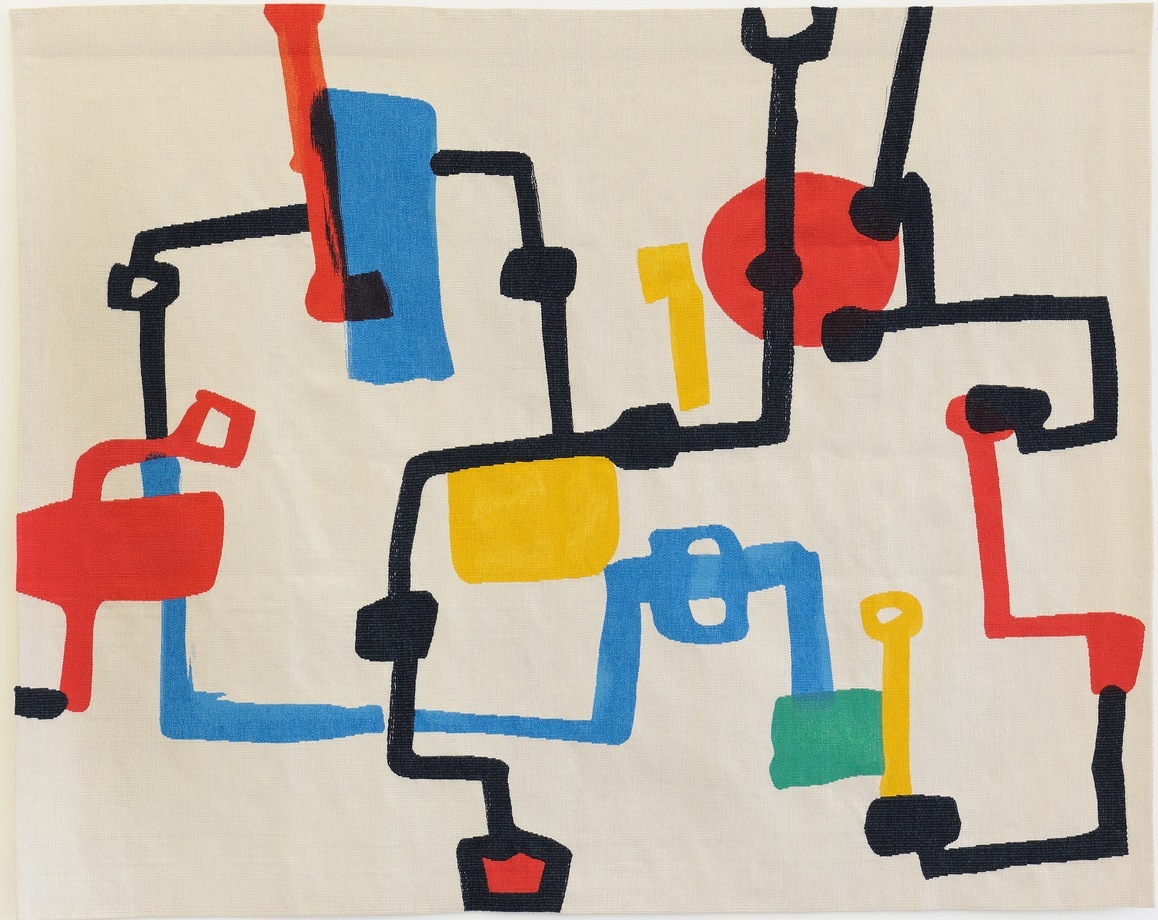قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بعدم التطرق لموضوع السقف الإنتاجي، أو، في واقع الأمر "لا ـ قرارها"، في اجتماعها الأخير مطلع الشهر الجاري، وجّه رسالة واضحة للسوق أنّ المنظمة نفضت يدها عملياً من أي محاولة للتأثير، وبالتالي أصبح المجال متاحا للدول الأعضاء أن تنتج ما تشاء وبكل ما يعنيه ذلك من انعكاس على الأسعار التي تراجعت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى سعري خلال السبع سنوات المنصرمة.
خطوة الأوبك هذه تبدو وكأنها اعتراف جاء متأخرا 33 عاما بأنه لا يمكنها التحكم في الأسعار عن طريق السيطرة على الإنتاج. ففي العام 1982، اعتمدت المنظمة لأول مرة نظام السقف الإنتاجي وهو 16 مليون برميل يوميا، وفي العام التالي، ولمزيد من الضبط، قامت بتخصيص حصة لكل دولة عضو بما يسمح بتحقيق معدل سعري متفق عليه. لكن ذلك الترتيب قام على أساس تخصيص الحصة الأكبر للسعودية لتصبح المنتج المرجِّح الذي يرتفع بإنتاجه ويخفضه وفق حاجة السوق لتحقيق السعر المستهدف. عدم التزام الدول الأعضاء بحصصها المعتمدة، وتدفق الإمدادات من خارج أوبك، دفع بالسعودية إلى التخلي عن لعب هذا الدور بصورة رسمية، ولو أنّ المنظمة ككل ظلت ملتزمة بسقف إنتاجي.. على الورق. ومنذ العام 2011 ظل هذا السقف في حدود 30 مليون برميل، ولو أنّ الإنتاج الفعلي تجاوز هذا السقف بأكثر من مليون ونصف المليون برميل يوميا.
وعلى الرغم من التراجع الكبير في سعر البرميل مقارنة بالقمة التي وصلها وهي 115 دولارا، إلّا أنّ الرياض دفعت المنظمة إلى اتباع استراتيجية الحفاظ على نصيبها في السوق، بدلا من الدفاع عن الأسعار التي ترى أنها عملية خاسرة، لأن أي خفض إنتاجي تقوم به أوبك سيتم التعويض عنه من قبل المنتجين الآخرين من خارج المنظمة. وقد لخص وزير النفط السعودي خطته بالقول إنّه مستعد للمشاركة في أي خفض إنتاجي متى التزم المنتجون الآخرون من داخل وخارج أوبك بالخفض كذلك. وفي غياب مثل هذا الالتزام، فمن الأفضل للمنظمة أن تستمر في ضخ الإنتاج حتى ولو تراجع سعر البرميل إلى 20 دولارا، وذلك للحفاظ على نصيبها في السوق كما أنّ تراجع الأسعار سيساعد على نمو الطلب.
نجاح جزئي
هذه الإستراتيجية حققت أهدافها جزئيا. فوفقاً للرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية، فإن الطلب على النفط حقق هذا العام أعلى زيادة له في عشر سنوات، وهي 1.7 مليون برميل يوميا، الأمر الذي جعل هناك فائضا في حدود المليون برميل، ولو أن وضع الأسعار لا يزال مقلقا، وسيستمر كذلك حتى النصف الثاني من العام المقبل على الأقل، عندما يتوقع حدوث تحسن سعري بسبب التراجع الذي يمكن أن يتعرض له الإنتاج الأميركي من النفط الصخري. وهكذا يبدو ليل الأسعار المنخفضة طويلا، بكل ما يعنيه ذلك على المنتجين كلّهم بما فيهم الدول الخليجية الست التي تتمتع بأوضاع مالية أفضل مقارنة بغيرها، لكنها تظل عرضة للتأثر بسبب المكانة المحورية للنفط وعائداته على اقتصادياتها وموازناتها، ولكونها تسيطر على نحو 30 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية وتقوم بثلث الإنتاج العالمي.
فالاقتصادات الخليجية شهدت تراجعا في معدلات نموها هذا العام بلغ 2.3 في المئة، مقابل متوسط نمو بلغ 5.8 في المئة خلال أكثر من عشر سنوات متواصلة بين العامين 2000 و2011.
على أنّ حجم المشكلة ومواجهتها يختلف من دولة إلى أخرى. فالبحرين وعُمان مثلا يحتاجان أن يكون سعر برميل النفط 100 دولار ليتمكنا من تقديم ميزانية متوازنة، والسعودية تحتاجه بحدود 97.5 دولارا للبرميل. وحتى قطر، ورغم ثروتها الضخمة من الغاز وقلة سكانها، إلا أنها تحتاج لسعر 55 دولارا للبرميل، وهذا ما دفعها لتجميد أو وقف العديد من المشروعات (عدا تلك المرتبطة بكأس العالم في 2022). وهكذا فالموازنات الخليجية التي سيتم الإعلان عنها ابتداء من مطلع العام المقبل ستتميز بفجوة واضحة بين الإيرادات والمصروفات، كما قد تشهد خفضا عاما في الإنفاق. ووفقا لبعض الأرقام التي نشرها بنك الكويت المركزي، فإنّ رصفائه في البحرين وعمان وقطر قاموا بترتيبات للاقتراض من السوق المحلية بمبالغ وصلت إلى 29 مليار دولار في النصف الاول من هذا العام. أما السعودية فيتوقع أن يبلغ حجم اقتراضها المحلي 27 مليار دولار بنهاية هذا العام، وذلك في مسعى للتعامل مع العجز في الميزانية الذي بلغ 20 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك اللجوء إلى احتياطاتها المالية لسد ذلك العجز. وفي مواجهة تراجع الإيرادات تعتبر الإمارات من أولى الدول الخليجية التي اتجهت الى إعمال مفهوم رفع الدعم بصورة ما، وفرض ضريبة على المبيعات.
العين على السعودية
تتركز الأنظار على السعودية لأنها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي التي دفعت بإصرار في اتجاه الاستمرار في الإنتاج العالي رغم هبوط الأسعار. ثم إن وضع السوق النفطية المستقبلي لا يزال غير مطمئن، لأن تأثير الاستمرار في ضخ الإنتاج لم يُسهم حتى الآن في إضعاف الإمدادات من خارج أوبك بالحجم المطلوب. ووفقا للتقرير الشهري عن حالة السوق الذي أصدرته المنظمة في العاشر من الشهر الجاري، فإن الإمدادات من خارج أوبك ستشهد تراجعا بنحو 380 ألف برميل يوميا العام المقبل، على أنّ الطلب على نفط أوبك سيكون في حدود 30.8 مليون برميل يوميا، علماً أنّه، ووفقا للتقرير، فإن حجم الإمدادات من الدول الأعضاء في المنظمة بلغ الشهر الماضي 31.7 مليون برميل يوميا.
يثير هذا الوضع الكثير من الأسئلة حول استراتيجية الرهان على عودة السوق النفطية إلى سابق عهدها وارتفاع الأسعار مرة أخرى. ومن المصادفات أنه في اليوم نفسه الذي صدر فيه تقرير أوبك، قامت شركة الاستشارات الأميركية "ماكينزي" بنشر تقرير عن إصلاحات مقترحة للاقتصاد السعودي. وفي واقع الأمر، تتالت التسريبات عن اعتزام السعودية القيام بإجراءات اقتصادية كبرى (ما ذكرته صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية عن اطّلاعها على وثيقة ترسم ملامح هذه التغييرات، وما ذكره الكاتب الأميركي توماس فريدمان عن لقائه بولي ولي العهد الذي حدّثه عن خططه لإعادة تأهيل اقتصاد بلاده بعيدا عن الاعتماد على النفط وعائداته والدفع باتجاه إقامة الحكومة الالكترونية وممارسة قدر اكبر من الشفافية والزام الوزارات والهيئات الحكومية ببرامج محددة لتنجز في أوقات معلومة، كما حملت بعض وسائل الاعلام المحلية أخباراً عن هذه التغييرات المتوقعة).
وشركة الاستشارات "ماكينزي" من الشركات التي استعين بها لوضع برامج هذا التغيير الاقتصادي، وقد قالت إن على السعودية أن تسارع، لتجنب تدهور أكبر خلال الخمسة عشر عاما المقبلة إذا لم تتمكن من مضاعفة الوظائف المتاحة في سوق العمل بثلاثة أضعاف لتجنب ارتفاع نسبة البطالة وتدهور دخل الأسرة وارتفاع حجم الدين الحكومي إلى 140 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. ولتجنب هذا الوضع تقترح دراسة "ماكينزي" استثمار أربعة تريليون دولار في برامج للتدريب ومواجهة قضية البطالة وخفض نسبتها إلى 7 في المئة، بدلا من أن تبلغ 22 في المئة إذا تركت الأمور على حالها، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من 10 في المئة الى 70 في المئة، والاستثمار في مجالات التعدين والبتروكيماويات والصحة والإنشاءات وتجارة التجزئة والسياحة. وكل هذا يقتضي قيام الحكومة بتغيير جذري في عملها من مولِّد مباشِر للإيرادات عبر النفط، إلى مسهِّل لاستثمارات القطاع الخاص.
على أنّه، وبانتظار كل ذلك، فسيظل القطاع النفطي يلعب دوراً محورياً في سياسة واقتصاد السعودية. وحالة عدم الوضوح لا تزال تحيط بهذا القطاع على الرغم من القيام ببعض الخطوات، مثل إلغاء المجلس الأعلى للبترول الذي يترأسه الملك عادة، والاستعاضة عنه بمجلس لأرامكو (يترأسه ولي ولي العهد). ومن القضايا التي تطل برأسها كذلك سؤال من يحل محل وزير النفط الحالي الذي بلغ الثمانين، وهل يذهب المنصب إلى ابن الملك الأمير عبد العزيز، نائب الوزير الحالي، أم سيتم اللجوء إلى الخيار القديم وجعل الوزارة من نصيب شخص من خارج العائلة المالكة؟ ثم هل تُفْصل أرامكو عن الوزارة لتعمل بصورة تجارية ومهنية بعيداً عن حسابات أوبك والسياسة، وهل تتم توسعة الوزارة من الناحية الأخرى لتضم الصناعات البتروكيماوية والكهرباء التي بلغ استهلاكها من النفط 900 ألف برميل يضاف إليها 400 ألف لمحطات توليد تحت الإنشاء، وهذا ما يطرح السؤال القديم المتجدد بخصوص قضية دعم المحروقات ومقدار إمكانية استمرار "دولة الرعاية" في تقديم كل أشكال الدعم الحكومي للقطاعات ولحياة الأفراد السعوديين.
وعندما سئل جوناثان ويتزل الذي قدم تقرير "ماكينزي" ذاك في مؤتمر صحافي، عن التبعات السياسية لرفع الدعم، أجاب أن هناك حاجة إلى "عقد اجتماعي" جديد وضمان وجود المزيد من الشفافية والمساءلة، وهو ما يدفع بقضايا النفط المتشعبة بأبعادها الفنية إلى ساحة السياسة الداخلية بما هي بنية السلطة وطبيعة علاقتها مع مجتمعها..