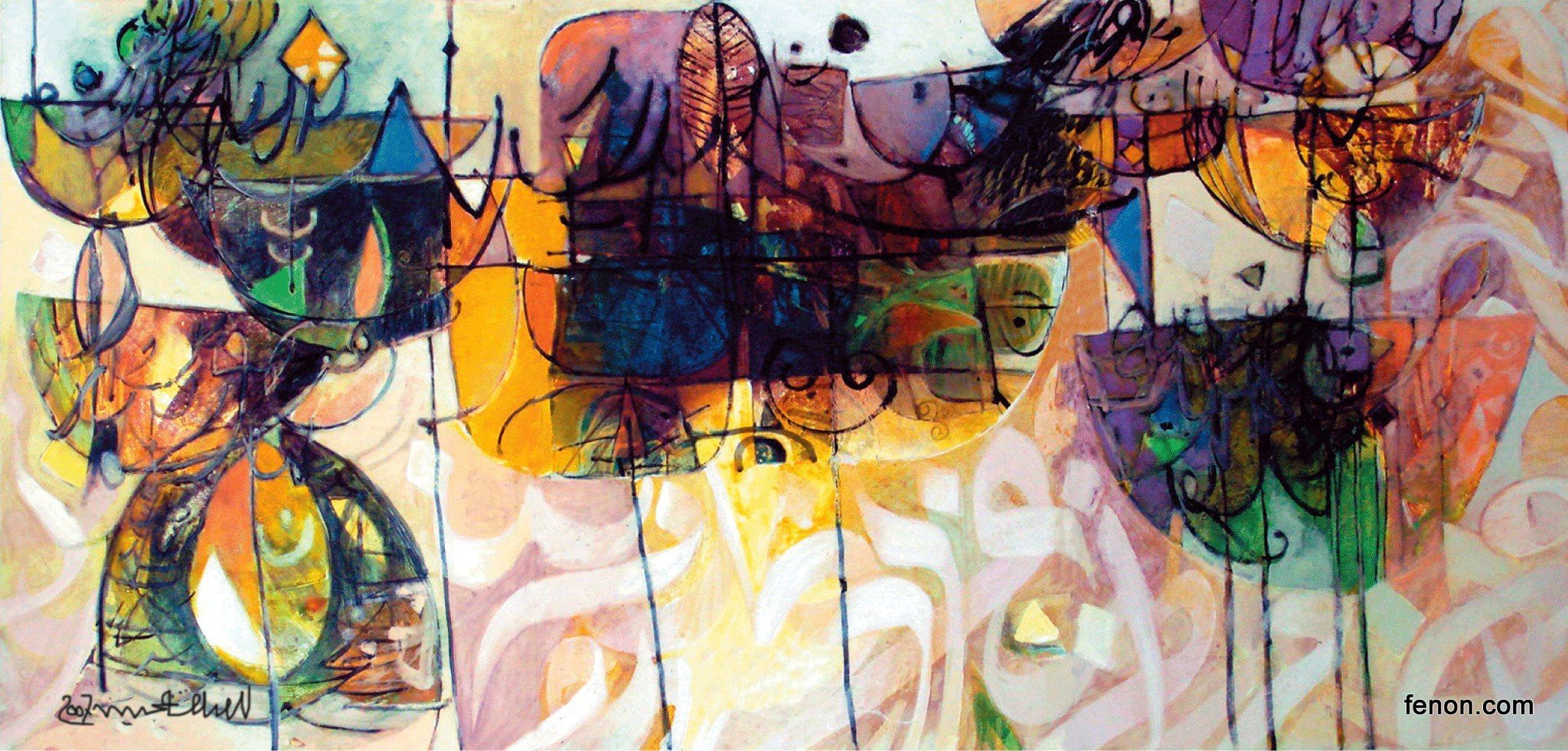بعد أكثر من خمس سنوات على انفصال الجنوب، والصدمة الاقتصادية التي أحدثها بسبب انتقال معظم الاحتياطيات النفطية إلى الدولة الجديدة، توصّلت الخرطوم إلى تفاهم عريض مع بكين يقضي بدخول الأخيرة ميدان الاستثمار الزراعي، ابتداءً بإعادة إحياء "مشروع الجزيرة"، وزراعة 450 ألف فدان، وبتوفير شريك استراتيجي يساعد السودان على استغلال موارده الطبيعية.
تجربة نموذجية لبكين
كانت الصين الشريك الرئيسي الذي ساعد السودان على تحقيق اختراق في ملفّ النفط في عقد التسعينيات من القرن الماضي، والانضمام بذلك إلى نادي الدول المصدِّرة، بعدما عانى من رفض الشركات الغربية العمل في صناعة النفط السودانية بسبب توتّر علاقات الخرطوم مع الدول الغربية. الصين اعتبرت مشروع النفط السوداني فرصة لها لتأكيد قدراتها الهندسية والإدارية على بناء المرافق الأساسية في صناعة النفط، من تجهيز الحقول ومحطّات المعالجة وخطوط الأنابيب وغيرها.. في بيئة غير مؤاتية سياسياً واقتصادياً، ومع غياب تام للبنية الأساسية. وحدث ذلك في وقت قياسي، ما جعل تجربتها نموذجاً ساعد على فتح أبواب القارة الإفريقية أمام بكين.
في العام 2012، وعقب انفصال الجنوب، زار وزير الخارجية السوداني وقتها الصين في مسعى لوضع العلاقات الثنائية في إطار جديد بالتركيز على الجانب الزراعي. لكن وعلى الرغم من تتالي زيارات المسؤولين السودانيين، وخاصة وزير الزراعة الأسبق والرئيس البشير نفسه، لم يحدث اختراق رئيسي. ولعل الديون الصينية السابقة على السودان (من فترة العمل على الملف النفطي) وكيفية تسديدها شكلت عقبة. فرغم غياب المعلومات الرسمية، إلا أن التقديرات تشير الى ان الصين قدمت ما لا يقلّ عن خمسة مليارات دولار في شكل قروض يفترض أن يتم تسديدها عبر شحنات نفطية بعد فترة سماح متفق عليها. لكن ذهاب معظم الاحتياطيات النفطية إلى دولة جنوب السودان الجديدة جعل من الصعب على الخرطوم الوفاء بتعهداتها تلك.
عوامل متغيّرة
بمرور الوقت، بدأ بعض التغيير في الموقف الصيني بسبب بروز عاملين جديدين: أولهما استعداد الخرطوم لفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي، بما في ذلك منح الأراضي القابلة للزراعة لآجال طويلة وإسباغ رداء من السرية على الاتفاقيات التي تبرمها مع المستثمرين الأجانب، وخاصة الدول، وإعطاءها قدراً من الحصانة. وتعتبر الاتفاقية الإطارية التي أبرمت هذا العام مع السعودية نموذجاً في هذا الصدد إذ تعطي الرياض حق استغلال مليون فدان في منطقة نهر عطبرة وأعالي ستيت لمدة 99 عاماً، وهي الاتفاقية التي أجازها البرلمان دون التدقيق في أبعادها والكشف العلني للبنود التي قامت عليها.
أما العامل الثاني فيتمثل في تعيين الدكتور عوض الجاز مساعداً لرئيس الجمهورية مسؤولاً عن ملف العلاقات مع الصين. ويعتبر الرجل من مهندسي العلاقات السودانية الصينية، إذ كان وزيراً للنفط، وفي عهده (الذي استمر أكثر من 15 عاماً) تمكّن من إلحاق السودان بنادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط ونجح في نسج علاقات متميزة مع مختلف دوائر السلطة في الصين، إضافة إلى كونه فاعلاً في مطبخ السلطة الذي يضع سياسات الحكم ويتابع تنفيذها. ومن موقعه هذا، فهو سيتمكن من التنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية وتخطّي العقبات الإدارية.
الشهر الماضي، زار وفد صيني كبير السودان بقيادة وزير الزراعة، وفي صفوفه عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصينية العاملة في ميدان الزراعة مثل "أكاديمية شاندونق للعلوم الزراعية" و "مركز أبحاث القطن" و "أكاديمية الميكنة الزراعية وأبحاث القمح".. وسجل الوفد زيارة ميدانية إلى مشروعي الجزيرة والرهد، حفلت بالكثير من الخطب والحديث العمومي عن خطة خمسية حتى العام 2020 وإقامة حديقة للنسيح عبر زراعة القطن بداية على مساحة 450 ألف فدان تتوسع إلى مليون فدان، بضم مشروع الرهد إلى الجزيرة، التي شكّلت في وقت من الأوقات عماد الاقتصاد السوداني كونها تعتبر أكبر مزرعة في العالم تحت إدارة واحدة، إذ بلغت مساحتها في ذروة نشاطها 2.2 مليون فدان.
مشروع الجزيرة لا يحتاج إلى كبير عناء بسبب طبوغرافية المنطقة التي تسمح بالري الانسيابي، ولو أنه يحتاج إلى تأهيل للقنوات والآليات الزراعية مع إقامة مصانع للنسيج والزيوت وغير ذلك من صناعات تكاملية. لكن حتى الآن تغيب الكثير من المعلومات خاصة بما يتعلق بمدى مسؤولية الصين والالتزامات التي عليها الوفاء بها، وأهمّ من ذلك بخصوص نوعية العلاقة مع المزارعين، وإذا ما سيكونون شركاء أم أجراء، علماً بأن نسبة كبيرة من أراضي المشروع تعتبر ملكاً حراً للمزارعين، أو أنهم كانوا يزرعونها لزمن طويل.. وكذلك هناك أسئلة حول مدى ما سيكون لديهم الخيار في اتباع النموذج الزراعي الذي ستقرّره الصين أم سيكون لهم زراعة ما يرغبون به. كذلك لم تتضح بصورة دقيقة حدود ومسؤولية الجانب الحكومي وشكله، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الإدارية، فهذا استثمار دولة يحتاج إلى وجود رسمي من قبلها في الجانب المقابل كي تتوازن المعادلة.
نقاط سلبية
بعض الباحثين في الميدان الزراعي أشاروا إلى نقاط سلبية عديدة لا بد من وضعها في الاعتبار والتحلي باليقظة. ومن ذلك أن الشركات الصينية لا تتمتّع بتقاليد في ميادين مثل الشفافية والاهتمام بالبيئة وتطبيق أفضل السياسات والخيارات، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب واسعاً لأضرار بيئية واقتصادية وتنامٍ للفساد، لأن التركيز سيكون على تحقيق الربح في المقام الأول، دون الاهتمام الكافي بتدريب عناصر بشرية من السودانيين لتتولى إدارة هذه المشروعات. كما أنّ الصين تسعى إلى تكثيف وجود عمالتها حتى في المجالات التي يفترض أن تُترك للعمالة المحلية.. هذا إلى جانب ضعف إحساسها بقضايا المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
مثل هذا النقد وجد طريقه إلى صفحات الصحف، بل إن البعض كتب بصورة واضحة وجلية أنه في غياب المعلومات التفصيلية عن آفاق وعناصر الاتفاقيات المبرمة مع الصين، فإنّ الباب انفتح واسعاً أمام الإشاعات والتأويلات المختلفة، وأنّ الصين ستعمل من خلال مشروعها الزراعي هذا في الجزيرة على وضع يدها على المشروع واسترجاع الديون التي لها على السودان. وحذّر البعض من أنّه إذا صدق جزء صغير من هذه الإشاعات، فإنّ إحدى أكثر مناطق السودان استقراراً ستكون معرّضة إلى فتنة واندلاع نزاع على ملكية الأرض وكيفية التصرف فيها، وسيتزايد الإحساس بالغبن لأن مشروع الجزيرة لم يستفد من المليارات التي حصلت عليها الحكومة إبان فورة النفط وهو يصبح الآن مطالباً بأن يسدّد ديون تلك الفترة.
على أن لكلّ من السودان والصين أجندته الخاصة في الدفع بهذه العلاقة. فالسودان الذي لا يزال يعاني من آثار الصدمة الاقتصادية لانفصال الجنوب ومن المقاطعة الاقتصادية الغربية، يحتاج إلى شريك مثل الصين يمكن أن يقدّم الكثير، بينما الصين ومن باب التجربة السابقة من خلال النفط، ترى في السودان مدخلاً لبقية القارة الأفريقية، وأنّه من خلال موارده الطبيعية الهائلة يمكن أن يوفّر للشركات الصينية ميداناً خصباً للاستثمار في المواد الأولية، خاصة في ميدان توفير الغذاء الذي أصبح هماً مقيماً للكثير من الدول.
لكن يغيب عن هذا التوجّه حتى الآن عنصر المواطن العادي المستفيد أو المتضرّر الأول من هذا الاستثمار. بسبب الغموض الذي يلفّ الاتفاقيات المبرمة وأهم من هذا في كونه شريكاً أصيلاً له الحقوق والواجبات كافة. فالتجارب التنموية التي لا تضع الإنسان والبعد الاجتماعي في قلب حركتها ينتهي بها الأمر إلى تردٍ اقتصادي يضيف عنصراً جديداً إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن هناك حركات نشطة حول العالم ناقدة ومتابعة لكيفية التصرف في الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب، ويمكن للسودانيين أن يتأثروا بها.