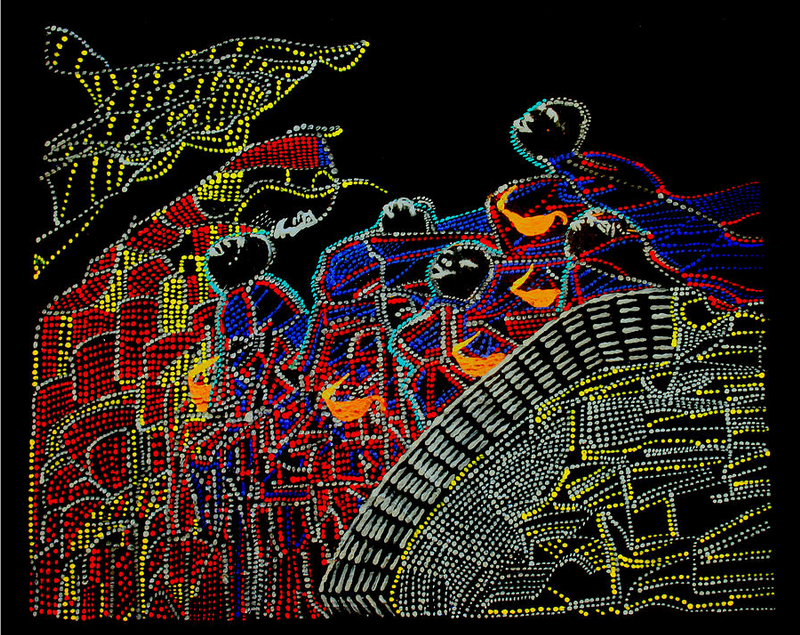أصبح من المؤكد ان رئيس جنوب السودان سيلفا كير لن يحضر حفل إعادة تصدير أول شحنة من بترول بلاده عبر ميناء بشائر السوداني، عندما تكتمل الترتيبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انقطاع عن الأسواق العالمية اثر قرار حكومته وقف انتاج النفط في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي. ولكن، هل أن هناك حفلا اصلا أو أي تصدير؟ اليوم، تتسابق القطيعة المتجددة والتسوية على قاعدة المصالح.
النزاع بين السودانَين حول قضايا نفطية على رأسها رسوم العبور، الى جانب أسباب أخرى مثل ترسيم الحدود، ومنطقة أبيي، واتهامات بدعم تمردات مسلحة... كاد أن يؤدي الى حرب مباشرة بين البلدين من قبل. ومع انه تم تجنبها في النهاية، الا ان عوامل التوتر لا تزال قائمة، وتعبر عنها حروب بالوكالة واستخدام المتمردين في البلدين كورقة ضغط على الآخر، والتوجه نحو المقاطعة أحيانا. وهناك في أحيان أخرى انقلاب في اتجاه عكسي، والعمل على تطبيع العلاقات في إطار المصلحة المشتركة بين البلدين، وأبرز مكوناتها الصناعة النفطية، حيث يحتاج جنوب السودان الى مرافق البنية التحتية للصناعة الموجودة في السودان، من مراكز معالجة وخطوط أنابيب وموانئ تصدير لإيصال نفطه الى الأسواق العالمية، كما يحتاج السودان الى نفط الجنوب.
يصدّر لا يصدّر
رغم اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وأبرزها الاتفاقية الخاصة بالمجال النفطي، الا ان التجاذب السياسي والهم الأمني طغيا على أي اتفاق، ، وهو ما عبر عنه الرئيس عمر البشير الشهر الماضي عندما وجه رسالة الى جوبا إثر تحرير القوات المسلحة السودانية منطقة أبو كرشولا في جنوب كردفان، التي سيطر عليها متمردو «الجبهة الثورية» لبضعة أسابيع، بضرورة رفع يدها عن دعم المتمردين، والا فإنّ الخرطوم ستمنع مرور نفط الجنوب عبر أراضيها نهائياً. وهو ما تم الإعلان عن تنفيذه مطلع هذا الشهر، اللهم الا إذا تدخل الوسطاء وفي مقدمتهم الاتحاد الأفريقي خلال فترة 60 يوماً كما تنص الاتفاقية، وتوصلوا الى ترتيبات نهائية ملزمة للطرفين، تسمح بإعادة تصدير نفط جنوب السودان عبر جارته الشمالية. وإذا تمّت تلك التفاهمات وعاد نفط الجنوب للتدفُّق عبر ميناء بشائر، ففي ذلك إشارة الى أنّ اتفاقيات التعاون تلك نجحت في الصمود ووضعت أساساً لتعاون مشترَك بين البلدين يمكن أن يؤسس لقاعدة من المصالح تمثل خطاً دفاعياً أمام التقلّبات السياسية.
لكن بسبب تاريخ طويل من عدم الثقة، فإنّ جوبا لا تزال تتفحّص خياراتها بشأن إيجاد منفذ آخر لصادراتها النفطية لا يمر بالسودان، لتتحرّر من ضغط الخرطوم. وكانت حكومة جنوب السودان، وإثر وقفها لإنتاجها النفطي مطلع العام الماضي، قد وقّعت مذكرات تفاهم مع كل من كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، بشأن بناء خطَّي أنابيب، يذهب الأول الى ميناء لامو على الحدود الشرقية لكينيا، بينما يخترق الثاني أثيوبيا، وهي نفسها دولة مغلقة مائياً، ليعبر الى جيبوتي ومن ثم الى الأسواق العالمية.
في انتظار دراسات الجدوى
لكن تلك كانت مجرّد مذكرات تفاهم تحتاج الى الكثير لتحويلها الى دراسات جدوى قابلة للتنفيذ، بعد تفحُّص مختلف العوامل، من المسار المقترح لكل خط، والتكلفة، والجهة التي ستقوم بالتمويل... وهو ما لم ينجز حتى الآن. بل إنّ تناوُل هذه القضية يبدو انه يتم في إطار الاستهلاك السياسي أكثر مما هو مشروع جاد.
فقبل انفصال جنوب السودان وقيامه دولة مستقلة، أعلنت شركة تويوتا اليابانية أنها بصدد إعداد دراسة لنقل نفط جنوب السودان للتصدير عبر كينيا. وفي نيسان/أبريل من العام الماضي، قام سيلفا كير بزيارة الى الصين كان أبرز ما فيها أن المسؤولين الصينيين رفضوا طلب جوبا الإسهام في تمويل وبناء الخط، وأنهم كما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» وقته، قالوا إنهم أسهموا في بناء خط أنابيب في السودان وعلى جوبا استخدامه.
وفي الشهر ذاته، أعلن باقان أموم كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان ان شركة تويوتا أكملت دراسة الجدوى لإنشاء الخط الذي يمر عبر كينيا، وأنها ستتقدّم قريبا بعروض مالية لكيفية التمويل وطريقة بناء الخط ومساره. لكن بعد عام وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان، برنابا ميريال بنجامين، ان الحكومة قامت بالتعاقد مع الشركة الألمانية IFC Consulting Engineers لإعداد دراسة جدوى لإنشاء خط أنابيب لتصدير نفط جنوب السودان عبر ميناء لامو الكيني. موقع الشركة الإلكتروني يقول إنها حصلت على العقد للقيام بدراسة لمختلف خيارات التصدير وتحليلها من الجانبين الفني والاقتصادي، لكن بدون تحديد أي إطار زمني للفراغ من هذه الدراسة. وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن وزير التجارة، قرنق ديينق، ان الرئيس سيلفا كير استقبل وفداً من شركة تويوتا التي ستقوم ببناء خطي الأنابيب الى ميناء لامو! وأيضاً لم تحدد التكلفة وكيفية التمويل أو مواعيد البداية الفعلية للعمل.
تفيد التقديرات العامة والأولية، أن كلَا الخطين المقترحين، عبر كينيا أو إثيوبيا وجيبوتي، سيكلف الواحد منهما ما بين ثلاثة الى أربعة مليارات دولار، وربما يستغرق ما بين عامين الى ثلاثة اعوام لاستكمال الإنشاءات. لكن ذلك يعتمد في الأساس على القيام بدراسة جدوى تفصيلية تحدد مسار الخط وكيفية تجاوز العقبات الطوبوغرافية، حيث توجد في بعض الأماكن ارتفاعات تصل الى قرابة 2000 متر فوق سطح البحر، وأحياناً مستنقعات. وأهم من ذلك كيفية حسم التعويضات للأرض التي سيمر عليها الخط، وملكية هذه الأراضي أصبحت قضية حساسة وترتبط بالتعويضات التي لا بد من الاتفاق بشأنها مع المجموعات السكانية القاطنة في تلك المناطق. وهناك عنصر التكلفة ومن يتحمله وكيفية التسديد وهل يتم ذلك للشركات المنفذة للمشروع أم تتولاه الشركات النفطية التي سوف تستخدم الخط. ثم هناك البعد الاستراتيجي حيث تفضل بعض قيادات جنوب السودان مرور الخط بإثيوبيا حتى يمكنها كسب أديس أبابا الى صفها في نزاعها المستمر مع الخرطوم.
هل يستحق العناء؟
وهذا ما يقود الى السؤال المحوري حول حجم الاحتياطيات النفطية الموجودة في جنوب السودان، واذا ما كانت كافية للدرجة التي تجعل من المجدي القيام ببناء خط أنبوب والإنفاق عليه. ووفقاً لتقديرات متتالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإنه ما لم تتم اكتشافات نفطية جديدة أو يحدث تحسن ملموس في نسبة استخلاص النفط المستخرج، فإن المخزون الموجود حالياً يكاد يكون قد بلغ قمته، وسيبدأ في التدهور في غضون ستة أو سبعة أعوام. وبالفعل، بدأت مؤشرات هذا التدهور. هناك تناقص الإنتاج من ولاية الوحدة، وهي أول منطقة بدأ الإنتاج والتصدير منها في العام 1999، حيث بلغ الإنتاج ذروة 350 ألف برميل يوميا العام 2005، ثم بدأ في التراجع الى نحو 150 ألف برميل يوميا عند وقف الإنتاج مطلع العام الماضي. كما ان منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وتوصف بأنها غنية بالنفط، شهدت تراجع انتاجها من 11 ألف برميل يوميا الى أقل من ثلاثة آلاف برميل يوميا. وفي رأي الخبراء، فإن دراسة شاملة من هذا النوع تحتاج الى فترة لا تقل عن خمس سنوات لإنجازها.
المنطقة الواعدة التي يُعتقد أنها تحتوي احتياطيات نفطية جديدة تتركز في مربع (ب) في ولاية جونقلي. ويعود اهتمام الشركات الأجنبية بهذا المربع الى ثمانينيات القرن الماضي، عندما حصل على امتياز العمل فيها كونسورتيوم تقوده شركة توتال الفرنسية، ويضم ماراثون الأميركية وشركة نفط الكويت. لكن بسبب اندلاع الحرب الأهلية الثانية في العام 1983، فإن الشركة جمّدت العمل، مع قيامها بتجديد رخصة امتيازها في العام 2004 ، عندما أصبح واضحا انه سيتم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية، وهو ما حدث في العام التالي.
ثلاثة أسباب وراء التعطيل
طوال السنوات التسع الماضية، لم يحدث تقدم يذكر لجهة الوصول حتى الى مرحلة حفر بئر واحدة لمعرفة حجم المخزون وكمية الإنتاج المتوقعة. ويعود ذلك الى ثلاثة أسباب رئيسية: أولها النزاع القانوني الذي دخلت فيه توتال مع شركة النيل الأبيض التي أقامت شراكة بين الحركة الشعبية (التي تحكم جنوب السودان) وشركة بريطانية صغيرة، وهو ما أدى الى تدخل سياسي في العام 2007، أعيد بموجبه الامتياز الى الكونسورتيوم الذي تقوده توتال. في ذلك الوقت بدأ واضحا أن جنوب السودان في طريقه الى الانفصال ليصبح دولة مستقلة، لذا كان التباطؤ في العمل مفهوما حتى تتضح الصورة سياسيا، مع كل ما يتبع ذلك مع إعادة لترتيب الوضع القانوني للعمل. وثانيا، هناك العامل المهم المتعلق بالوضع الأمني. فولاية جونقلي أصبحت أكثر الولايات التي تعاني من اضطراب أمني في جنوب السودان، خاصة أن مساحة الامتياز كبيرة تبلغ 120 ألف كيلومتر مربع. وتعاني الولاية من نزاعات قبلية متعددة، الى جانب بروز مجموعات متمردة تعمل تحت لافتات سياسية مستهدفة سيطرة الحركة الشعبية على الأوضاع. وبلغت هذه الاضطرابات قمتها الشهر الماضي عندما سيطرت مجموعة يقودها المتمرد ديفيد ياو ياو على الحامية العسكرية في منطقة بوما، وهي للمفارقة أوّل منطقة سيطرت عليها «الحركة الشعبية» عندما كانت تقاتل حكومة السودان في الثمانينيات، ودفعت بتوتال الى تجميد نشاطها للتنقيب عن النفط. الأمر الثالث ان حكومة جنوب السودان قامت بممارسة سلطاتها السيادية وتقسيم مربع (ب) هذا الى ثلاثة مربعات: (أ) و(ب) و(ج)، وأعطت للكونسورتيوم الذي تقوده توتال المربع الأول وعرضت الإثنين الآخرين على شركات أخرى. لكن لم يتبلور شيء. ومع ان توتال لم تصرّح بعد بردّة فعلها على هذه الخطوة، الا انه يبدو من الصعوبة بمكان أن تقوم بمنازعتها على أسس قانونية، وذلك لممارسة جوبا حقوق سيادتها الوطنية، لكن ذلك يُتوقع أن يلقي بظلاله على حماستها للعمل.
لدى الآخرين ايضا نفط
من ناحية أخرى، فإن بناء خط أنابيب لنقل نفط جنوب السودان الى الخارج يحتاج الى أن يضع في حسبانه التطورات التي بدأت تشهدها صناعة النفط في منطقة شرق أفريقيا، حيث تتالت أخبار عن اكتشافات في مجالَي النفط والغاز في كل من أوغندا وكينيا وموزمبيق وتنزانيا ومدغشقر. ويُعتقد أن موزمبيق ستكون أول دولة تقوم بتصدير الغاز وستتبعها تنزانيا. وبرزت شركات عالمية مثل أكسون/موبيل الأميركية، وستات أويل النرويجية، وشركة النفط الصينية العاملة في المياه المغمورة وغيرها، وذلك في إشارة لاستقطاب هذه المنطقة لشركات عالمية.
أوغندا تبدو في وضع أفضل من ناحية حجم الاكتشافات النفطية التي تمت حتى الآن وقامت بها شركة «تللو» البريطانية، التي حققت اكتشافات أقل حجما في كينيا المجاورة. لكن أوغندا مثل جنوب السودان دولة مغلقة، وليس لها منفذ على البحر. الرئيس الأوغندي يركز على ضرورة إقامة مصاف لتكرير النفط بدلاً من تصديره خاماً، وهو ما يجد صدى في جوبا التي وقّعت اتفاقيات لإنشاء مصفاتين صغيرتين لتلبية احتياجاتها الداخلية.
وهكذا يبدو انه الى جانب العوامل الفنية وحجم الاحتياطي والإنتاج المتوقع، التي تثير عقبات أمام الخط البديل الذي تأمل جوبا في إقامته وإنهاء اعتمادها على الخرطوم، فإنّ العوامل السياسية في شرق أفريقيا تثير حساسيات مماثلة، خاصة أن لكل دولة، من كينيا الى أثيوبيا وأوغندا، حساباتها السياسية والاستراتيجية، مما يجعل منفذ نفط جنوب السودان الى الأسواق العالمية عبر السودان أمراً لا مفر منه، في المستقبل المنظور على الأقل.