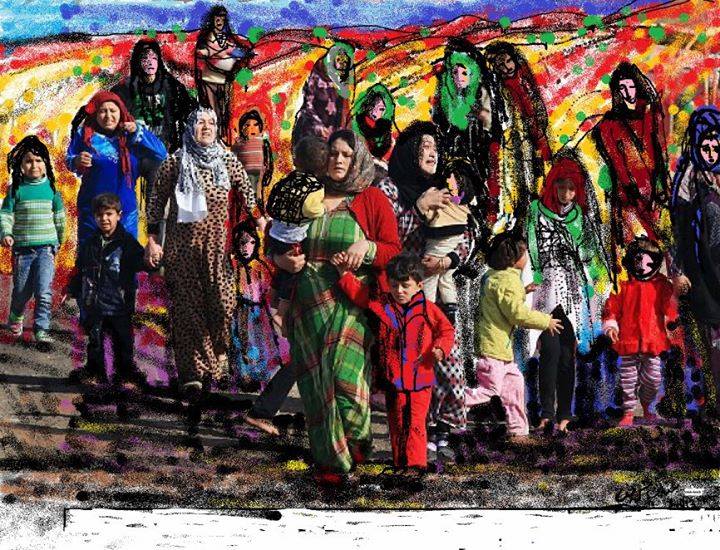غرق العراق منذ سقوط نظام صدّام حسين على يد القوات الأميركية في العام 2003، في موجة عنف ذات بعد طائفي، وفي فوضى سياسية غير مسبوقة. صحيح أن جذور إضعاف الدولة وانهيار المكونات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، تعود (على أقل تقدير) إلى ضربات "التحالف الدولي" بقيادة الأميركيين في العام 1991 والكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الاقتصادي الذي فُرض على الناس، إلا أن العراق لم يكن متشظياً بالمقدار الذي اصبح عليه الآن إلا منذ الغزو الأميركي.
مأسس الاميركيون تلك الحال على قواعد عرقية - طائفية إبان فترة الاحتلال، أرخت بثقلها على كامل المجتمع العراقي، ثم تجسدت في الانقسام الذي طال الأراضي الواقعة جزئيا تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك في حياة أهالي بغداد الذين يعيشون في أحياء انقسمت بين سنة وشيعة. غير أن أحد معطيات هذا الانقسام، والتي تُسقط غالبا من الحسبان، هو البعد الجندري.
استلهام النظام اللبناني!
للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية العراقية في الرابع عشر من تموز 1958، اقترح الاسلاميون الشيعة المحافظون، خلال اجتماع لمجلس الحكم الانتقالي في كانون الأول 2003، إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية على أساس طائفي، بما يحاكي قانون الأحوال الشخصية اللبناني. آنذاك، برر هذا الاقتراح عبد العزيز الحكيم، رئيس "المجلس الأعلى" (أحد الاحزاب الاسلامية الشيعية الأساسية)، الذي وصل إلى السلطة مع القوات الأميركية، بكونه ترجمة لحرية الاعتقاد، التي أمعن النظام القديم في قمعها، بحسب رأيه.
وتعتبر هذه الخطوة في الواقع بمثابة تأكيد على الطابع الشيعي للهوية العراقية الذي تطالب به مجموعة سياسية عانت من قمع النظام القديم. وهكذا فإن قانون الأحوال الشخصية رقم 188، الذي وضع في العام 1959 ليحكم الشؤون الخاصة (زواج، ميراث، طلاق، الخ) ومن ضمنها معظم التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، لن يطبق بعد الآن بطريقة موحدة على جميع المواطنين العراقيين، بل سيُضاف إليه قانون خاص بالشيعة يمهّد الطريق أمام كل طائفة (مجموعة) للمطالبة بقانون خاص بها.
في العام 1959، تمت المصادقة على القانون 188 الذي اعتبر من القوانين الأكثر تقدمية في المنطقة بما يخص حقوق المرأة. أتى ذلك كمحصلة لجهود الحركة النسوية العراقية، وحراك "رابطة النساء العراقيات" تحديداً، ومن وجوهها نزيهة الدليمي، المناضلة الشيوعية البارزة وأول وزيرة عربية (في 1959) التي شاركت في صياغته.
المساواة في الميراث
كان قانون الأحوال الشخصية يضمن المساواة في الميراث، وهو ما كان (ولا يزال) عاملاً فريداً في قانون أسهم بوضعه مع السلطات العراقية علماء سنة وشيعة. لقد ولدت الجمهورية العراقية الأولى برئاسة عبد الكريم القاسم في مناخ كانت فيه الثقافة السياسية المهيمنة هي تلك اليسارية المعادية للامبريالية، وتحديداً تأثير الحزب الشيوعي، حيث كانت منظماته النسائية ناشطة جداً.
وعليه، فقد أتى وضع قانون جديد للأحوال الشخصية ليمارس قطيعة مع هذا الإرث التقدمي والثوري والمعادي للرأسمالية الذي قُدِّم للناس عبر قانون الأحوال الشخصية.
لم يدخل اقتراح رئيس المجلس الأعلى في العام 2003 حيّز التنفيذ، لكنه استعيد في إطار البند 41 من الدستور الذي صودق عليه في العام 2005. ومؤخراً، وعلى هامش الانتخابات البرلمانية، كرّر حزب "الفضيلة" الشيعي مطلب إخضاع قانون الأحوال الشخصية للفقه الجعفري حصراً. وهذا الفقه يسمح، من ضمن أشياء أخرى، بزواج الفتيات بدءا من سن التاسعة، باعتباره سن البلوغ.
استنكرت النساء العراقيات المدافعات عن حقوق المرأة، والمنضويات في "شبكة النساء العراقيات"، هذا الطرح الذي يضع قانون الأحوال الشخصية موضع تساؤل من قبل احزاب جميعها محافظ وطائفي. واعتبرت النساء أن القانون القديم، وبرغم نواقصه ـ إذ تمّ "إصلاحه" باتجاه تراجعي في عهد صدام حسين في عقد التسعينيات من القرن الفائت ـ فهو يحمي وحدة العراقيين في إطار الحقوق الشخصية، ولا سيما بما يخص الزيجات المختلطة طائفياً. ليس هذا فحسب، بل هو يضمن مقاربة تقدمية نسبياً لحقوق المرأة.
كما ندّدت المدافعات العراقيات عن حقوق المرأة بهيمنة الأجواء الاجتماعية والدينية المحافظة على المجتمع العراقي حالياً. وهذه كانت قد تصاعدت مع الحملة الإيمانية التي أطلقها نظام صدام حسين في التسعينيات، وبلغت ذروتها بعد العام 2003 الذي شهد وصول الأحزاب الإسلامية المتشددة إلى السلطة. ومؤخرا، وتأكيداً على ضرورة الحفاظ على الزواج المدني، أطلقت "جمعية نساء بغداد" حملة لمواجهة الزيجات التي تتم خارج إطار المحكمة، والتي تُعرف بـ "زواج السيد"، وهي الزيجات التي يعقدها رجل دين، ولا تنفك تتزايد منذ العام 2003. وتضع هذه الزيجات الزوجات الشابات أمام نظام حقوق مقيّد للغاية وغير شرعي وفق القانون العراقي. وتفضح الجمعية تزايد حالات "زواج السيد" لفتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و13 عاماً ، لا سيما في الاوساط الفقيرة.
وهكذا، فإن تشرذم هوية العراق وأرضه على أسس عرقية وطائفية، علاوة على ما يسببه من فوضى أمنية، له أثر كبير وحقيقي على حقوق النساء. في وقت تُظهر الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003، وهي المتوافق على فسادها وانعدام كفاءتها عجزاً عن الاستجابة لحاجات العراقيين الجوهرية: الأمن والوصول إلى مياه الشفة والكهرباء والمسكن اللائق.
التمثيل بدل الحقوق
تقع على عاتق طائفية الحكومة المركزية، وعجزها عن تلبية حاجات مختلف مكونات المجتمع العراقي على قاعدة المساواة، فضلاً عن قمعها للحراك السني الذي قام غرب البلاد، المسؤولية الأكبر عن الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها حاليا البلاد.
علاوة على ذلك، فإن عسكرة المجتمع العراقي (التي يعود تاريخها إلى منتصف الثمانينيات)، مصحوبة بتمجيد الصورة الذكورية للعسكري، والتي بلغت ذروتها مع اجتياح تنظيم "داعش" لشمال البلاد، أدت إلى انتشار مفهوم عادي للعنف، والى إعادة تكوين العلاقات الجندرية التي باتت تحكمها ضرورات الأمن لا العدالة في المساواة بين الجنسين.
أجمع الأميركيون، ومعهم الأمم المتحدة وشبكات "الجمعيات غير الحكومية" والنخبة السياسية الجديدة من الأكراد والشيعة التي وصلت إلى السلطة في العام 2003.. على أهمية وجود المرأة ومشاركتها السياسية في السلطة. وعليه، تمّ في العام 2005 تبني الكوتا النسائية في المجالس التمثيلية بنسبة 25 في المئة (30 في المئة في كردستان). الحضور السياسي للمرأة، ومعظمه تم عبر البرلمان العراقي من خلال تمثيل الاحزاب الاكثر محافظة وطائفية، منحت الإدارة الأميركية والأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية التي كانت حاضرة في الفترات الأولى للاحتلال، نوعاً من راحة الضمير. أما بالنسبة للنساء العراقيات، فيبدو أنه قد فُضِّل لهن منذ 2003 "الظهور" على حق المساواة، و"المشاركة" السياسية (في الفوضى) على تحصيل الحقوق.