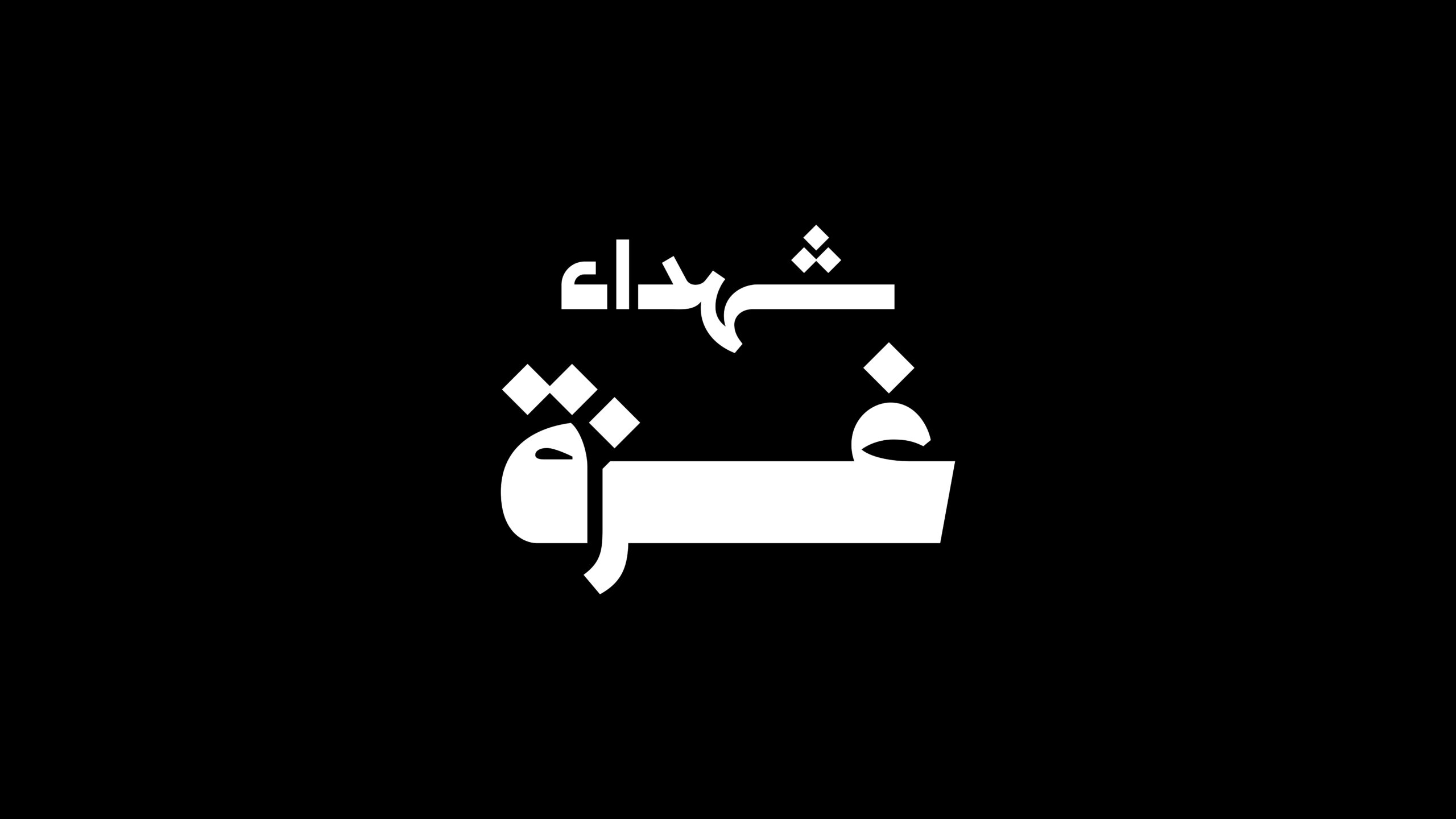في واحدة من الليالي الأخيرة في بيتي بمدينة غزّة، خطرَ لي كُلّ الشهداء من الأصدقاء، الذين رحلوا وقتلتهُم الحرب. حينها كُنّا في الأيام الأولى للحرب، إذا ما قارنّاها بالمدّة التي وصلت إليها الآن. ليلتها استشهد الصديق "ميسرة الريّس"، بعد أن كتب كلماتٍ بسيطة تداولها الناس، عن تخوّفه من أن يموت تحت أنقاض بيته، ليتحقّق ذلكَ لاحقاً. سألتُ نفسي، وأنا أعيش لياليَ صعبة تحت شظايا القذائف المدفعية، مع باقي أفراد عائلتي: من سيذكر هذه الحكايا؟ من سيكتُب عنهم؟ وماذا إن مُتُّ الآن، من سيحكي عنّي؟
في تلك الليلة، مباشرةً، أنشأتُ حساباً جديداً على موقع "إكس" ("تويتر" سابقاً)، أسميتُه "شُهداء غزّة". سريعاً بدأتُ نشر قصّة صديقي "ميسرة"، الطبيب الذي قضى في مدينة غزّة حين كان ينتظر طفلاً، ثم قصصاً لبعض أصدقائي الشُهداء الذين تذكّرتهم من بين هذه القائمة الكبيرة. "إبراهيم لافي"، صديقي العزيز وأوّل صحافي استشهد في الحرب صباح "السابع من أكتوبر"، شهداءُ آخرون من إخوة أصدقائي وأقاربهم.
بدأتُ بنشر الفكرة على "إكس"، نشرتُها في عددٍ من المجموعات الإلكترونية، تحدّثت عنها هُنا وهُناك لأصدقاء وصحافيين ونشطاء، طلبتُ منهم أن ننشر الفكرة. في اليوم التالي، أسستُ حساباً آخر بالفكرة نفسها على تطبيق "انستغرام"، واليوم اللاحق على تطبيق "تلغرام".
من هُنا كانت البداية. كانت البداية كي لا تبقى كُل الحكايا، وكُل الأسماء، نهاية فقط، من دون قصّة، فأوّل ما كتبتُه "هُنا نحكي قصص الشهداء، شُهداء غزّة، هُنا ننشر عنهم كي لا يكونوا أرقاماً".
لم أتوقّع أن تلقى هذه الفكرة رواجاً كبيراً في الأيام اللاحقة، وعلى الرغم من أنّي نزحتُ من بيتي في "مُخيم الشاطئ" إلى "حي الشيخ رضوان" بعدها بيوميْن، ثم من شمال غزّة إلى مدينة رفح الجنوبيّة بعدها بأيّام، وعشتُ تفاصيلَ صعبة من المُعاناة، لم أُقرّر أبداً التخلي عن الفكرة. سرعان ما أكملتُها، وكلّ يوم صرتُ أُفكّر، كيف أُطوّرها؟
____________
ملف خاص
إلى غزة وأهلها
____________
في اليوم الأوّل بعد تأسيس الفكرة، أوّل من أرسلتُها إليه، كان الشهيد الدكتور "رفعت العرعير". مباشرةً تابعَ المُبادرة، وقبل النقاش معهُ، بادرَ بالعرض بترجمة القصص المنشورة فيها إلى اللُغة الإنجليزية، ونشرها من جانبه، أو حتى نشرها من طرفي في الحساب. قال "رفعت" حينها، كلمةً واضحة، وهو المعروف بثوابته المُتعلقة بفلسطين ومقاومتها ونشر قضيّتها إلى العالم، قال: "يجب أن نذكر إسرائيل دائماً، يجب أن نذكر القاتل. يجب ألّا نقول إنّ الشخص استشهد فقط بتاريخ كذا، أو قتلته الصواريخ بتاريخ كذا. يجب أن نقول للجميع: "قتلتهُ إسرائيل، قتلهُ الاحتلال، قصفهُ الاحتلال.. إلخ"، ولم أتخلَ يوماً عن هذه الفكرة، حتى حينَ توسّع فريق العمل.
لطالما جلستُ مع نفسي أفكّر فيما حولي. في المُبادرة. كانت ولا تزال منفذاً لآلاف الناس كي يتحدّثوا قليلاً عن أحبائهم الذين فقدوهم، وهؤلاء سيفوقون الخمسين ألفاً. هذا العدد الهائل، من سيبقى ليحكي عنه؟ هذه فرصة كي نحكي، حتى لو استمرَ الأمر لأكثر من عشرة أعوام.
من هُنا كانت البداية... كي لا تبقى كُل الحكايا، وكُل الأسماء، نهاية فقط، من دون قصّة. فأوّل ما كتبتُه "هُنا نحكي قصص الشهداء، شُهداء غزّة، هُنا ننشر عنهم كي لا يكونوا أرقاماً".
في البداية، ولأشهرَ طويلة، كنتُ الشخص الوحيد الذي عملَ على الفكرة. أصحو من نومي، أُتابع جديد الحساب، من أرسل رسالةً؟ من أرسل قصة شهيد أو صورة أو أو.. أُعيد صياغتها، أكتُبها بطريقة جيّدة، أُرتّبها، أُرتّب الصورة، ثم أقوم بنشرها مع تاريخ الاستشهاد.
مطلب الشهداء!
03-11-2023
عيون شهداء غزّة.. نافذةٌ على جمالها
12-11-2023
حافظت على ثوابت أساسيّة في نشر القصص: اسم الشهيد، صورته، تاريخ استشهاده، وبعض تفاصيل حياته، حتى لو بالحدّ الأدنى، الذي سنقولُ فيه للعالم إن هذا الشهيد ليسَ مُجرّد عدد. أن نقول لهم إنّهُ كانت لهُ حياة. نعم، بعض الناس كان يُرسل قصة بلا تفاصيل، فهوُ لا يعرفُ الكتابة، ولا يعرف كيفَ يتحدّث عن صديقه أو قريبه أو شقيقه، لا يعرفُ سوى حُبّه وتعلّقه به، فأدفعهُ لذلك بشدّة، مُرسلًا إليه بعض الأسئلة التي ستُكوّن القصة: هل الشهيد متزوج؟ هل عندهُ أولاد؟ تاريخ ميلاده؟ ماذا كان يدرس؟ ماذا كان يعمل؟ هل تتذكّر موقفاً مميزاً حصلَ معه؟ كيف كانت علاقته مع أهله وجيرانه؟ وهكذا أستخلصُ بعض التفاصيل من المُرسِل، لتجعلني أُحوّلها إلى قصة ولو من فقرتيْن.
تنتظر الناس رؤية اسم الشهيد وصورته، كي ترتاح. أنهم يعتقدون أنهم يقومون بشيءٍ كبير من أجلهم، أن يقولوا للعالم إن هذا الشخص ليس رقماً في العدّد المُستمر. فوزارة الصحّة تُعلن بشكلٍ مُستمر ارتفاع أعداد الشُهداء، الذي تخطّى حاجز الـ 40 ألفاً في الأيام الماضية. كُلنا نعرفُ شُهداءَ منهم، وكُلنا نُريد أن نقول إنّ من نُحبه أو نعرفه، كانت لهُ حياة وقصّة وذكريات وأحلام.
لم أتخيّل حجم التفاعل الذي لاقتهُ الفكرة. أولاً تفاعل الجمهور معها، نشر القصص وحديثهم عنها، شعاراتهم التي كانوا يُرفقونها مع كلّ مشاركة لقصّة من المنصة، وهم يكتبون أنّهم ليسوا أرقاماً، دعواتهم للناس كي تُتابع الفكرة، والتواصل الكبير معي من أشخاص آخرين لترجمة القصص إلى لُغاتٍ أُخرى، منها التركية والإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية، وغيرها.
الأهمّ من كلّ ذلك، ما شهدتهُ من إقبالٍ شديد لأهالي الشُهداء وأصدقائهم. الكُل يُريد أن ننشر قصة. الكُل يريد أن يحكي عن صديقه ورفيقه وحبيبه وأخيه وأُمه وزوجه. هُنا أدركتُ حقيقة واحدة ثابتة وكبيرة: لسنا أرقاماً.
لا يزال هذا الإقبال مستمراً حتى اليوم. يجري استقبال القصص عبر أربع طُرق: "الإيميل" الرسمي للمُبادرة، الرسائل في حساب "إكس" وحساب "انستغرام"، وحساب "تلغرام" مخصّص للأمر نفسه. في كُلّ يوم يصل ما يزيد على عشر قصص لشُهداء، وفي كلّ يوم تصل عشرات الرسائل من أولئك الذين أرسلوا القصص في الأيام الماضية، يسألون متى سيتم نشر القصّة. هذا يسأل عن قصة شقيقه، وهذا عن قصة صديقه. الكُل ينتظر.
اكتشفتُ أنّ الناس تنتظر رؤية اسم الشهيد وصورته، كي ترتاح. أنهم يعتقدون الآن أنهم يقومون بشيءٍ كبير من أجلهم، أن يقولوا للعالم إن هذا الشخص ليس رقماً في العدّد المُستمر، فوزارة الصحّة تُعلن بشكلٍ مُستمر ارتفاع أعداد الشُهداء، الذي تخطّى حاجز الـ 40 ألفاً في الأيام الماضية. كُلنا نعرفُ شُهداءَ منهم، وكُلنا لا نُريد سوى أن نقول للناس إنّ من نُحبه أو نعرفه، هو شخص كانت لهُ حياة وقصّة وذكريات وأحلام، وليس مُجرد إضافة يوميّة على رقم الأربعين ألف.
قال صديقي الشهيد الدكتور "رفعت العرعير": "إنْ كُتب عليّ الموت، فليجلب موتي الأمل، فلتكن حكاية، وليكن موتي حكاية"... ولتَكُن حياة الباقين بعد الشُهداء، فرصة للحكاية أيضاً.
بقيتُ أعمل على الفكرة وحيداً، بينما ساعدني بعض الأصدقاء في البداية كي يُنقذوا استمرار الفكرة في حال الانقطاع، لكن هذا العمل المُكمّل منهم لم يكن أساسياً ولا دائماً، لانشغالهم. تبعَ ذلك إصراري على الاستمرار وحيداً. لاحقاً تواصلتُ مع خطّاط ومُصمِّم - للأسف لا أذكر اسمه - طلبتُ منه تصميم شعارٍ للمبادرة، لأعتمده في وقتٍ لاحق، ويصير علامة واضحة ورسميّة للفكرة التي أخذت تتطوّر يوماً بعد يوم. تبعَ ذلك إضافة الشعار إلى كلّ صورة ضمن قالب مُعين، تطوّر لاحقًا بإضافة اسم كلّ شهيد إلى الصورة مع الشعار، وتفاصيل مُهمة، كي تكون مرجعاً عندما يُشاهِد الصورة أحد الأشخاص، فيعود إلى المنصات ويتعرّف إلى شهداءَ آخرين.
شيئان مُهمّان طرأا على الفكرة لاحقاً: الأوّل أن فريقاً من مُبدعي المحتوى تواصلوا للمساعدة تطوعاً في المُبادرة، من تصميم وكتابة وتحرير ونشر، والثاني أنّ شركةً تعمل في لندن ودُبي، قدّمت عرضاً بتأسيس موقع إلكتروني للمُبادرة. وهاتان الفكرتان قائمتان حتى الآن.
فنّانات غزّة وأديباتّها الشهيدات
27-11-2023
أخذ الاحتلال الناس.. وأعادهم جثثاً بلا هوية
08-08-2024
فقد دخلَ معي فريق يضمُ كاتبتَيْ محتوى، ومُصمماً ومُساعدين آخرين في النشر والمُراجعة، سهّل العمل عليَّ بشكلٍ كامل، وهم أصدقاء يعملون اليوم بشكلٍ تطوّعي، وفيما بعد ومع امتداد الأشهر، صرت أعرضُ فكرة المُساعدة التطوعيّة على الجمهور، فأجدُ كثيراً من الكتّاب والمُحررين والصحافيين، الذين يُمكن الاعتماد عليهم في المساعدة في تحرير القصص وتجهيزها للنشر، وهي مُهمة ضرورية لتسريع العمل وتسريع تحقيق الهدف، بعدم تكدّس القصص. والأهم، كي يكون الشهداء مُرتاحين حين لا ننساهم، وكي يكون أهلُهم سُعداء بأن يروهم ويروا قصصهم، يطوفُ بها الإنترنت، فيتحدّثون عنهم ويحكون حكاياتهم.
أنشأنا موقعاً إلكترونياً بلغتيْن، العربية والإنجليزية، كتبتُ افتتاحيّته، وكتبتُ رسالتنا. أنشأتُ فيه مساحة مخصّصة لإرسال القصص، وقسّمنا القصص على أقسام كثيرة، منها فئات الشهداء من رجال ونساء وأطفال وكبار سن، ومسعفين وصحافيين ومدنيين... إضافةً إلى تواريخ الاستشهاد ومناطقها، ما يجعل من الموقع مرجعاً كبيراً وأرشيفاً لكلّ قصص الشهداء التي نعمل عليها، حتى لا تكون المبادرة مجرّد فكرة عابرة، وأن يستعملها كلّ شخص يبحث عن شهيد.
كنتُ سعيداً حين تواصل معي أحد الأصدقاء، ليسأل عن أسماء شُهداء استشهدوا في تواريخ معيّنة، لاستخدامها في شيءٍ ما، وقد ساعدتهُ بالعودة إلى مُبادرتي. قلتُ لنفسي، على الأقل أصبحت مرجعاً. على الأقل نفعلُ شيئًا. كلّ ذلك، الآن وأنا تحت القصف، وأنا نازح هارب من غزّة إلى رفح، ثم إلى الزوايدة، ثم إلى دير البلح.. ثم ثم ثم.. ولا أزال أتذكّر الشهداء.
مرةً وأنا أجلس في مكان نزوحي في رفح، أقضي كثيراً من الوقت في تجهيز قصص الشُهداء للنشر في اليوم التالي، سألني أحد الشبان الذين ينامون معي في الغرفة نفسها: "انتَ ما زهقت من قصص الشُهداء؟ مش حتوقّف؟" سرحتُ قليلاً في السؤال، وسألتُ نفسي: فعلاً، إلى متى؟ حينها تأكدّتُ أنها ستكون إلى الأبد.
لطالما جلستُ مع نفسي أفكّر فيما حولي. في المُبادرة. كانت ولا تزال منفذاً لآلاف الناس كي يتحدّثوا قليلاً عن أحبائهم الذين فقدوهم، وهؤلاء سيفوقون الخمسين ألفاً. هذا العدد الهائل من سيبقى ليحكي عنه؟ نعم لا ضرر، سأحكي أنا وسيحكي الجميع، هذه فرصة كي نحكي، حتى لو استمرَ الأمر لأكثر من عشرة أعوام.
نظرتُ إلى الفكرة من زاوية إقبال الناس عليها، كمرجع كبير وواسع ورسمي، كفكرة مؤسّسة لما هو أبعد من مجرّد منصة، كأرشيف كبير سنعمل عليه لسنوات، أتوقّع أن يعمل عليه آلاف المتطوعين أو المئات فيما بعد الحرب، أو حتى أشخاص كموظفين وعاملين وباحثين، إن كان للفكرة يوماً ما تمويلًا معيناً لإنجاحها واستمرارها.
تمنّيت لو أنّ الشهداء كُلهم يعودون ويستطيعون أن يروا ما قالهُ عنهم الناس. كلّ كلمات الحُب، كل المواقف الجميلة، كُل التفاصيل، كلّ الأشياء التي تعود إلى الذاكرة، تستحقُ أن يعرفها الشهيد، كما تستحقُ أن يعرفها الناس.
عندما غادرتُ رفح، تحت وطأة المدافع، مُجبراً من الخوف على طفلتي الصغيرة وعلى عائلتي، نزحتُ إلى مكانٍ لا يوجد فيه إنترنت، ولا يزال الأمرُ مستمراً إلى الآن. أضطر كلّ يوم لأقطع المسافات كي أتصلَ بالإنترنت، وهو ما منعني من الاستمرار بالفكرة. لكن ذلك لم يكُن عائقاً، فقد صارت الفكرة مُستمرة إلى الآن.
بلد القبعات..
04-07-2024
معايشة الحرب في "غزَّة" - شهادة
13-06-2024
بمجرّد أن قررتُ النزوح، عرضَ عليَّ شقيقي الصغير "أحمد"، الطالب الجامعي الذي لم يُكمل عامه الثالث في الجامعة بسبب الحرب، أن يواصل المساعدة في النشر والبحث عن القصص، رفقة المتطوعين. الآن هو يُدير الفكرة مع الفريق رسمياً، وأنا أُشرف على الأمر، أُقدم له النصائح والملاحظات، وأتابع الأمور الرئيسية والرد على كلّ من يسأل أو يرغب في شيء غير إرسال القصص. وهي مُبادرة منه، سأبقى ممتنًا له عليها، طويلاً، فقط لأنّهُ استمرَ بالفكرة كما لو أنني هُنا.
لماذا أفعل ذلك؟ أفعلهُ لأنني أرى نفسي مكان كلّ شهيد. استشهد زوج أختي بعد بدء الحرب بأسبوعٍ واحد، كان مُسعفاً، ذهب يُنقذ الجرحى بعد قصف مجموعة من النازحين على طريق "صلاح الدين الشرقي" في مدينة غزّة، قصفته الطائرات بصواريخها أثناء مُهمة إنسانية، وإن لم أكُنْ قد كتبتُ عنه ونشرت قصته في المنصة، لا أتوقّع أن يكتب عنهُ أحد أو يذكره أحد غير عائلته. كذلك كثيرٌ من الشُهداء.
كذلك سأكون أنا، رُبما ذلك، نعم، ورُبما يكون أحدٌ آخر من أهلي، كما كان كثيرٌ من أصدقائي الذين فقدتُهم في هذه الإبادة.
لطالما سألتُ نفسي، إذا متّ واستشهدت، ماذا سيحكي عني الناس؟ كيف سيتذكّرونني؟ ماذا سيقولون؟ ماذا سيقول هذا وماذا سيحكي ذاك أو يتذكّر؟. تمنّيت لو أنّ الشهداء كُلهم يعودون ويستطيعون أن يروا ما قالهُ عنهم الناس. كلّ كلمات الحُب، كل المواقف الجميلة، كُل التفاصيل، كلّ الأشياء التي تعود إلى الذاكرة، تستحقُ أن يعرفها الشهيد، كما تستحقُ أن يعرفها الناس.
لأنني أُدرك أنني عندما أموت، لن أستطيع العودة لأرى ما كتبوا عنّي، قرّرت أن تكون هذه الفكرة.
هذه الفكرة من أجلي ومن أجل كُل الشهداء. غداً حين أكونُ مكانهم، سأكون مطمئناً، وأنا أعرف أنّ كل هؤلاء الذين أتحتُ لهم فرصةً للحديث عن أصدقائهم الشهداء وأحبابهم، سيتذكرونني كثيراً.
"حكايا غزّة": الرواية بصفتها أمَلاً
26-01-2024
وكما قال صديقي الشهيد الدكتور "رفعت العرعير": "إنْ كُتب عليّ الموت، فليجلب موتي الأمل، فلتكن حكاية، وليكن موتي حكاية". كتبَ "رفعت" هذه الكلمات، لكنّني كنتُ أفكّر فيها قبل أن يرحلَ عنّا، كنتُ طويلًا، في كلّ ليلة أحكيها لنفسي ولمن حولي، والآن، كانت مُبادرة "شُهداء غزّة"، كي يكون هذا الموت حكاية.. ولتَكُن حياة الباقين بعد الشُهداء، فرصة للحكاية أيضاً.
- رابط الموقع الإلكتروني لا زال قيد التجهيز
- رابط المبادرة على إكس: https://x.com/Gaza_Shaheed
- على انستغرام: https://www.instagram.com/gaza_shaheed
- على تلغرام: https://t.me/Gaza_shaheed