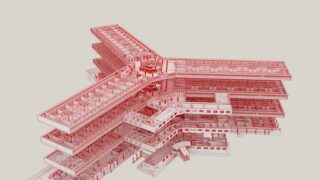تظهر السلطة كاختزال متقن للواقع الموضوعي، وتظهر أيضاً كسلسلة طويلة من القرارات والأوامر، لا يعرف الناس من أين تتساقط فوق رؤوسهم ولا حتى كيف، كما لا يعرفون ما يكفي عن طبيعتها، فيختلط عليهم تموضعها وتموضعهم على طرفيّ العقد الاجتماعي. لكنهم بهذا يسلّمون لها رقابهم، يرمون إليها مصائرهم بلا اكتراثٍ أو ندم، وكأنها مصائرُ مستعارة لهم، لا تخصّهم بشيء. والناس لا تجادل السلطة بصوابيّة قراراتها. هم بالأصل متشكّكون بحقيقة كينونتهم كمواطنين يمنحون السلطة شرعيتها، والسلطة تنظر إليهم كمحتويات جداول ورقية مهملة داخل سجلّات الأحوال الشخصيّة، أو كأرقام طويلة مدوّنة فوق بطاقاتهم الشخصية.. ليسوا أكثر من ذلك ضمن حسابات صيغة زمنيّة ممتدة منذ قرابة نصف قرن، تَقلّصَ خلالها مفهوم المواطنة على حساب تمادي نفوذ مفهوم السلطة، وهذا استنهضَ خراب اليقين، أصابت شظاياه خلال الأعوام الماضية جموع السوريين بصورة موجعة، وجعلتهم يتساءلون بمرارة عن سبب طمس مكانهم داخل مسار صناعة القرار.
الحياة داخل أدراج السلطة
منذ تحوّلت السلطة في سوريا إلى نظام حكم لا يتغيّر، وهي لا تجد ضيراً من بقائها فوق القانون وفوق المجتمع أيضاً. موقعها الجديد جعلها تستخفّ بفكرة المواطنة وتميل إلى إبطالها تدريجيّاً، مكتفيةً باستبدال كل مواطن بملفٍّ ورقي. تتعامل مع الناس على أنهم مجرّد معطيات نظريّة مقسّمة إلى فئات وجداول، وهذا الاستعلاء شطبَ الفعل المجتمعي خلال هذه الحرب وقبلها. وطبّق وصايةُ صارمة استندت إلى قدرة السلطة غير المحدودة على التفكير والتقرير نيابةً عن المجتمع ككل.
يشتكي الناس من العبث المفرط في إدارة شأنهم العام، ينتقدون أداء وزير الكهرباء، فيجدونه وقد صار رئيساً للحكومة، يتساءلون عن سبب بقاء مصرف بلادهم المركزي متفرّجاً على ملحمة تهالك قيمة الليرة السورية، فيجدون حاكم المصرف المركزي وقد صار وزيراً للاقتصاد والتجارة، يرفعون راياتٍ بيضاء تنفعهم في إشهار عورة إفلاسهم، فترفع لهم السلطة أسعار المحروقات مجدداً، تستدير أحاديثهم حول أزمة وجودهم تلك، تحاول صياغتها مجدداً: هل يعيشون على ضفة، وتعيش السلطة على الضفّة النقيضة، وهل بين الضفتين عداوة؟
أواخر شهر حزيران/ يونيو من هذا العام، بحثت جلسة حوار نظّمتها القيادة القطرية لحزب البعث في عناوين عديدة حاولت الإحاطة بالتطورات والمؤشرات الاقتصادية المالية والنقدية وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطن. حينها خرج المتحاورون بثلاثين مقترحاً تعلّقت بعمل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف والرقابة على شركات الصرافة وزيادة الإنتاج المحلّي وضرورة تأليف خلية أزمة اقتصادية، وأخرى لإدارة التوقعات والقرار الاستباقي. تلك القائمة الطويلة من المقترحات التي طلب رئيس الحكومة السابقة وائل الحلقي من وزرائه إبداء الرأي فيها تدلل ضمنيّاً على غياب هواجس الشأن العام عن الذهنية التطبيقية للسلطة. وكان على الكارثة المعيشيّة التي تعمّ حياة السوريين أن تحتفل بعيد ميلادها الخامس كي تلتقطها مجسّات السلطة الخاملة، فتبحثها كأنها استجدت للتو، ثم تطلب من الحكومة الاطلاع عليها، وكأن الحكومة أيضاً غافلةً عنها، أو أنها لم تكن سوى مديرٍ تنفيذي متردّي الأداء للشأن العام.
التملّك والثراء ورضا السلطة
استولت السلطة خلال الأشهر الماضية على أراضٍ وصفتها بأنها زائدة عن سقف الملكية الزراعية المسموح به في سوريا، والمحدَّد بقانون صدر عام 1980، وقبلاً بقانون الإصلاح الزراعي لعام 1958 وتعديلاته. تلك القرارات هطلت من سماء السلطة فجأة، وكأنها تنبّهت بغتةً إلى تجاوزات طالت قانون الملكية. لكن هل يمكن تبسيط المسألة على هذا النحو، أم أنّ لهذه القرارات خلفيةً سياسية؟ إذ تشير المعلومات الأولية إلى انتهاء السلطة إجرائيّاً من مصادرة عقارات زراعيّة واسعة يعود نسَبها الجغرافيّ إلى درعا وحمص وريف دمشق والسويداء. ومن بين العقارات المصادرة واحدٌ تعود ملكيته إلى رجل الأعمال المعروف موفق قدّاح، بالإضافة إلى مصادرة عقارات زراعية لرجال أعمال آخرين صاروا خارج البلاد. غير أنّ السيرة الذاتية للسلطة القائمة تشير إلى أنها فتحت أبواب اقتصادها وتشريعاتها على مصاريعها منذ العام 2008 أمام معادلات السوق، وأمام استثمارات رموز المال السياسي الجديد، ولأن السلطة في سوريا كما في غيرها من الأنظمة الشمولية تراعي الدور الأبوي، وربما لا تتقن سواه، فأنها تغدق العطاء على من تشاء وبقراراتٍ واضحة، وتزيل عطاياها عمن تريد، وبقراراتٍ معلّلة أيضاً.
لقد تجذّرت الثروة في سوريا خلال السنوات الماضية داخل دوائرٍ ضيّقة، أخذت تحيط بمراكز النفوذ. وهذا انزياحٌ طبيعي استقطبه الاقتتال العسكري الطويل، وجرّه إلى عناوين شهيّة تمجّد "البراغماتيّة" وتحلّلها شرعاً. امتلاك السلطة يقود بالضرورة إلى إدراك مقدماتِ ثراءٍ حقيقي، وصار مقدار الثروة يُنسب حسابيّاً إلى حجم السلطة، من خلال قدرتها غير المقنّنة في التحوّل إلى فعلٍ إلغائيٍّ لباقي بنى المجتمع، وخارج نظرية المحاسبة المجتمعيّة أيضاً، وكأن هذا التجريد يكاد يتطابق عمليّاً مع تحلّل النظام القائم وعودته إلى مركباته الأساسية المشّتقة أصلاً من نفوذ حزب البعث والمؤسسة الأمنية والعسكريّة ثم من احتكار السلطة المطلق.
قطعة لحمٍ باردة
لم تدارِ السلطة الوجع اليومي للناس باعتباره نصيبهم الوحيد من الحرب الطويلة، تناستهُ وأخذت تبحث عن مطارح جديدة للثراء وإن كان على حساب إفقار السواد الأعظم من مؤيديها. وهذا أخذ يتّضح أكثر منذ العام 2013، ومعها بدأت منظومات النهب العام تستلهم روح المرحلة، وتتوسع أفقياً وعمودياً. ثم طوّقت السلطة تدريجيّاً، وخلال سعيها إلى تعظيم ثراء مكوناتها، النمط الاستهلاكي العام للقابعين تحت وصايتها، وامتصّت قدراتهم الشرائيّة المحدودة، فأغرقت الناس في عجزٍ لا قاع له، ثم شقّت بسكينها النسيج الاجتماعي الباقي ضمن جسد البلاد، قسمتهُ بين عاجزين راضين بما يسدُّ الرمق، وبين انتهازيين التحقوا بأسفل درك معادلة النهب، فانتظموا في حلقاتٍ صغيرة تخدم مصالح حلقاتٍ ذات مستوى أعلى من السلطة، تقدّم الفائدة لها، وتستفيد هي بالحدّ الأدنى.
الخشية باتت تطال وصول القرارات الحكوميّة التي تُضمر بشكلٍ غيرِ مرئيّ زيادةً في ثراء البعض، إلى بديهيّات الحياة نفسها، وإلى سلّة الاستهلاك الأساسيّة فتضيف عليها أوزاراً جديدة لم تكن في حسبان الناس. وهنا يكفي أن تَصْدُق التوقعات التي تشي بنيّة وزارة الاقتصاد إصدار قرارٍ يسمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز إلى دول الخليج بصورةٍ خاصة، لكي نتكهّن منذ الآن بإمكانية وصول سعر الكيلو الواحد من لحم الغنم في السوق السوريّة إلى حدود 20 دولاراً بحسب تقديرات بعض المختصّين.
بالمقابل أدارت الحكومة السابقة ظهرها إلى اللحوم البيضاء أيضاً، بعدما امتنعت عن منح قرضٍ بقيمة ملياري ليرة كان هدفه تخفيض كلفة الإنتاج في قطاع الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بشكلٍ ملحوظ منذ شهر أيار / مايو من هذا العام. ألم تكن زيادة الإنتاج المحليّ واحدة من بين المقترحات الثلاثين التي خلصت إليها السلطة خلال اجتماعٍ حواري أدارته في مبنى القيادة القطريّة؟
كما لم تراعِ السلطة حرمة الفقر الذي ارتفع منسوبه العام، ولا راعت تدابيره الانتقامية على حياة الناس. دوماً كانت تظهر على الضفة الأخرى للحياة، تارةً بحكوماتها الشكليّة المتعاقبة، وتارةً بمجلس شعبٍ مرتجل، يلزمها لإكمال "بريستيج" شكل الدولة. كما لم تغيّر معادلة الحرب شيئاً من الممارسة الواقعية للسلطة، ظلّت هي الأخرى متعالية، دوغمائيّة، لا يعنيها سوى الديمومة حتى ولو فوق أنقاض البلاد وقاطنيها.