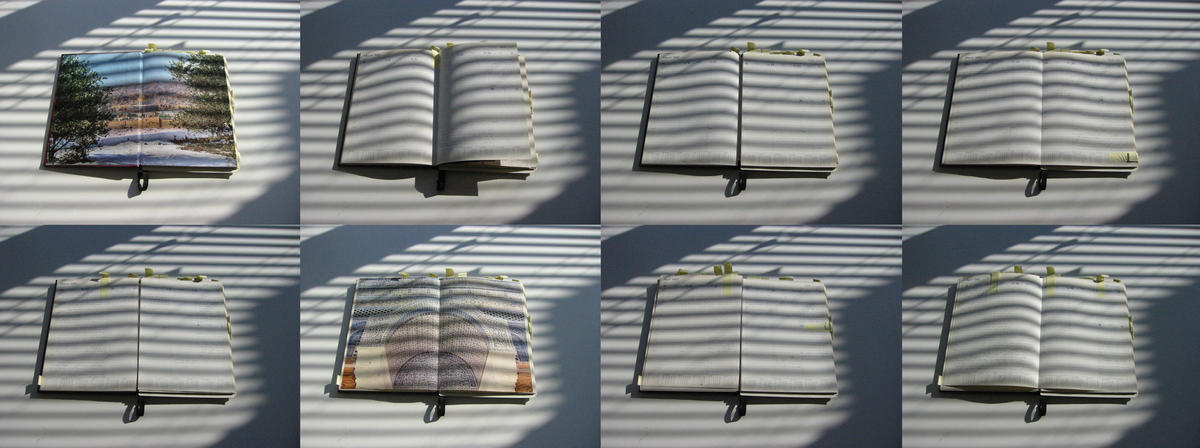وقف الأهالي على الرصيف المقابل للإعدادية التي تحولت إلى مركز امتحانات للشهادة الثانوية "البكالوريا"، بعد 12 سنة دراسية متواصلة. جمع المركز طالبات أربع ثانويات، إحداها تقع في حي على التخوم الحربية. احتضنت الأمهات بناتهن، وزودنهن بطاقاتٍ معنوية مشفوعة بالأدعية، وطالبنهن التجمل بالصبر في قاعة الامتحان، ومغادرة التوتر والاضطراب قبل البدء بكتابة الإجابات، وتمنين في تمتمات مختلجة، وهن يتابعنهن يدخلن من البوابة الرئيسية، إبعاد شر القذائف عن المكان. وبقين واقفات في أمكنتهن تحت الشمس، ينتظرن خروجهن الظافر.
توخى التعليم انتزاع كينونة الاستقلال. وبقي رغم آماله المضمرة، تابعاً لأنساق أخرى تنتمي للمجتمع والدولة والسلطة التي تحكمهما، وما انفك يُعرض في الأسواق المدرسية، التي أملت كل الفئات المنبثقة من متن الطبقات الشعبية التي أرادت لأبنائها الانتقال من البيع العاري لقوة العمل إلى بيعها بوسائل تكتسي بثوب الإجازات الجامعية العليا والمتوسطة، وعملت للحصول بالكفاح الدراسي الدؤوب على ما يتحقق به، من توفير فرص للعمل ودخل للعيش وحالة من الرفاه والاستقرار.. بعد استقوائها بالتعليم المتوسط والعالي لردم الفجوة العضلية بين الآباء المنهكين بضمور عضلاتهم والأبناء الصاعدين بشفاعة التعليم. لكن العروض باتت تتطلب دفع أثمان عالية من الجهد والمال، ما يفوق الوعود المخادعة التي يحققها.
يقوّم المعلمون ما يخالونه اعوجاجاً تربوياً ولفظياً، بالعصي والكلام الحاد، وينقل بعضهم الطلاب إلى غياهب التهديد والابتزاز، كما يُستعَن خارج المدرسة بعصي أخرى وكلام آخر لتعود الأمور إلى سابق اعوجاجها. ومن تبقى منهم، من الذين احتفظوا بدور متخيّل للمعلم في إهاب المثقف التنويري، أمسوا يجدون أنفسهم في شروط جديدة يمكن اعتبارها غير تنويرية، بل مناهضة كلياً للتنوير.
ارتبطت "ديمقراطية التعليم" بالأنظمة الجمهورية. وديمقراطية التعليم كناية عن توفير التعليم الإلزامي وبعض من لوازمه للمرحلة الابتدائية التي تستغرق 6 سنوات تعليمية، قبل رفعها لتشمل المرحلة الإعدادية (3 سنوات). ولكي تنتقل "ديمقراطية التعليم"من شعار إلى واقع تطبيقي، استولى الإنقلابيون في ستينيات القرن الماضي على مئات القصور والبيوت الفاخرة، فضلاً عن تأميم شمل عشرات المدارس الأوروبية، جرى تحويلها إلى مدارس ابتدائية – اعدادية - ثانوية، واستقدم الآلاف من حملة الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعض من طلبة الجامعة، وعُمل على إدراجهم في وظائف مؤقتة أو دائمة في وزارة التربية والتعليم. يحتاج الوصول إلى التعليم الجامعي 12 سنة دراسية متواصلة، باستثناء المؤسسات الرعائية ــ حضانة، رياض الأطفال ــ قبل وصولهم إلى سن قبولهم في المدرسة الابتدائية.
ينتقل الكثير من الطلبة بعد إتمامهم المرحلة الإعدادية، وفق ثبت الدرجات التي حصلوا عليها، إلى التعليم الفني والمهني...إلخ ويكمل الآخرون مسيرتهم في التعليم العام.. وتتوج بحصولهم على شهادة التعليم الثانوي المنقسمة إلى فرعين علمي وأدبي، يختار الطالب أحدهما، الذي لم يعد كافياً النجاح فيه فحسب، إذ يتوجب الحصول على معدلات معينة للقبول في الفروع الجامعية، ومعدلات تقارب التمامية لدخول الكليات التي تعتبر عليا، كالطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.. مسيرة شاقة ومكلفة مالياً ونفسياً، كأنها توكيد لتصريح قديم لوزيرة التعليم العالي"سأجعل الدخول للجامعة حلماً للطلبة".. الذي تصادف مع توقيع حزمة من التراخيص لإطلاق عدد من الجامعات الخاصة، مما دل إلى أن المؤسسات التعليمية شبه المجانية، باتت عبئاً على ميزانية الاقتصاد الحكومي. ترافق ذلك مع إطلاق "التعليم الجامعي الموازي"، يدخله الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على العلامات الكافية، وحمل من بدايته صفة التعليم بأجور، ويتم في صفوف المباني الجامعية ذاتها. لا يضمر التعليم غاية بذاته، فهو وسيلة لتوفير العمل الذي تتطلبه مستلزماته وشروطه وتطورها.
يتوجب الكف عن التهليل لهذه المسيرة التعليمية التي أخذت بعضاً من سمات "الحتمية التعليمية" المفضية إلى ملكوت العمل الهانئ، المحقق للازدهار والرفاه، بل الانتقال إلى نقدها وكشف خللها وإجحافها، والقدرات الاستنزافية الكامنة في تفاصيلها، سواء لجهة الطلبة أو لعائلاتهم.
- ولكن ماذا بعد الدخول للجامعة؟
-الخروج منها، إذ بعد كل دخول خروج.
يتزود الطالب بشهادة جامعية تؤهله للدخول الى سوق العمل الذي يخضع بدوره لقوانينه الخاصة.. هي عبور مجازي من المؤسسة التعليمية إلى الدولة ومؤسساتها والمجتمع وفعالياته الاقتصادية، وانتقال من الاعتماد على أسرته في توفير المصروف الجامعي إلى الاعتماد على الذات، وتضعه في مواجهة الواقع العملي المتفارق مع الخيال التعليمي. شواغر العمل، النمو المتزايد أو المتراجع للاقتصاد، تراجع أو تزايد التوظيف في المؤسسات الحكومية، جدوى الشهادة التي حصل عليها وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل.. بعدما تبين أنّ عشرات الأفرع الجامعية منفصلة كلياً عن الحاجات التي يطلبها سوق العمل، وكأنها قد أنشئت بغاية زيادة الفرص لاستيعاب الناجحين في الشهادة الثانوية، مثل كلّيات الآثار والمتاحف والسياحة والتربية وإدارة الأعمال.. كما يفرض سوق العمل في القطاعات غير الحكومية مهارات تتطلب من الطالب المتخرج حديثاً إعادة التسجيل في دورات تعليمية في اللغات الأجنبية ــ الإنكليزية على الخصوص ــ والبرمجيات الحاسوبية.. ليعود طائعاً إلى الضغط المزدوج، العودة من جديد إلى مقاعد التعليم، الاستنزاف المالي لأسرته.
- هل وجدت عملاً؟
- لا، سأذهب لأداء الخدمة الإلزامية، وبعدها أعاود البحث.
مسيرة طويلة، مضنية للأسرة بمواردها المحدودة، وللخريج الجامعي.. الذي لن يدخل فعلياً سوق العمل، إلا بعد تجاوزه سن السادسة والعشرين، إضافة للإمكانات المالية العالية التي يتطلبها بعد تخرجه وتجاوزه مرحلة الاختصاص. الواصلون والواصلات إلى الكليات الامتيازية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة..) لتوفير عيادات وصيدليات بتجهيزاتها المكلفة. لا تفصح المسارات الاجتماعية عن كنهها الذي تسربلت بداياتها في هيئات مبهجة، تزينها أناقة الهندام، وحسن الألفاظ، وبدائع الكلام، لتنتهي وكأنما خرجت عن مرتسم طريقها، وها هي "ديمقراطية التعليم" التي فتحت الباب في يوم ما من القرن الماضي أمام الطبقات الشعبية، لتعبر إلى مواقع اجتماعية أخرى، وتعبث بجغرافيا الطبقات الساكنة، تعود إلى انغلاقها.. أو لانفتاح إلى البطالة وجحيم اقتصاد السوق، أو السوء.
الآخرون.. الآخرون.. أي ذاك الرهط المدجج بالآمال، سيكون مصير الأشد حظاً منهم، بعد توفير عمل ثابت، كمصير عازف الكونترباص في أوركسترا سمفونية. يراه الجميع واقفاً في صفوفها الخلفية، يعزف حصته من المقطوعات الموسيقية، ولا أحد يعير صوت النشيج الخافت المنبعث من قلب آلته، وقلبه.