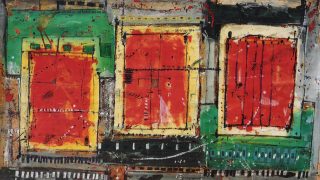في 19 آذار/ مارس 2011، يوم الاستفتاء على تعديلات الدستور التي أدخلها المجلس العسكري الحاكم حينذاك، بعد تنحي مبارك عن الحكم بأقل من شهرين، انتصرت "نعم". وكانت أول هزيمة انتخابية لـ "قوى الثورة" التي حشدت للتصويت بـ "لا".
وقتها أحسسنا بإحباط خفيف، نابع من اﻷمل الذي أعطته إيانا الثورة. كنا طول عمرنا أقلية، وجاءت الثورة لتعطينا إشارة خافتة بأننا ربما لسنا أقلية لهذا الحد، ثم جاء "استفتاء 19 مارس" ليعيدنا إلى وضعنا اﻷصلي. خاب أملنا قليلا، وعانينا اكتئابا خفيفًا مع توالي ظهور أعدائنا كالأشباح. اﻹخوان وأتباع الشيخ حازم أبو إسماعيل، أبناء مبارك وأتباع رجلَي مبارك، عمر سليمان وأحمد شفيق، ومن ورائهم جيوش ضخمة من المحافِظين، من يفضلون القمع على الشتيمة، ومن يفضلون عصا السيد على صرخة العبد. عانينا الكآبة وبدأنا نكتب عن هزيمة الثورة، بعد نجاحها غير المسبوق في تاريخ مصر، بأقل من شهرين، بدأنا نكتب عن هزيمة الثورة.
ولكن اﻷيام مرت وعرفنا طعم الهزيمة الحقيقية، الهزيمة المراوغة التي جاءت عن طريق الانتخابات، ووضعتنا في مواجهة رقمية مع المجتمع. خضعنا للانتخابات، وأُحبِطنا معها. وصلت المسيرة الانتخابية لذروتها بفوز مرشح اﻹخوان المسلمين محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، ووصوله لسدة الحكم بعدد من اﻷصوات يزيد قليلًا عن غريمه أحمد شفيق. بعدها بدأ تذمّرٌ يغلي بين صفوف الثوريين احتجاجاً على مرسي وخيانته للثورة، واتجاره، هو وجماعته، بالدِّين، بل وتذمراً من الانتخابات كآلية للديمقراطية، وشاركَنا المجتمع هذا التذمر هذه المرة. إلى أن جاءت "ثورة 30 يونيو" التي نزل فيها الثوار جنباً إلى جنب المواطن العادي، إلى جنب أبناء مبارك، وإلى جنب رجال الشرطة والجيش المسلحين، ضد حكم اﻹخوان المسلمين، في ما سيشكل بعدها الذريعة لاستيلاء الجيش على الحكم.
كانت هذه أقسى هزيمة على اﻹطلاق لنا. لم يكن ممكنًا للثورة أن تنهزم من خارجها، لم تكن لتُهُزم عبر مواجهة عسكرية في شوارع "محمد محمود" مثلًا. لم تتأتَّ هزيمتها إلّا من داخل نفوس الثوريين أولا، عبر شعورهم الدفين أنهم "شركاء الانقلاب". ليس فقط أنّ مَن حولنا في 30 يونيو كانوا يحملون رجال الشرطة على أعناقهم، بل كنا نحن أيضا من حملناهم، ونادى كثير منا بالحكم العسكري كحلّ وحيد للتغلب على خطر الإسلام السياسي. لم نعرف أنفسنا للحظة، وعندما انتبهنا كان الوقت قد فات. وكان الجيش انتهى من اﻹسلاميين ثم استدار إلينا.
كانت هذه الهزيمة اﻷصلية، الضربة الساحقة التي قضت على وجود التظاهرات في الشارع مرة أخرى. اندلعت تظاهرات خافتة ومنكسرة بعدها، ثم خمدت تماماً، قبل أن تعاود الانفجار في اﻷسابيع اﻷخيرة.
في ظلام أيّام حظر التجوال التي أعقبت "مذبحة رابعة"، كتب الشاعر محمود عزت مفتتحاً قصيدته "صلاة الخوف": "نجّينا م الشرير/ ارحمنا م التجربة/ المعركة المرة دي/ مش هيّنة/ المعركة غايمة/ غربال ورا غربال/ وف صفّنا الجنرال/ المعركة مرعبة/ ووقفنا زي الجثث/ باصّين على المدبحة/ الدم على صدرنا/ بننتصر؟ ولاّ/ ف طابور الدبح؟/ هل دا سؤال العار/ ولاّ السكوت أقبح؟/ ننزل نلمّ الغنايم/ ولاّ نعد الجثث؟".
اقرأ أيضاً: خواطر حول سنوات الثورة.. شعوب مصر الثلاثة
ما فات كان الوجه المهيمن لـ30 يونيو: وجه الحيلة التي انطلت علينا، الانقلاب العسكري الذي أسهمنا فيه بلا وعي. ولكن هذا لم يكن الوجه الوحيد.
في أعقاب 30 يونيو، شاع تساؤل حول تعريف أحداث هذا اليوم، وما إذا كانت ثورة أم انقلاباً. من قالوا إنها "ثورة" كانت لديهم حججهم: صحيح أن الجنرال كان في صفنا، ولكن سبق نزوله نزول ملايين من المدنيين. وصحيح أن 30 يونيو أتت بالحكم العسكري، ولكنها أزاحت رئيساً بعد أن هتفت الجماهير بسقوطه.
نسلّم بأن هناك جانبا لا بأس به من الحيلة في 30 يونيو، وقد يكون هو الجانب اﻷبرز حتى. ولكن هذه "الحيلة" حفرت أيضا في ذاكرة المصريين مشهد الجماهير وهي تزيح مرسي، بعد أن كان انحفر في ذاكرتهم المشهد اﻷول واﻷصلي للجماهير وهي تزيح مبارك. هذا يفسر لماذا يقابل التهديد بـ "ثورة ثالثة" بهذه الهستيريا.
كان نجاح "ثورة 25 يناير" في تنحية مبارك زلزالاً ضخماً هز مصر كلها، لكونه فعلا غير مسبوق في مصر منذ آلاف السنوات. ومن هنا تنبع مركزيته، وسيمر وقت طويل قبل اﻹحاطة بجميع توابعه. فمثلاً، أحد هذه التوابع كان استحالة هزيمة الثورة سوى بإقناع الثوار أن تخلّصهم من محمد مرسي هو فعل ثوري، أي بالانحناء قليلاً أمام قوة الجماهير وركوب موجتها، وتوجيهها في اتجاه معاد آخر، وهو القبول بالحكم العسكري. ولكن ما حدث بعدها كان أن مشهد عزل الجماهير لمبارك، ثم مشهد خلعها لمرسي، خلقا وعياً غائماً بسهولة إطاحة الرؤساء، وبحق الجماهير في خلع أي رئيس لا يرضون عنه. هذا الوعي جديد تماماً، بالتأكيد لم يكن موجوداً أيام عبد الناصر ولا أيام السادات الذي اغتيل على يد طلقات فرد، لا على يد ثورة جماهيرية، ولا في أيام مبارك، باستثناء اﻷخيرة منها.

باﻹضافة لهذا، تتحول الثورة، المصحوبة بإمكانيات التواصل الواسع عبر اﻹنترنت، إلى طاقة تمس الجميع. لا تُخفى على أحد مظاهر التحرر الديني خلال السنوات الخمس الماضية، خلع البنات للحجاب، كتابة اﻷلفاظ البذيئة بهدف تحرير اللغة المكتوبة من محافظتها، تزايد ظاهرة اﻹلحاد، السخرية من الشيوخ، الهجوم ضد المتحرشين، الدفاع عن المثليين، وغيرها. كما لا تُخفى على أحد مظاهر النقد الموجهة للسلطة العسكرية. قبل 25 يناير، كان هذا النوع من النقد مقصوراً على مجموعة من الكتيبات والمقالات اليسارية شديدة الهامشية، أمّا اﻵن فهو يُناقَش في البيوت والمقاهي وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن كان لا يزال ممنوعاً من الوصول لوسائل اﻹعلام الرسمية. فتبدل الخطاب المعارض من واحد يختزل المأساة الفلسطينية في "اﻷقصى اﻷسير"، إلى آخر يطالب بالعدالة والحرية والديمقراطية، كما يعبر عن تضامنه بقوة مع الفلسطينيين. كان الثوريون هم القاطرة التي أطلقت هذا القطار. أطلقوه وانهزموا. وإذا كان من الممكن التفريق بين الجوهر والعَرَض، ورأيي أن هذا ممكن، نقول إن الثوريين منسحبون لكن الثورة تأخذ في التمدد.
ترينا قصة تظاهرات 30 يونيو، والتحالفات التي أدّت إليها ونشأت عنها، والتي سرعان ما تفككت، كيف يمكن للشكل أن يؤثر في الموضوع، وكيف يمكن للتكنيك أن ينقلب على نفسه، ولو ببطء، ولو بشكل غير واع.
***
يصف بعض مؤيدو الدولة القديمة "الربيع العربي" بالمؤامرة المعدة لتفتيت العالم العربي. وحجتهم التي يتصوّرونها دامغة: هل من الصدفة أن تنفجر انتفاضة في تونس تليها أخرى في مصر ثم في سوريا وليبيا واليمن والبحرين وغيرها؟ رفضهم لمفهوم الصدفة يؤدي بهم إلى التبني الفوري لمفهوم المؤامرة، مع تجاهلهم لمفهوم ثالث: التفاعل. يمكننا هنا أن نتخيل استعمارياً قديماً، فرنسياً أو بريطانياً مثلا، يعيش في خمسينيات وستينيات القرن الفائت، ويعزي نفسه بأنّ حركات التحرر الوطني في الشرق اﻷوسط لم تكن عفوية وإنما كانت مدبرة من أعداء خارجيين.
الحقيقة أن الشعوب تتأثر ببعضها، خاصة لو كانت تتكلم اللغة نفسها، أو تتجاور جغرافيا. وهذا التفاعل يدخل لمستويات أكثر دقة في حالة المجتمع المصري الذي يتأثر فيه أفراده ببعضهم البعض، سواء بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أو لوجود خلفية سياسية مشتركة بين جميع أفراده، قائمة على مشهدَي 25 و30 باﻷساس.
يحكي آباؤنا أن توقيع معاهدة كامب ديفيد قد قوبل بالذهول. صمت ثقيل ران على القاهرة أثناء مشاهدة نزول السادات لمطار بن غوريون ثم خطابه في الكنيست. ويُحكى أن المناضل ابراهيم منصور سار وحده في شوارع وسط البلد بلافتة مكتوب عليها "تسقط كامب ديفيد". شخص واحد يسير في شوارع القاهرة بالسبعينيات احتجاجاً على ما يحدث، بالمقارنة بآلاف اقتحموا الشوارع في اﻷسابيع الماضية احتجاجاً على التنازل عن جزيرتَي تيران وصنافير للسعودية.
لا تخاف الطبقة الحاكمة اﻵن باﻷساس من مؤامرات القصور، كما كان دأبها دائماً، ولكنها تخاف من الجماهير (التي قد تحفّز بدورها مؤامرات القصور). والجماهير لا تني ترسل الإشارات، أولها، للمفارقة، كان في الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي وصل السيسي نفسه بمقتضاها إلى رئاسة الحكم، والتي شهدت لجاناً انتخابية ارتعب إعلاميو التلفزيون لفرط خوائها. بدأ العد التنازلي لشعبية الرئيس منذ لحظة انتخابه. ومن وقتها يأخذ مؤيدوه في التناقص، ويأخذ إعلاميون معروفون بولائهم للسيسي في تقديم الانتقادات تلو الانتقادات له. ومن لا يزالون على ولائهم له، يخفت صوتهم بالتدريج وتصبح مدائحهم للسيسي غير منطقية وتقابَل بالسخرية. بدا هذا واضحًا أشد ما يكون الوضوح في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ثم في قضية تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية.
بالتدريج تنمو في مصر سرديات متشككة في السلطة، سواء الدينية أو العسكرية أو اﻷبوية العائلية. حتى جزء كبير من مؤيدي السيسي يسود بينهم الإحساس بامتلاكهم للسيسي، فلو حابى اﻷخير الثوار مثلا، ولو بالكلام، يغضبون ويهددون بالتوقف عن دعمه، وفي يقينهم أنه سيخاف ﻷن إطاحة الرؤساء أضحت سهلة في السنوات الخمس اﻷخيرة. اﻹحساس بامتلاك الجماهير للرئيس لم يكن واردا أيام مبارك. وجود مبارك، في أغلب سنوات حكمه، كان بديهيا وغير مفكّر فيه، على عكس السيسي. كل من المصريين اﻵن يسأل اﻵخر ويسأل نفسه: "هل أنت مع السيسي أم ضده، ولماذا؟". يشعر محبو السيسي بالخذلان إذا ما خيب رئيسهم آمالهم، ويخترعون حججاً لتبرير مواقفهم، ﻷنّهم يواجهون سخرية الأصدقاء في الفايسبوك، أو الزملاء في العمل، أو اﻷقرباء في البيت والتجمعات العائلية. ومع تردي الوضعَين الاقتصادي واﻷمني، وتعرُض سلامتهم الشخصية وسلامة من يعرفونهم للخطر، يتحول الواحد منهم بالتدريج إلى معارض للسيسي.
ولكن، ومنعا من الإغراق في التفاؤل، نذكّر أن السيسي لا يزال يحكم مصر، وأنه سيظل يحكم ربما لفترة طويلة قادمة، وأنّ الخطاب الرسمي كله قائم على معاداة الثورة، وأن الثوريين مهزومون بشكل لم يسبق له مثيل منذ 2011. فقط مع هذا، لا يزال السوس ينخر جدار الصمت، ولدينا إشارات عديدة على أن القرقعة ستكون مدويّة.