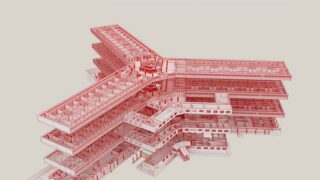كَمَن يكابد شهوة ممضّة، وبصوت ضجِرٍ آمر، باغتني طارق: بدّي (أريد) حكاية!
طارق الذي لا يعلم شيئاً عن تعليمات مركز إيواء النازحين في ريف دمشق، التي تمنع المتطوعين من الاقتراب من تفاصيل وخصوصيات الأطفال، عاجلني بأمر آخر: بدي حكاية ما فيها حرب! في المركز الذي لا أدري من أية مرجعية يستقي تعليماته، أوعزوا لنا أن نشاغل الأطفال عن همومهم بالنشاطات واللعب النهاري، سكتوا عن الليل وشجونه، ولم يفطنوا إلى احتمال طفل يطلب حكاية في عزّ الظهر ساهياً عن صخبنا البهلواني ونحن نحاول استيلاد فرح وسكينة من رعب ودماء!
ليد طارق قضية لا تخطئ هدفها (كم من الأطفال أصبحوا من دون أطراف!). فهي تعلقت بثياب نازحة من الحجر الأسود كانت مشغولة بالقبض على أيدي ثلاثة أولاد ورضيع تحمله مع صرة صغيرة. النازحة تبكي كلما سألوها عن طارق وتجيب: "والله لا أعرف عنه شيئاً ولا أتذكر متى وأين رآني وتعلّق بي.. يمكن من وقت ما وصلنا إلى السبينة، عندما وصلنا السبينة دارت اشتباكات وقامت القيامة والناس ركضت من كل مكان في فترة اختفاء الحواجز.. وبعدها لم نعرف ما حدث، احتمال يكون أحد الحواجز استولى على المنطقة ومنع بقية أهله من الخروج، يمكن يكونون هربوا في اتجاه آخر، ويمكن أصيبوا أو ماتوا لا قدّر الله"!
مرة أخرى يد طارق المعلقة بالهواء والرجاء أحكمت الحصار عليّ ولم تدعني أفلت من الوقوع في فخ حكاية أسرعت إلى اختلاقها متعثرة: كان في قديم الزمان (يا لبؤس الحكايات التي تتوسد التاريخ لتتنكر في زيّ الحكمة الصالحة للبقاء)، كان في عيلة (أستدركُ، فطارق وحيد)، كان في بنت (لقد وجدتُ ضالتي، الحديث عن البنات فيه متعة ربما تزيل غمّ هذا الرجل الصغير).. تطربني الفكرة وأتابع: كان في بنت حلوة (أي تمييز هذا، وماذا لو لم تكن حلوة، كم بدت لي مبتذلة وسقيمة محاولات الناشطين والناشطات التغزل بجمال الأطفال السوريين علّهم يكسبون اهتمام العالم من باب الجمال بعد أن فشلوا في ولوجه من باب الطفولة). أتلعثم: قصدي كان في بنت كويسة وشاطرة (كم من العبارات الجوفاء نحشو بها جسد الحكاية، ويمر في خاطري أن الحكاية هي خلاصة التجربة البشرية المنقولة للأجيال وهي نسغ الثقافة السائدة. ترى من هم أسياد البلد الآن، وما هي ثقافتهم وما هي الخلاصة على كل حال؟). بسأم منكسر داهمني طارق: هذه البنت ماتت أمها متل أختي، مو (أليس كذلك)؟!
مثل شظية طائشة اخترقت عبارة طارق رأسي. تعالوا واشهدوا كيف تطايرت الوصفات "الأممية" مثل غبار. تلك الوصفات التي يحشون بها النشطاء في دورات تدريبية داخل سورية وخارجها ويتجشمون عناءها نقوداً ومخصصات وكتيبات وأفلاماً وحجوزات فنادق وطائرات وبوفيهات.. وفي النهاية يأتي هذا الولد ويستدرجني ليخبرني في ثوان أن لديه حكاية، حكاية خاصة لم أفهم مقاصد مواربتها: ترى من التي ماتت؟ هل هي أخته؟ أم أمّ أخته؟ ولماذا لم يقل: أمي؟
مسؤولة الصحة التي قطعت خلوتنا ونحن نرتكب إثم الحكاية، جرّت طارق من يده لتدهن رأسه بشامبو القمل. كانت لديها طمأنينة راسخة بأن اللعب والحركة أفضل علاج للأطفال، وأنهما يزيلان هموم النفس بنفس السلاسة التي يزيل بها الشامبو قمل الرأس!
كان بالإمكان الركون إلى خبرات مسؤولة الصحة، لو لم تسجل واقعة أخرى في مركز الإيواء: أطفال صغار يهربون خارج سور المركز ويعذبون قطة! يا "لفضيحتنا أمام الرأي العام العالمي"، "الآن سنخسر تعاطف العالم مع قضايانا". متى سيفهم هؤلاء الأولاد الشرسون كل تلك الكلمات الكبيرة الجميلة عن الإنسان وحب الحياة والمصالحة والمسامحة والعدالة الانتقالية وأمثالها من العبوات الجاهزة التي نستوردها خصيصاً لأجلهم؟
خمسة ملايين طفل سوري في الداخل والشتات حسب الإحصاءات الدولية الرسمية، هم خارج التعليم، لكن يوماً ما، سيسخرون منا جميعاً وسيقولون بلغات وتعابير مختلفة: وكأن بلادنا لم تعرف تخليد الحيوانات وتأبيدها في قصصها وسيرها وشعرها وحياتها الفلاحية كما في تماثيلها وفنونها..
لكن المشرفين على المركز اكتشفوا أن العلّة في الأطفال وأحالوهم إلى الطبيب المختص. في سوريا، اليوم وغداً، فائض طلب على الأطباء النفسيين، ولا أحد يدري عن احتياجات الأطباء النفسيين وشغلهم الشاغل أن يعملوا على تكييف المريض مع واقعه، هل هم أنفسهم يقبلون الحرب؟ وهل على الناس أن تقبل هذه الهمجية؟ عالم كامل يرتد إلى بربريته لا يتوانى عن القتل والتنكيل والتعذيب، من غوانتانامو إلى الشيشان مروراً بأفغانستان وراوندا والعراق وتركيا وسوريا وايران والسعودية والبحرين، وبإطلالة خاطفة على تبرئة الجرافة من تهمة سحق جسد مقاوِمة سلميّة في فلسطين... كل ذلك والعيب فينا، نحن الذين لا نستطيع رمي عقولنا في البحر كما رُميت جثة عدو، والمضي إلى مساءاتنا مبتسمين ونحن نداعب القطط والكلاب! نعم نعم علينا أن نصدق حكايا الوحوش البشرية وهي تتلو بياناتها ليل نهار: أن البراميل المتفجرة لا تدمر إلا الذين يستحقون، وأن طيران التحالف الذكي يستأصل الأشرار كما تسحب الشعرة من العجين. الإعلام الدولي على كل شيء قدير، وحبل الكذب ليس قصيراً، إنه مثل العادة جراراً.
في البحث عن حكاية لطارق، أفزعني أنه لم يعد للسوريين حكاية، حكاياتهم التبشيرية عن الخير الذي ينتصر على الشرّ، تشظت بوابل قصف لا يدع مجالاً لالتماس فرج من السماء ورُجمت وأُحرقت بأيدي التكفييرين الذين يلاحقون ظلال عدالة كانت تأتي بلبوس ساحرة تنصف المظلومين. أما خاتمات الحكايا التي كانت تحرص على وأد الفضول والمعرفة والمتعة وهي تهلل لحكمة التحصّن في البيت، فقد دُفنت إلى غير رجعة مع البيت وسكانه.
في الحروب تتصدر الأرقام (والصور في أيامنا) مكان الحكاية، تفترس الخيال والوهم والآمال، لتدعنا نلوك العجز أمام حقائق صادمة، حيث تقول التقارير الرسمية الموثقة ان طارق أوفر حظاً من (17.268) طفلاً قضوا بنيران الحرب، بينهم (518) طفلاً خطفهم رصاص القناصة! وطارق ما زال يتنعم بشامبو قمل على خلاف أمثاله من (9500) الاطفال المعتقلين الذين ينضم القمل والجرب إلى قافلة الوحوش المتكالبة على نهش أجسادهم، وهؤلاء كلهم محظوظون لأنهم لم يكونوا من (95) الهالكين تحت التعذيب، وغيرهم من جرحى الجسد الذين يفوقون (280) ألفاً، ناهيك عن الغرقى في البحار والعالقين بالثلوج والذين يبيتون ليلة بعد ليال على الحدود والقاضين من الحرارة وانقطاع الكهرباء ونقص الدواء و... وما لم تذكره التقارير، أن الناجين من الأطفال داخل سوريا أو في الشتات لم يعودوا أطفالاً (تُزوَّج الصغيرات، ويُجند الصبيان وقوداً للحروب، وكثر من الأطفال تبتلعهم دوامة الحياة وهم يطلبون قوت يومهم) فقد أصبح لكل منهم حكاية طويلة معقدة لا نعرف تفاصيلها ولم تدنُ نهايتها ولن نبلغ الحكمة منها، تماماً مثل حكاية هذه الحرب.