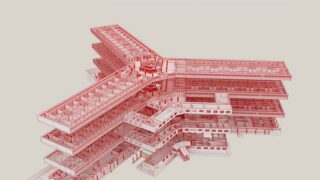سقطَ الحاجز بلا دماء، إذ لم تحدث معركة حين هدم مجموعةٌ من الشيوخ في شهر كانون الثاني الحاجز الأمني عند المدخل الغربي لمدينة السويداء (100 كيلومتر جنوب دمشق). بعد مرور أسبوع، أقام عناصر من الجيش النظامي خيمتين مكان الحاجز المهدّم ومكثوا فيهما كإجراء رمزي يقي السلطة من فقدان ماء وجهها. الحدث ليس عفوياً بما يكفي لتجاهل التقاطه. كما فعل الهدم لم ترافقه ثورة، ولا هي استمرت إلى ما بعده. فتلك الجغرافيا تجنبت التمادي في حراك آذار العام 2011، فلم توثّق إلا مظاهرات معدودة قمعتها السلطات بأذرعٍ من الأهالي المحليين.
لم يجرِ تبادلٌ للعنف بين المؤسسة الأمنية وبين الأهالي أثناء هدم الحاجز أو في ما تلاه. كما غابَ عن مضامين فعلِ الهدم أيُّ استفزازٍ للسلطة مما ينتج عن عواقبه تأديب في حسابٍ رياضي دقيق. ولعل تفكيك ما حدث إلى مكوناته الأولية يكشف تقدّم الحامل الديني للحراك المجتمعي في عمق المشهد الحياتي اليومي، وغياب فعل الحامل السياسي المقترن بالمعارضة المدنية. لكن لماذا أولئك الشيوخ هم من باتوا يتصدرون الفعل المجتمعي، لا سواهم؟
في غياب أدوار الدولة والمعارضة
الشيوخ الذين هدموا الحاجز الأمني يُعرفون محلّياً باسم "جيش الموحِّدين"، وهم ليسوا معارضةً سياسية للنظام القائم، لا بالمعنى الحرفي ولا بالمعنى المجازي. تأسس تجمعهم في أواخر العام 2011 بعدما استقطبهم شعار حماية المحافظة وسكانها المحليين بادئ الأمر، لكنهم اشترطوا أن يكون المنتسب إليهم متديناً. لذا نجد أن أغلبهم من الشيوخ الفتيان وحديثي العهد في التديّن، يتقاسمون تواضع المنبت الطبقي، ومستوى تعليميا لا يتجاوز المرحلة الثانوية.
تجمّعهم بقي كامناً في نسيجِ الحياة الاجتماعية، يتّسع تدريجياً مستعيناً بالإيديولوجيا الدينية، لكنهم كانوا يظهرون أيضاً كفعلٍ ماديٍّ ملموس في لحظاتٍ محددة مكّنتهم من جني ودّ المجتمع. حتى أن المعارضة المدنية المحلّية هللت لمواقفهم حين حرروا مجموعةً من الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية، كانت السلطات تحتجزهم في ظروفٍ صعبة خلال الشتاء الماضي في منطقة اسمها "سدّ العيّن"، أو حين شرائهم لصهاريج المحروقات من سائقيها بالسعر الرسمي، مستبِقين أن تصير حمولاتها في جيوب محطات الوقود، ثم عادوا فباعوها للناس مباشرةً بالسعر الرسمي خلال الشتاء الحالي. ومؤخراً، حين هدموا الحاجز الأمني بعدما وثّق في ممارساته بعض التطاول على كرامة الناس. فهم بذلك يكسبون غطاءً شعبياً، ترتفع معه أسهمهم المجتمعية، في ظل تراجعِ أسهم السلطة ومكانتها التي تتحاشى الصدام معهم خشيةً من دخولها في نزاعٍ يُفسد عليها شعار حماية الأقليات في سوريا. كما أنهم، وفي آن، أخذوا حصّة المعارضة السياسية من الشارع المحلّي حين لم يَستمِله شعار "الحرية" في مظاهرات العام 2011 القليلة، بحيث بدا الشعار حينها مع من أطلقهُ كبنيةٍ فوقيّة تنظيريّة تموضعت أعلى البنية المعرفية المتواضعة لعامة الناس، خلافاً لمضامين الاستقطاب الديني الذي استلّهم عناوينه العامة بدايةً من حماية الناس من التهديدات الخارجية المحتملة، ثم بالذهاب إلى قاع المجتمع مباشرةً، واستمالة المتضررين من الانقسام الطبقي الجديد. هؤلاء المشايخ أيضاً يهزّون أعلى الهرم الاجتماعي بما يمثّله من نفوذٍ دينيٍّ مجتمعيّ، في تكرارٍ موضوعي لحوادثٍ تاريخية مماثلة.
التاريخ يدور ويتكرر موضوعياً
يتزعّم الشيخ وحيد البلعوس جماعة "جيش الموحدين"، ويتقاسم معهم منبتاً طبقيّاً متقارباً، إذ كان يعمل في سلك الشرطة قبل أن يتقاعد ويكرّس حياته للعمل الديني. يعيش في بيتٍ متواضع مع والدته، لا أملاك يديرها، ولا حيازاتٍ زراعية واسعة تعود بإيرادات عليه. لكن تنامي نفوذِ جماعته على الأرض بدأ يُقلق الزعامة الدينية التقليدية، وهي التي تنحدرُ من منابتٍ طبقية تملك حيازاتٍ زراعية، وتدير أعمالاً تجارية واسعة تدرّ عليها الأرباح من الخارج، وتتوارث منصب الرئاسة الروحية للطائفة.. فسارعت إلى إدانةِ "جيش الموحدين" بحجةِ نفورها من حادثة هدم الحاجز الأمني. وبيان الإدانة جاء رسمياً، وموقّعاً من قبل الرئاسة الروحية للطائفة.
هذا الصدام غير الظاهر بعد بصورةٍ تناحرية جاءَ نتيجةَ عجز القيادات التقليدية عن التقاط مكوّنات اللحظة الراهنة، بما تحمله من تناقضات مزمنة تخصّ غياب العدالة في توزيع الدخل الوطني، والمستوى الشحيح من الكرامة الإنسانية. ثم بتأخرّها عن اللحاق بالاصطفافات الاجتماعية الجديدة الناشئة من ظرف الحرب خلال أربعة أعوام.
لم يكن الصدام بهذا المعنى هدفاً قائماً بذاته، وليس حدثاً هجيناً أو طارئاً، إذ نجد أوّل مقارباته الموضوعية في الربع الأول من القرن التاسع عشر بظهور شخصية الشيخ إبراهيم الهجري وتطورها من كاتبٍ بسيط عند يحيى الحمدان، الزعيم السياسي للجبل وقتذاك، إلى أولِ رئيس روحي للطائفة، ومن ثم منافس على القيادة السياسية فيما بعد. لقد انحاز فكر الشيخ ابراهيم وسلوكه إلى عامة المجتمع، لا إلى زعاماته، فتنامت شعبيته إثر رفضه تجنيد الشباب في جيش الحاكم العثماني إبراهيم باشا بين عامي 1838 و1840، وإثر اختياره الوقوف إلى جانب الفلاحين المضطهدين في الإقطاعيات الزراعية للحمدان. هذا التناقض في عمق العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية أعادَ تدريجياً صوغ قيادةٍ سياسية - طبقية جديدة.
بعد ذلك بنحو قرن، أيقظَ الحس الراديكالي العميق لسلطان الأطرش (أصبح فيما بعد القائد العام للثورة السورية ضد الفرنسيين) قلق السلطة الدينية الرسمية بعد صياغته لاصطفاف شعبيّ جديد حوله، يتجاوز حدود الطبقية الإقطاعية في ثنائية الفلاح الأجير / والإقطاعي الصديق لسلطة الانتداب الفرنسي. فاقترن قلقها وقتذاك ببيان رسمي صدر في العام 1922، أدان قتل سلطان الأطرش وجماعته لأربعة جنود فرنسيين وتبرّأ من فعلتهم تلك، وحمل توقيع شيوخ الرئاسة الروحية مجتمعين، وكانوا الشيخ حسن جربوع، والشيخ أحمد الهجري، والشيخ محمد أبو فخر، والشيخ علي الحناوي.
نحو الدويلات الدينية
ينتظم "جيش الموحدين" كقوة محسوسة في الواقع من دون أن يكون له مقرٌّ واضح، لكنه يظهر من بين شقوق الحياة الواقعية، فيطفو على سطحها في لحظات محددة، ثم يعود وينسل إلى عمقها. بالكاد يمكن توثيق حضور هؤلاء الشيوخ المقاتلين في تفاصيل الحياة اليومية، لكنهم القوّة الوحيدة المنظّمة على الأرض، تقودهم إيديولوجيا واضحة وإن بملامح دينية، ما يجعلهم، وبوفرتهم العددية أيضاً، قادرين على تكوين بديل للسلطة السياسية القائمة في حال تفككها، وتقسيم الجغرافيا السورية إلى مقاسات دينية ومذهبية تُهلك تاريخنا، وتُهلكنا معه.