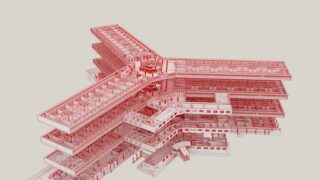يُجدي بعدَ مرورِ ثلاثِ سنواتٍ على بدايةِ حراك آذار / مارس في سوريا تفحّصُ الناتج الواقعي الكلّي لهُ على الأرض، وبلا الخوضِ في إشكالاتهِ التوصيفيّة وإعادةِ بحثها. لقد كان شاقاً منذ البداية على المعارضين الذين انتموا خلال العقود الماضية إلى معتقلات السلطة، وإلى أحزابٍ محظورة وضعيفة الاستقطاب الجماهيري، إخراج معادلات تلك الثوراتِ في صيغةٍ تطابق معطيات الداخل السوري بما فيه من بنى اجتماعية - اقتصادية اندمجت منذ مجيء البعث إلى السلطة عام 1963، في جسمٍ أوحى بأنه شبه متجانس، تدير فيه المؤسسة الحزبية والأمنية عقله الجمعي، وتُعفيهِ من التفكير. بدا شاقاً أيضاً على المعارضة السياسية المعزولة عن باقي بنى المجتمع بفعلِ الدولة الأمنية العميقة في سوريا، التكّهنُ بالطريقة التي سيصل فيها الفعل الثوري العربي إلى بلدهم، ومن أين سيبدأ، وكيف؟ حينها لم تكن المعارضة السياسة الحقيقية تملك، وهي غير التي تمّت صناعتها على عجلٍ بعد بدء الحراك، التصورات الكافية عن نوع الصراعِ الذي يمكن أن تخوضهُ مع السلطة القائمة، وعن نتائجه، وكلفته، وعن مدّته الزمنية.
الاستدراج إلى الوهم
حملت لحظةُ النزول إلى الشارع في آذار / مارس قبل ما يقرب اليوم من أربع سنواتٍ الكثيرَ من التردد والحيطة إثرَ صعود نجم الاسلاميين إلى الواجهة في انتفاضاتِ الدولِ الأخرى. لقد تريّث العديد من المعارضين في تصديقِ الصيحات المنتفضة، وفي تصديق براءتها، أي من أنّها تنتمي إلى الوجع السوري لا إلى سواه، وليست بتمويل خليجيّ أو غربيّ. لكن الحراكَ الذي بدأ من مدينة درعا (100 كيلو متر جنوب دمشق) خلافاً للتوقعات التي انتظرتهُ طويلاً، ظلَّ عاجزاً عن إقناع دمشق العاصمة السياسية، ومعها حلب العاصمة الاقتصادية، بجديته وبجدواه. وخلافاً لما جرى في مصر وتونس وحتى في اليمن، أمّنَ حراك آذار / مارس في سوريا كلَّ متطلباتِ الانقسام الداخلي، وشدّها بإحكام إلى مدارات حوله وحول السلطة التي يقارعها. ذلك الانقسام العمودي المؤلم الذي حلَّ في الحياة اليومية اعتباراً من الأسرة الواحدة، وصولاً إلى مكانِ الدراسة أو العمل، صار أكثر إلحاحاً وقسوةً حينما باتت معادلة النزاع المسلّح قائمةً على الأرض كأول نتاجٍ واقعي لهشاشةِ المعارضة، بما تمثّلهُ من رصيدٍ مجتمعيٍّ متواضعِ الأثر، ولسطوةِ السلطة في سوريا، وخصوصيتها بما تنتمي إليهِ من تحالفاتٍ إقليمية ودولية، وبما تديره من أهمية جيوسياسية. كذلك لم تكن الاسقاطات المنطقية لموازين القوى الدولية على الواقعِ السوري قد توضّحت بعد في مخرجات الحراك الشعبي الذي ابتلعه سريعاً النزاع المسلّح فتوقفت الهتافات المطالبة برحيل السلطة وإسقاط النظام، وصارَ الجميع رهينةَ صوتِ السلاح، وبدأ التسابق المحموم إلى الحسمِ الكليّ الذي يكفل الإطاحةَ بالآخر. ثم اتضح لاحقاً، في عامي 2013 و2014 بأنهُ وهمٌ تم استدراج الجميع إليه.
الواقعُ غير الشعارات الكلّية
لعّلَ العامان الماضيان قد ألحقا بالسوريين عسفاً شديدَ الأثر، إذ لم يقف أيٌّ من الطرفين المتصارعين على ضفةِ الشعب، لا السلطةُ القائمة برموزها، ولا معارضتها. فالسوريون النازحون ظلّوا عالقين في مصائرِ العوزِ والبردِ والتشرّد داخلَ مخيماتِ دولِ الجوار، فيما المعارضةُ السياسية الخارجية بقيت تنعمُ بحياةٍ لا تخصُّ بشيءٍ شقاءَ العيشِ في المخيمات، والسوريون في الداخل أفجعهم انهيار قيمةِ الليرة السورية، وتدهورُ قدرتها الشرائية، وشحُّ موارد التدفئة والكهرباء وندرتهما، فيما رموزُ السلطةِ القائمة لا يكابدونَ ما يكابدهُ عامةُ الشعب من شقاء.
التسابق إلى الشعاراتِ الكلّية كان ممكناً وقائماً بقدرِ إشكاليةِ الصراعِ الدائرِ في البلاد، وانتظارِ انتهائه. لكنهُ لم يأتِ واقعياً بالقدرِ الكافي. فلا هي "مؤامرةٌ كونية" بالمعنى "الميتافيزيقي" الذي أراده الشعار، كما لم يُراكم الشعب أدواتٍ نضاليةٍ كافية تجيز له "إسقاط النظام" برموزه السياسية والاقتصادية، ومنظومة علاقاته المعيقة لحركة تطور المجتمع ككل في حراك سلمي.
ثم لاقت مضامين حراك آذار / مارس تقنيناً قاسياً بعد منتصف العام 2013 حينما ازدهر النزاع العسكري أكثر في ترتيباتٍ إقليمية ودولية رعته وضمنت صيرورته، وباتَ الاسلاميون في تنظيمات "داعش" و"النصرة" والألوية الإسلامية المختلفة لاعباً أساسياً على الأرض، وانحسر دور "الجيش الحرّ"، وانجرّت قياداته إلى خصومات وصرعات براغماتية، وتقلّص نفوذه على الأرض على حساب ازديادِ نفوذ الاسلاميين، في حين بقيت المعارضة الخارجية حبيسةَ الشعارات الكليّة، مثلما بقيت السلطة القائمة حبيستها.
الحصاد
طرح الواقع السوري المرير خلال العامين الماضيين أسئلةً شاقةً على ذاته، مثلما أعاد طرح أسئلة شاقة تخصّ تبعات حراك آذار / مارس الذي بدأ عام 2011، فأراد بعد حينٍ "إسقاط النظام القائم"، لكن منطقه بدا عاجزاً في آخرِ عامين عن إنتاج حراك أبسطَ في مطالبه بكثير، إذ لم تعاين المناطق التي شهدت بعض "مسيرات الحرية" عام 2011 و 2012 والتي لا تزال تحت سيطرة السلطة، أيَّ تحركات شعبية تمسّ الاحتجاج على سياسة السلطة في إدارة الشأن العام. ويوجد على الأرض سلسلةٌ طويلة من المآسي تكفي لانطلاق ثورات شعبية كاملة أبسطها ندرةُ وسائلِ التدفئة منذ بدايةِ الشتاء الحالي ثم غيابها، أو استمرار متوالية الارتفاع في المعدلات العامة للأسعار بما يذبح دخولهم المحدودة.
ما يحدث واقعياً ليس استخفافاً بمضامينِ المطالب، أو تفاوتَ أهميتها كما لو أنها مقارنةٌ بين "الاحتجاج لبلوغ مجتمع الحريات السياسية" وبين "الاحتجاج على غياب مادة المازوت عن المدافئ المنزلية"! كلاهما شعاران يليق بهما النزول إلى الشارع، وإن اختلف حجميهما. فالمسألة هنا تخصُّ أكثر وجود حوامل اجتماعية حقيقية تستطيع الحراك لتحقيق مطالبها أيّاً يكن وزنها، والراجح أنَّ حراك آذار / مارس، وخلافاً لحراك المصريين في ثورتين متتاليتين، كان آنياً في سوريا، وحامله الاجتماعيٍّ أضعف من أن يبقيه حيّاً، حتى أن المعارضة الداخلية انزلقت إلى الفرجة على المآسي اليومية لحياة السوريين، فبدت وكأنها جزء معطّل من السلطة القائمة. لم يتكرر السيناريو المصري أو التونسي في سوريا، ولا حتى اقتربَ واقع حالِ السنواتِ الثلاثِ ونيف الماضية من السيناريو اليمني. فالقوى الحقيقية التي باتت متصارعةً على الأرض لا تميلُ هي ومَن يقف وراءها إلى صوغِ حلٍّ سياسي. هناك استقطابان لا أفقَ مشتركَ يمكن الحوار بشأنه بينهما ضمنَ المعطياتِ العامة الراهنة: السلطةُ القائمة بما تقبض عليه من جيش نظامي، وأجهزة أمنية ومناصرين حزبيين، وسوى ذلك من أدوات ووسائل، والإسلاميون بولاءاتهم المتفاوتة... ولا وجود لمعارضةٍ سياسيةٍ حالية تمثّلهم وتباشر الحوار مع السلطة القائمة، لا في الائتلاف ولا في المجلس ولا حتى في المعارضات الداخلية. البلاد دخلت منذ عامين نفقاً مسدوداً لا خلاص منه إلا بتوافقٍ دولي/ إقليمي يفتحُ نهايته الموصدة بعناية، وهذا لا يبدو أنه سيحدثَ قبل أن يصل الخراب في سوريا إلى مبتغاه.