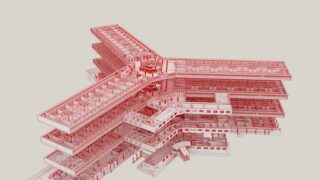سيبدو الأمر غريباً، حين خرج «مواطن» إلى شرفة منزله في أواخر الليل ليسقط السلطة بصوت عال، مطلقاً عليها أوصافا شنيعة. لم يُسَمِّ رموزها بأسمائهم الحقيقية بل بما يدل عليهم، ويستطيع معرفتهم عموم السوريين دون عناء. لن يسأله أحد من أبناء حيّ «بستان الباشا»: لماذا لا يخرج في تظاهرة، من تلك التي يسمونها «طيارة»، وهي لفرط طيرانها لن يشعر بها من تصادف عبوره بقربها، ومن تستوقفه يخالها نمطاً من المشاجرات المحدثة أو من التشجيع الذي تحظى به الفرق الرياضية المحلية بعد هزائمها أمام بعضها. لكن ربما يسأله من هو غريب عن الواقع السياسي السوري، ويعظه بأهمية الالتزام بالنضال السلمي، مشدداً على حسناته الملموسة كتخفيض «الكوليسترول» وتنشيط الدورة الدموية، وإدرار البول المشبع بالأملاح السامة. حينها تكون التظاهرة هي شكل من الرياضة السياسية، ونمطاً يحاكي الدوري العام للألعاب الرياضية.
يخرج أبو «حرب»، وفي تسميات أكثر دقة «أبو سلام» إلى الشرفة، كاسراً حاجز الجرأة بربع ليتر من العرق الممدد بمياه الفرات وثلجه، مجاهراً بإسقاط السلطة وموبخاً جيرانه النائمين، بكونهم قطيع خراف وهب حياته للطعام والتناسل والنوم والتهيؤ الديني الافتراضي للتضحية بما تبقى من حيواتهم على موائد الآلهة وولائمهم الباذخة.
يزداد غيظاً، لا لأن أحداً لم يرم بطانية الصوف ويرتدي ملابسه على عجل لينزل إلى التظاهرة، أو يخرج للشرفة من فوره، كما فعل «المواطن» ويبدأ بالهتاف التوكيدي، بل لأن أحدهم خرج إلى شرفة منزله وصاح به: «حاجة علاك فاضي، بدنا ننام!!» (ترجمة: يكفي ثرثرة فارغة نريد أن ننام).
لم يصغ لتحذيرات زوجته ونداءاتها المتوسلة، هي التي كانت تملأ البيت بأكياس المعونة من الثياب والأحذية والأطعمة والأدوية، التي تجمعها بدأب وصبر مع متطوعات أخريات، وتسعى بمجازفات كبيرة لإيصالها إلى من يحتاجها في الأرياف: «سلوكك أرعن وغير مسؤول، يفتح علينا أبواب جهنم، حين يستدعي مخبرو الحي دوريات الأمن ويبدأون أقله بتفتيش البيت ليجدوا ما يجدون، بعدها سيأخذوننا جميعاً إلى السجن وينسوننا هناك، إن لم يقتلونا من فورهم».
وحين كرر احتجاجه بعد أسبوع، سمع صوتاً هادراً يطالب بإيقاف هذا المجنون عن الكلام!! مما عنى أن المطالبة بإسقاط سلطة سياسية في هذه البلاد ،عمل يشبه الجنون. العاقل من يتكيف معها، ويتمسح إلى الأبد كقط ذليل بحذائها الأسود الطويل.
هذا كله قبل نهاية شهر أيلول من عام ألفين واثنتي عشر. بعدها سيغادرون البيت ويتبددون في أطراف البلاد وخارجها، لن يصعد «المواطن» إلى الشرفة وينادي على النيام بضرورة الثورة، لأنه لن يجد أحدا من سكان الحي باقيا ليسمع كلامه، ولن يجد شرفة، يخرج إليها آخر الليل ويقبض بكلتا يديه على سورها المعدني قبل أن ينادي على الخلائق. كل هذا وغيره سوي بالأرض.
ماذا تفعلين هنا يا أمي!!
على إفريز السور الذي يطوق «حديقة السبيل» الهانئة، جلست مكورة أمام صندوق خشبي، من تلك الصناديق التي تحمل بها الفاكهة من البساتين إلى الأسواق، وضعت فوق قاعدته المقلوبة بضاعتها: بضع قطع بسكويت وشوكولا وجوارب نايلون نسائية. نرى معطفها الثقيل من فرو الفيزون، ويديها المحميتين بقفازين أنيقين من الشاموا الناعم الأنيس، قبل أن نرى وجهها المعجون بخلائط الحليب والعسل ونسغ الخزامى، رأسها المغطى بمنديل حريري بلون سكر غير صاف، حذاءها المرتفع الحواف اللبادية والمنتهي بسوار صوفي يضيق على ساقيها...
نستدل أنها من طالبات الفرنسيسكان في الستينيات، وتتقن الفرنسية كما العربية، وتلفظهما بثقة المعلمين المكرسين لأداء مهمة تربوية متقنة. قرأت فولتير وراسين بلغتهما، بعد أن قرأت نثريات خليل مطران وجمال الدين الأفغاني وطه حسين. وزارت مع أسرتها باريس والإسكندرية وإسطنبول في تلك الأصياف المبهجة التي كان يكرسها الأبوان لأولادهما. وصافحت الممثلة ماجدة الصبّاحي حين حضرت مع الفيلم الذي شخّصت فيه دور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد. وعبرت على قبر من كان يوماً أميراً للشعراء ويستعيد المتظاهرون هذه الأيام في المدن والقرى بيت قصيدته «وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق» ووضعت بيديها باقة زهور بيضاء فوق ضريحه الحجري.
لكنها الآن وحيدة وبلا معيل. لم تلب نداءات الهاتف عن ضرورة الخروج من المدينة والالتحاق بإخوتها وأولادهم وترك «الجمل بما حمل». الحوالات المالية التي يرسلها أولاد إخوتها من فيينا تتعثر ولا تصل، وهي لا تقبل مد يدها إلى المحسنين، تفضل عليها الجلوس على الإفريز الحجري لسور الحديقة في برد «المربعانية»، لتحصل في نهاية النهار الثقيل على ما يعادل ثمن وجبة طعام، وعلى ذاك الإيناس البهيج الذي يحمله العابرون والفضوليون. قليل من يعرف أن عوائد عمل سنة كاملة، لن يعادل ثمن المعطف الذي ترتديه.
قبل حلول العتمة، تحمل صندوقها وتفرغ بضائعها في كيس أسود وتصعد بتعب إلى شقتها العالية الواسعة المظلمة. تضع الصندوق والكيس قرب الباب وتغلق أقفاله، وترمي عنها كل الألبسة الثقيلة. تغسل يديها وقدميها وتجول بنظرات غزال متوجس في أطراف البيت وزواياه قبل أن تمضي إلى سريرها وتتدثر بأغطية ذكرياتها الصوفية.
جلست بثبات وصمت، كأنها تمثال رخام، ووضعت أمامها على الرصيف، كل ما كانت قد أعدته بحنان أمومي لأولادها وأحفادها، ويفيض عن حاجة من بقي معها، مربيات الفواكه ومخللات الخضار البلدية، أوراق العنب ورب البندورة. لم يأت أحدٌ منهم ليأخذ حصته من تعبها ورائحتها وأنفاسها، ولن تصل لأحد هذه الحمولات من الأطعمة المثقلة بزجاج الآنية الأنيقة. ويبدد انقطاع الكهرباء الطويل المتواصل تعب الأيام وساعات التحضيرات الطويلة، ويدفنها بخشونة في سلال النفايات. الأمل وسواه يذوبان في ثلاجة بلا طاقة الكهرباء الضرورية. كل ما هو قابل للبيع يباع تباعا، الأقراط الذهبية وسلسال التهنئة بالوليد البكر، الطنافس الفارسية، التذكارات الأنيقة المصنوعة من الخشب والخلائط المعدنية والخزف والزجاج الملون. ليست وحيدة في هذا البيت الواسع في حي «الفرنسيسكان»، بشرفاته العريضة التي حولتها بدأب ومثابرة إلى حديقة معلقة، معها شقيقها العازب، المحتاج لجلستين أسبوعيتين لغسيل الكلى، وإبنتها المهندسة الأربعينية، التي دفعها الخوف من مخاطر الطرقات لطلب إجازة طويلة من العمل.
تستقبل الشاري العجول والجشع الذي يتصنع الانفعال والتقوى، وتعد له فنجان قهوة قبل أن تكلمه عن تلك الأشياء الثمينة بحمولاتها العاطفية وثقلها الوجداني. وتختم الكلام: أرجو أن تحافظ عليها، كأنما تأمل أن تستردها في يوم ما. في أعماقها تعلم تماماً أنها تبيع ضحكاتها الحليبية المنطفئة، ودموعها الساخنة الراهنة وأفراحها المخبوءة، أي كل ما هو غير قابل للاسترداد...
ـ حذاري !! إن لم تبيعيهم، سيأتي عاجلاً من يسرقهم برعونة وخسة. خير أن تتنعمي بالأموال التي تعود عليك.
وترتبك أمام محدثيها، لا لعجز في الرد أو استكمال الحوار، بل لأن ثمن المقتنيات يذهب تباعاً للمشفى ولندرة من يقدّر الأشياء المعروضة للبيع ويدرك أهميتها، ويملك مالاً لذلك. وهناك من يتفهم مخاوفها الافتراضية غير المصرح بها، ويغمغم «تخافين من سرقتها، لكن من يحمني أنا كذلك من السرقة بعد أن أشتريها». يومها، قال الطبيب المشرف على غسيل الكلية، أن اللقاء التالي سيكون اللقاء الأخير، إدارة المشفى ستغلق شعبة غسيل الكلية لعدم توفر الأدوية الضرورية للغسيل، واقترح عليها مشفى في بيروت لإتمام الجلسات وأعطاها رقم هاتف مقسمه، ووعدها بالتوصية بالمريض والتعريف على أحوالهم.
أمسكت بيد أخيها ولفتها حول كتفها، عبرت البوابة الخارجية ونزلت ببطء على الدرج الحجري، وهي تفكر بما بقي في مدخرات البيت لتبيعه.
في «كرم الطراب» حيث الطريق إلى المطار الدولي، ارتفع بيتها من قرميد رطب وأعمدة إسمنت تنوء بحمولة الأسقف. توفي زوجها منذ زمن تاركاً لها ثلاثة شبان وفتاة، بلا أي إعالة، تتسرب خلسة عنهم لتغسل أدراج البنايات وتنظف البيوت في الأحياء الراقية والمتوسطة، وتعود نظيفة وأنيقة بحمولات متواضعة من الألبسة المستعملة والأطعمة البائتة والقليل من المال الذي يتكفل بحلّ صدأ حديد العوز، في آلة حياتها المعطلة.
لكنها الآن في القبو الرطب المظلم، وهو المعادل للزنزانة الضيقة في مكان آخر يغلق إلى الأبد. بعد أن سمح رب عمل الشبان الذين صاروا جميعهم عمال خياطة في ورشة لصناعة الملابس، بالإقامة فيها والعمل، موفراً على صندوقه زيادة الأجور التي طالبوا بها للتعويض على ارتفاع تكاليف النقل والجنون المهول في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الحياة.
في الليل تتدثر بأغطيتها ولا تنام، ترى الجرذان تبحث عن أطعمتها فوق مواسير الصرف الصحي للبناء، وتربكها الصراصير الكبيرة تحت لحافها، وفي الصباح تتحدث مع أولادها عن غياب الضوء ونقص التهوئة المعززين بالانقطاع الطويل للكهرباء، وتسرب الأوساخ من فتحات القبو المحاذية للرصيف، وعن ضرورة العودة لتفقد بيت العائلة.
وبعد الانقطاعات الطويلة للكهرباء، ألغى المعلم أسبوعيتهم، وحسم أمر محاسبتهم على القطعة، وذلك قبل توقف إنتاج معامل صناعة الأقمشة والمعامل المكملة للإنتاج من طباعة وتطريز وسواهما، والارتفاع الكبير في أسعار الأقمشة المتبقية في المستودعات، والقابلة للنقل والبيع بعد عمليات النهب والحرق التي طالت المناطق الصناعية والأسواق التجارية: «بإمكانكم أن تبقوا في الورشة حتى تعودوا إلى بيتكم لكني لن أستطيع أن أوفر لكم عملاً بعد الآن»، خاطبهم من نافذة سيارته. وأكمل: «لعلّ الأمور تتحسن في الأسابيع القادمة». نزلوا إلى القبو وتحدثوا عن السبل والكيفيات التي تخولهم تأمين طعامهم وبعض حوائجهم، وجلست أمهم قربهم تسمعهم. بعدها صعدت أصوات نحيب متقطع من عمق القبو المقطوعة عنه الكهرباء.