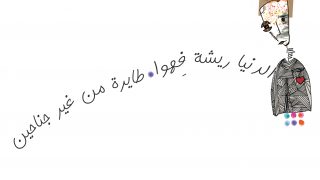كان عليّ أن أحتفي بيوم المرأة العالمي هذا العام بكتابة أكثر ذاتية بغية البعد عن الخطابية المطروقة والاقتراب من الحميمية. فقررت الكتابة عن والدتي: فاطمة أحمد بابكر أو بت احمد - كما اشتهرت. وقد يرى البعض أن المناسبة الأفضل لمثل هذا الحديث هي عيد الأم. ولكنه في الواقع أضيق من أن يشمل أبعاد تلك الشخصية والعلاقة. فهي حقيقة وليس مجازاً، تجسيد لما نردده بأن المرأة التي نتحدث عنها هي الأم، والزوجة، والحبيبة، والصديقة والزميلة. ومن مكارم الدهر أن يعيش المرء حتى السبعين وهو يستمتع بحنان أم تقترب من التسعين وقد ثبَّتت عمره في السابعة وتعامله كأنه ذاهب لليوم الأول إلى المدرسة غدا. فهذه فترة من العلاقة كافية للحب والتعود والتعلق، خاصة أن فارق السن ـ في الأصل ـ ليس كبيرا.
ختمت ثقافة القرية كتابتها على جسد الفتاة الصغيرة من ختان فرعوني، وشطوب أفقية على الخدين تميز قبيلتها، ثم وشم الشفاه لاحقا. ولم تعرف الطريق لمدرسة، وبدأت في اكتساب مهارات زوجة المستقبل المدبرة والحصيفة. وكانت أول الدروس تعلم «العواسة» أو صناعة رقائق الخبز السوداني (أو الكِسرة) على الصاج المحمي الساخن. وهذه بداية صهرها بالنار كامرأة واعدة. وقد تماهت «بت أحمد» مع الصاج والعواسة حتى تجاوزت السبعين رغم تكاثر المخابز الحديثة. وهذا درس اقتبسته منها وحورته من الصاج الى المكتبة والكتب: المثابرة والصبر والاستمرارية. ولم يكن للعواسة أوقات بعينها، فلو أنزل القطار ضيفا في الثانية صباحا، فهي تتجه بلا تململ للصاج وتشعل نار الفجر. وكان من عاداتها، وهي تعوس، الترنم بأغنية أو مديح نبوي، قتلا للضجر. هل هذه أخلاقية العمل والالتزام التي نسمع عنها؟ وقد تحملت مبكرا هذا العبء الذي دام عقودا، فقد جاء ابن عمها الذي عمل شرطيا بمرتب محترم ـ ست جنيهات ـ يطلب يدها، فتم الزواج فورا وهي لم تبلغ الخامسة عشرة. وانتقل بها من القرية إلى مدينة كانت مركز السكك الحديدية لحياة مختلفة عما ألفته حتى ذاك الوقت.
أفرحت ابن عمها بأن يكون المولود البكر ذكرا، بعد عام واحد فقط من الزواج. ولكنها توقفت لمدة ثمانية أعوام، كانت هي الجحيم نفسه مع ضغوط لضرورة تطليق المرأة العاقر أو غير الولود. وصارت أكبر مخاوفها أن يأتي والدها بزوجة ثانية (أو ضرة). وصمدت «بت أحمد» طوال تلك السنوات العاصفة من دون أمان ووسط تهديد مصيري. وهذه عظمة أخرى وصمود حققته بسلاح ثقافة الزوج السائدة، ففي بحثها عن السبب، استقر الرأي بأنها تعرضت لسحر في فترة النفاس (أو ما يسمى كبسة). ولأن السحر يطرد بالمفاجأة أو بما هو غير معتاد، فلم تتردد في التجريب. وكانت من ضمن محاولاتها فك الكبسة، حضور قداس في كنيسة مار جرجس، أو النظر لتدفق فيضان مياه النيل عند فتح علب الخزان. ورغم أنها ممارسات مسيحية وفرعونية مخالفة لصحيح الدين، لم يمنعها أهلها المتدينون عن ذلك. وللمصادفة، جاءت المولودة بعد توقف طويل فاتحة الطريق لخمسة أشقاء. وجعل هذا الانتصار من «بت أحمد» شخصية قوية بل متسلطة بعد سنوات الخوف والتهديد. وانتزعت مكانة جعلتها صاحبة كلمة نافذة. وصرتُ أطلق عليها لقب «الكنداكة» وهي تسمية ملكة كوش السودانية خلال الفترة من سنة 40 ق.م. حتى 10 ميلادية، وقد حاربت الرومان في أسوان.
تعلمت من مدرسة الشاعر حافظ إبراهيم كثيرا، وصرت أتساءل دائما: كيف استطاع الكثير من الأمهات القرويات الأميات بناء رجال ونساء، وتأهيلهم لمهام صعبة في هذه الدنيا؟ لم تتعلم بت أحمد في المدارس، لكنها عوضت التعليم النظامي بالحكمة. فقد اكتفت مدارسنا بتقديم المعلومات مهملة الحكمة وهي أحيانا تقتل الفراسة والفطنة. كنا نحاول أن نخفي عنها بعض الأسرار وتكشفها سريعا. وتقول بزهو: انتو قايلين نفسكم أفهم مني عشان ما دخلت المدرسة؟ والله أنا أكتِّف (اربط) النمل! وما زال أصدقائي القدامى يسألونني: كيف والدتك التي تكتف النمل؟ وبالفعل، فقد تابعت ورعت بنجاح سبعة من الأشخاص، أربعة أولاد وثلاث بنات، وزودتهم بخصال طيبة. ولكنني كنت وما زلت أحظى بالحب والتفضيل بحكم الاقدمية أو طول العشرة، ولأن الذكريات المشتركة خصبة، ولنا الاثنان ذاكرة تسمح لنا بالاستعادة ومعاودة المتعة الماضية. والأهم من ذلك، استمرار أثر دروس الطفولة. فقد تعلمت حينئذ الدرس الذي أوصلني للإيمان بالاشتراكية والعدالة وحب الناس، ماشيا في طريق سهل وقصير: الممارسة والسلوك اليومي.
فقد كنا نسكن في بداية حياتنا في منازل الشرطة وهي شبه معسكرات (تسمى القشلاق). وكان الجميع في مستوى طبقي واحد، لا يملكون الكثير واحتياجاتهم محدودة ويمدون أرجلهم قدر لحافاتهم. وفي هذا الجو منعتني بت أحمد أن أقول لأقراني من الأطفال: هذا حقي وذلك حقك، أو لا أعطيك حقي تلعب به. وعلى المستوى الأكبر، فقد كان هذا السكن المتقارب بمثابة «كومونة» جماعية في الكثير. لذلك، لم تكن تمانع في حالة عودتي من المدرسة لو شعرت بالجوع، أن أتغدى وأرتاح في أي بيت. ولم أكن أعاقب على هذا السلوك، بل تشكر أمي صاحبتها التي استضافتني. وأضعفت هذه السلوكيات فيّ كثيرا رغبة التملك وشعور الأنانية، ربما من دون أن تقصد ذلك. كما كان منزلنا أقرب للسكن الداخلي، يرتاده الكثيرون طلبا للنوم أو الطعام. لذلك كان تعاقبني إذا سألت عن سرير (أو عنقريب بالسوداني) منفصل في حالة وجود ضيوف أو ترددتُ في مشاركة الآخرين في سرير، أو حتى في وضع مرتبة على الأرض. ولكن هذه الحياة الجماعية أدخلتني لاحقا في خيار صعب: كيف أكون فرديا وليس أنانيا؟
تشارك بت أحمد في كل النقاشات السياسية من خلال التلفاز والإصرار على أن نقرأ لها الصحف. ولها قاموس مميز للأسماء الخاصة بالرؤساء والبلدان، فهي تنطقها بطريقة خاطئة وتصر على تسمياتها وترفض أي تصحيحات ونستخدم نحن ـ مجبرين ـ تسمياتها الخاطئة لكي يستمر الحوار. وترجع هذه المكابرة إلى أن الذكاء الفطري أو قل الغريزي يميل لتكوين ثوابت وقناعات عند صاحبه، ويعتبر التراجع والمراجعة عيبا كبيرا يقلل من الكرامة، رغم أنه يكشف عن قوة الشخصية. ولكن الغريب انتشار هذا السلوك وسط المثقفين الحداثيين! وقد ساعدت المناهج التعليمية البنكية أي القائمة على الحفظ والتلقين في تكريسه.
تمارس بت أحمد شكلا من العلمانية الشعبية - لو صح التعبير ـ فهي لا تميل لأحاديث الفقهاء والمشايخ في الإعلام. ولها تعليقات جريئة. فعندما تسمعهم يروون كثيرا من الأحاديث النبوية، تقول: «والله الرجال ديل بكضبوا (يكذبون) جنس كضب (كذب) عن النبي، يقولوه القالو والما قالو». وتعلق على آخر يتحدث عن الجنّة: «شوف الراجل دا يتكلم عن الجنّة كأنه كان فيها أمس!». وقد أكملت فجوات دينها وبحثها عن المعنى والطمأنينة بالاعتقاد في «الزار» الذي تعقد له أحيانا حلقات وحفلات تلبس فيها الملابس الحمراء الصارخة وقد تدخن السيجار، وترقص على أنغام صاخبة، خاصة وهي يتقمصها «خيط» حبشي أو (لوليّا) التي تحب الصخب. وفي البداية تشاجرنا حول هذه الطقوس، ولكن في النهاية بدت لي مثل الدراما السيكولوجية التي تقوم بمهمة التنفيس وكسر التابوهات، فسكتُ ثم ساهمتُ في تكاليفها. واخيرا، كان من أهم قراراتها،عدم ارتداء الحجاب ولا النقاب. ولم تهتم بالنقد مثل امرأة كبيرة وما بتخجل ولا بتخاف الله. وهي ما زالت تجلس سافرة مع «أجعص» (أقوى) رجل وتجادله بلا وجل.
هذه صورة قلمية وذكريات عن امرأة شديدة التحرر والثقة في النفس، ولم تكتسب ذلك من الكتب ولا كونت منظمة مجتمع مدني ولا ساندت سيداو. وهي تشكك في تفسير هذه العلاقة العكسية بين زيادة التعليم ونقصان الوعي والاستنارة. وكثيرا ما أسأل نفسي: كيف كان سيكون حال بت أحمد لو دخلت مدارس التدجين الحالية؟ لماذا تغيب الحكمة في تعليمنا؟ ومن الأمثلة التي ترددها في التهكم على غباء المتعلمين الاجتماعي، قولها: القلم ما بزيل بلم. وعندما تشاهد طريقة جلوس النائبات الإسلامويات في البرلمان السوداني والوزيرات، تعلق: «شوفهم مدندنات كيف!» (المدندن هو المتبلد أو الخامد الذي لا يعبر عن ذاته سواء كلاما أو مظهرا).
تشكك بت أحمد في معركة «التمكين السياسي» حين رأت الوزيرة والنائبة مدندنة، وقد استبطنت الخضوع والاضطهاد. وقد وصفت إحدى «مثقفات» المرحلة بالكذب، حين سمعتها تدافع علنا عن تعدد الزوجات، باعتبار أنها لن تقبل العيش مع ضرة. لقد استحق جيل بت أحمد صفة جيل التضحيات والصدق مع النفس.