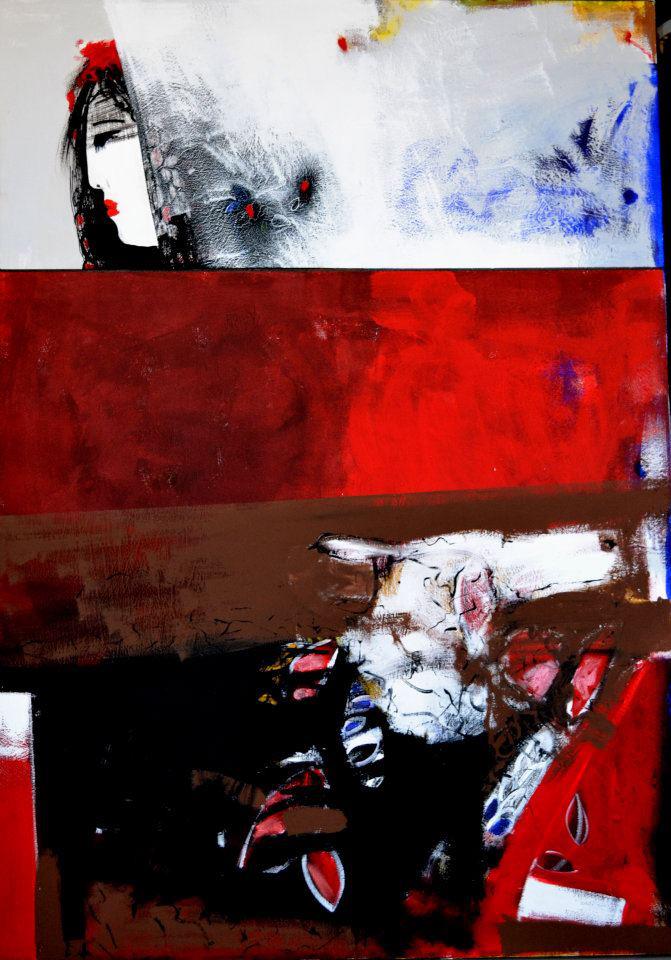من قصص الحب. لو كانت سلمى تتمتع ببعد النظر، لكانت بالطبع اختارت قصة حب والديها. لكن الحنق الذي التحفت به حياتها منذ البداية أعماها عن هذه الرؤية عمراً. كانت مشغولة بالوقوف على منصة القاضي، تحاكم الواقع الاجتماعي الذي تدفع هي ضريبته الباهظة جداً، تحاكمه بعنف وقسوة وبدون إعطائه فرصة الدفاع. أما الآن وقد تكرر المشهد الذي عاشته أمها معها هي بالذات، فقد استمرت في المحاكمة لكنها تريثت في تفاصيل الحكاية.
تنظر في وجه أمها لامع السمرة، في جسدها الممتلئ الذي يرتجُّ مع كل حركاتها، تتأمل في عزلتها الاختيارية، في حس الفكاهة الذي تتقشف فيه، في شعورها بالامتنان للحياة، في أسرارها غير المعلنة حتى لابنتها الكبرى، في عبوديتها المطلقة للأب، الأب الذي بلون قمحي صافٍ، شعر خفيف متناثر، ثقة بالنفس نابعة من صلابة التمسك بالقرارات، صمت عن سبق إصرار وترصد، رجل يعمل في مكتبة الدولة التي تغيرت أسماؤها مراراً خلال العشرين عاماً الماضية، رجل هجر ما كان يعرفه وارتحل إلى عالم صنعه بيديه واختار هو كل تفاصيله دون معارضة من أحد. أي حب يمكن أن ينشأ بين كائنين كهذين؟ بين رجل يعيش بين الكتب وامرأة لا تقرأ، بين رجل من عائلة مترفة طبقياً، وفتاة من "المهمشين" (يطلق عليهم في اليمن "الأخدام"، وهم شديدو سمرة البشرة وفئة في قاع المجتمع)، بين رجل يعرف ما سيرتدي الخميس القادم، وامرأة بالكاد تنتبه للتفاصيل. لم تفكر هي بهم من منطلق الحب، لكنها أرادت فتح ذاكرة أبيها لتعرف هذه التفاصيل، الأب الذي كان يقفل ذاكرته حتى عن نفسه هو.
الرجل الذي يصنع عوالمه، كان يصنع عالمها رغماً عن مقاومتها.
لن تكون أمها، فكرت كذلك منذ البداية. هي ليست أمها، رغم أن لها رائحتها وسمارها اللامع، عيناها السوداوان اللامعتان أيضاً، بصيرتها المذهلة. ولم تسعَ لتكون أبيها، هي فقط استساغت صمته الغامض، وقرأت كتبه المركونة في صناديقه الكرتونية، وفي مراحل صباها التي ناداها فيها الجميع ب "خادمة"، عادت لعزلة أمها، وللكتب التي احتفظ بها أبوها، ويبدو أنه كان قد اختلسها من محل عمله. كانت تقرأ في الشمس، تقرأ ما تفهمه وما لا تفهمه، هي فقط تقرأ الكلمات حين لا يكون لديها حصة في مشاهدة التلفاز. بعدها خبأت كل دفاتر المدرسة المستعملة، نسخت على الورق الأبيض المتبقي ما حفظته من الكتب، ثم صاغت كلماتها هي. وكانت دهشتها العظمى حين كتبت فقرة واحدة من صفحتين، كان فقرة واحدة بعشرات الجمل، حين أحضر أبوها الكمبيوتر "البيج" الضخم إلى المنزل، وقال لها بشكل عرضي: يمكنك الآن الكتابة هنا. كان يعرف أنها تكتب، وهي التي اعتقدت أن أحداً لا يعرف. بصفتها الأكبر بين الأولاد، أحكمت سيطرتها على الكمبيوتر، كتبت كثيراً وخبأت كل كتاباتها في مجلدات مخفية لا يستطيع أبوها الوصول إليها.
أي حب يمكن أن ينشأ بين كائنين كهذين؟ بين رجل يعيش بين الكتب وامرأة لا تقرأ، بين رجل من عائلة مترفة طبقياً، وفتاة من "المهمشين" (يطلق عليهم في اليمن "الأخدام"، وهم شديدو سمرة البشرة، ويشكلون فئة منبوذة في قاع المجتمع).
خلال ستة أشهر من التواصل، لم يطلب منها ولو لمرة واحدة أن تريه صورتها، لم يتحدث عن أيّ مواضيع جنسية، لم يعبر لها إلا عن انبهاره بالطريقة التي تكتب فيها. بدأت تشجعه بطريقتها ليخوض في الوحل المحرم وبالتالي تطرده من جنة كتاباتها، كما اعتادت.
لم تعرف عن الحياة الكثير، وفي عزلة أمها الاختيارية وصمْت أباها البارد، نشأت لتحب ما تحب وحدها، مراهقة باختياراتها الغريبة، تخشى العالم وتكره من حولها، تكره طبقتها الاجتماعية ولون بشرتها، تكره الأحياء التي ينتقلون للحياة فيها، تكره أعيادهم التي لم يزوروا فيها أحداً، والتي كانت أيضاً لتكرهها لو كانوا يزورون فيها أحداً. تكره شعورها بالتعالي على عائلة أمها وهو ذاته الشعور التي تكرهه من عائلة أبيها، وكثيراً ما تكره حقيقة أنها تكره فكرة زواج أمها وأبيها الذي تسبب في وجودها وسط هذه المعضلة الطبقية.
أنشأت حسابها المستعار على منتديات الكتابة الرائجة. كتبت بدون بهجة، كتبت غضبها كله وصبته على رؤوس الأشهاد، عنف غير مسبوق بكتابات أنثى باسم سلمى، ثم على الفيسبوك، سلمى فقط. لكنها كانت أكثر لطفاً هناك، خشيت أن يعرفها أحد، خشيت أن تكون هدفاً، خشيت كل ذلك الوهم الذي كان في منتديات الكتابة السابقة، لكنها بقيت بروحها الغاضبة المنكسرة.
لو كانت فقط في مكان آخر..
هذه الأمنية التي تختزل كل شيء. لو كان لها أن تحتفي بنفسها، أن تتخلص من غضبها، أن تتصالح مع العالم، ألا ترى فيه كل هذه البشاعة، لو كان لها أن ترى نفسها جميلة، لو لم تكن أمها مهمّشة، أو لو لم يكن لدى أبيها فرصة التعلم وتعليّمها... لا يمكن أن تجتمع هذه المتناقضات.
"قالوا أني سحرتُ أباكِ كي يتزوجني، جدتك أيضاً أحضرت لي ورقة السحر التي قالت أنها وجدتها مخاطة في حقيبة أبيك الجلدية. أنا لم أسحره، أمي كانت تحب الذهاب للساحرة، أنا لم أذهب قط، هو فقط كان يراقبني كل يوم أعبر فيه عائدة من العمل".
تشرح أمها باستمرار هذه النقطة في كل حديث عن العائلة، لا تستسلم. تقترح سلمى أن الحب ممكن، لكنها تريد أن تعرف المعادلة الشاملة. حين ظهر عليّ فجأة أمامها على الفيسبوك، بصورة وجهه النحيل، نظرته الضائعة الحزينة، وكمية التعازي غير المنطقية التي ينعى فيها قريباً أو صديقاً. تصاعدت دماؤها الساخنة كمن وجد دليلاً على جريمة، بدون خطة بدون هدف، أو بدون حتى التفكير في المعادلة الشاملة التي تحاول إيجادها. قررت أنها ستضعه في مرمى نيرانها، كما كانت تفعل في منتديات الكتابة، يائسة من أن أحداً سيحبها حين يعرف حقيقتها. كانت تنتقم من المجتمع بالطريقة الوحيدة التي تجيدها: كلماتها.
كانت قد خرجت بنسب مدروسة على طريقتها، وأعلنت أن المجتمع بكامله مريض جنسياً، وأن أفكاره المنحلّة ستقضي عليه يوماً بلا شك.
كتبت لعليّ، جرته في شبكة من محادثات سطحية بلا معنى، حتى تورط في حديث شبه يومي معها، مجازفاً بشراء باقات الإنترنت التي لا يستطيع تحمل كلفتها بتلك الكثافة، والتي كانت جديدة كل الجدة على ميزانيته. أما هي فقد حافظت على هاتفها المحمول مثلما تحافظ على دفتر كتاباتها الخفي، كانت تخشى أن يجد أحدهم ما فيه، أو أن ينكسر. لقد تحصلت على قيمة هذا الهاتف أيضاً بـ"كلماتها"، لكنها غير متأكدة إن كانت تستطيع فعل هذا مجدداً.
لم يكن عليّ أحد فتيان المنتديات.
____________
من دفاتر السفير العربي
اليمن بعدسة ريم مجاهد
____________
تلك الطبيعة الخام التي اكتشفتها بعد أن كانت قد ورطته، تكشفت لها عن فتى ريفي بسيط، ليس لديه أي تجربة في قصص الحب لا الواقعية ولا الافتراضية. خلال ستة أشهر من التواصل، لم يطلب منها ولو لمرة واحدة أن تريه صورتها، لم يتحدث عن أيّ مواضيع جنسية، لم يعبر لها إلا عن انبهاره بالطريقة التي تكتب فيها. بدأت تشجعه بطريقتها ليخوض في الوحل المحرم وبالتالي تطرده من جنة كتاباتها، كما اعتادت. لكن عليّ كان أغبى وأبسط من أن يعرف تلك اللعبة، ولم يكن ليقارن أبداً بكل الرجال السفلة والمتحرشين الذين اختبرت انحلالهم خلال مراحل المنتديات وغرف الشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كانت قد خرجت بنسب مدروسة على طريقتها، وأعلنت أن المجتمع بكامله مريض جنسياً، وأن أفكاره المنحلة ستقضي عليّه يوماً بلا شك.
استثنت نفسها من كل قاعدة.
أما عليّ، الذي كان عانس قريته، وحامل جنازات أصدقائه وأصدقائهم، كاتب التعازي الأكبر، السبّاح الذي يلتقط جثث الفتيات من خزانات المياه، الباحث عن الحب، المعذب بفكرة المال الذي لا يستطيع إيجاد مصدره، عليّ الذي أصبح يصحو من نومه ليفتش عن رسائلها، وينام بعد أن يكون قد تمنى لها ليلة سعيدة، فقد وجد نفسه قزماً في حضورها، مشحوناً برغبة أن يكون أفضل، سارحاً في تهويمات الظهيرة القاسية، متخيلاً شكلها وتفاصيل يومها، مرتعداً من فكرة خسارة هذا الأُنس الذي حلّ في حياته من حيث لا يحتسب، دائراً في فلك كان قد وصفه بالجاذبية الساحقة للأنثى الغامضة المقتدرة. لم يستطع عليّ فهم هذه السرعة في فيضان مشاعره، اعتقد أنه التسلسل الطبيعي، ولم تشرح له سلمى أن هذه مؤثرات التجربة الأولى.
أخيراً، في تلك الليلة حين فكر علي أنه لن يكتب عزاءً لنفسه، ترك نفسه للموجة الأكبر. قرر أن مصدر المال السريع أمرٌ سيفكر فيه لاحقاً، وأن اللحظة حانت ليترك الشلال يأخذ مجراه. كان الشلال ذاته الذي تحاول سلمى قمعه، خائفة من البؤس الذي سيتسبب فيه لروحها، مُذلّة من كمية الحقائق التي إما أنها لم تقلها، أو أنها كذبت بشأنها.
موت
06-06-2019
نادية
14-06-2019
علي
27-06-2019