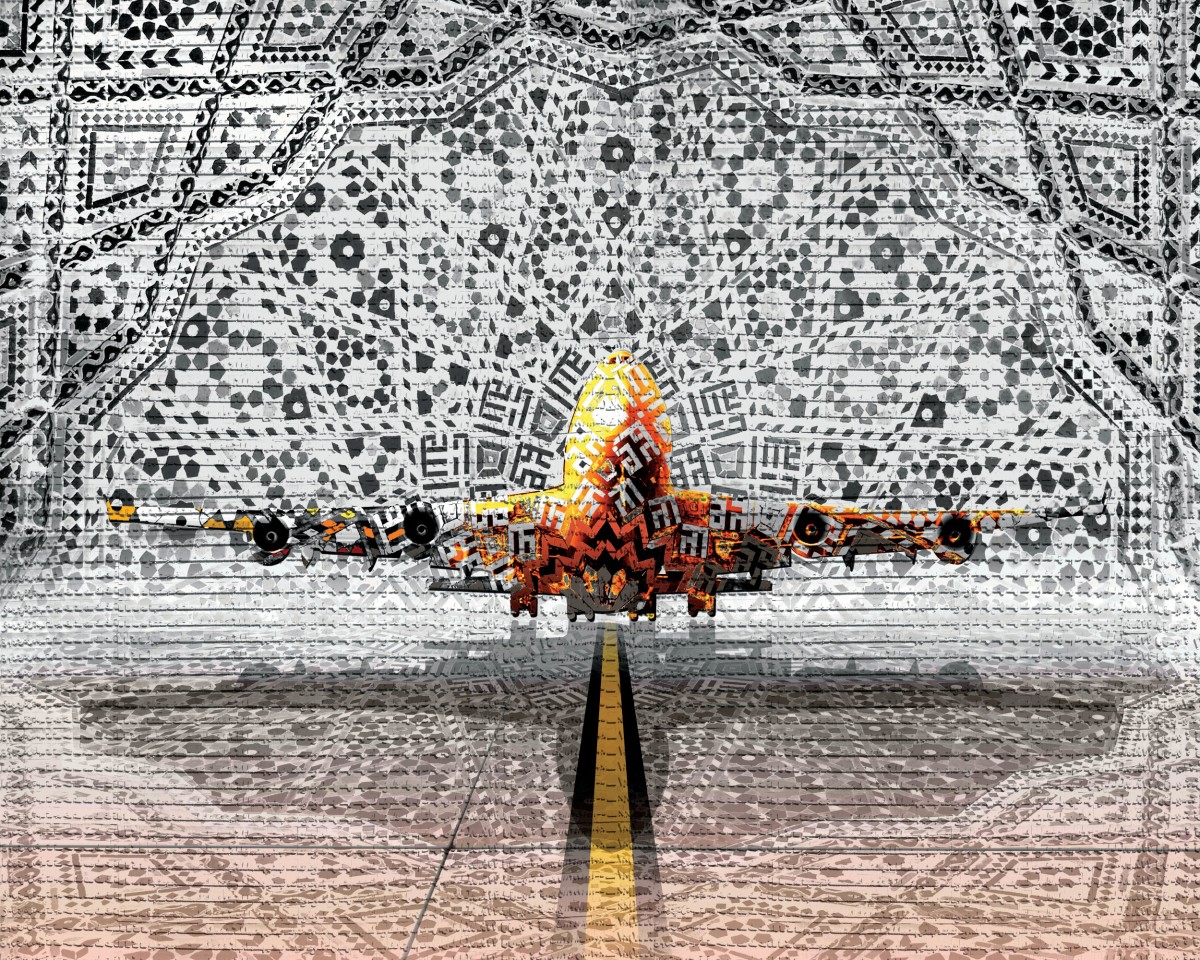بعد بدء العمليات العسكرية ("عاصفة الحزم") ضد اليمن التي تقودها المملكة السعودية بمشاركة عملياتية من بقية دول مجلس التعاون (عدا سلطنة عمان)، بذلت السعودية وحلفاؤها، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، جهوداً جدية لتسويق الحرب. وفي اليوم الثاني لبدئها، خرج شيخ الأزهر ليحمد الله على انطلاق "عاصفة الحزم" التي "استعاد العرب (بها) قوَّتَهم، واجتمعوا على قلب رجل واحد، وفتحوا صفحة جديدة في الشرق الأوسط، وأصبحوا الآن قوة رادعة يُحسب لها الحساب في مواجهة التَّحديات والمشكلات التي تمسُّ مِن قريب أو مِن بعيد كيان الأمَّة وحاضرها ومستقبلها".
حفلة زار "عاصفة الحزم"
أخطأَ من ظن أن شيخ الأزهر لم يترك مجالاً لمنافسيه حين رفع سقف المديح فوصف القصف الجوي لمدن اليمن وأريافه بأنه "صَّحوة عربيَّة بدأت تُدوِّي في المنطقة، وتحفظ مصالح شعوبها، وتحرس آمالَهم وطموحاتِهم". قيل إن الخيالَ يفتح آفاقاً ولكنه قد يشطح. ولهذا انتشر في قنوات الإعلام عدد من السّياسيّين و "المحللين الإستراتيجيين" لشرح كيف ستقود السعودية وهي في مقدمة الصحوة العربية الجديدة، جيشاً عربيّاً موحداً يمتلك أحدث التقنيات العسكرية.. بما فيها السلاح النووي (الذي ستحصل عليه السعودية، كما قيل، من باكستان). ورأينا خبراء في القانون الدولي يتولون مناقشة "تحديد الولاية القانونية للجيش العربي الموحد"، أي تعيين مهامه ومسؤولياته في البلدان العربية التي سيتمركز فيها. كما شرع عسكريون في الحديث عن سبل توحيد العقائد العسكرية المختلفة للجيوش العربية، وآليات توحيد القيادة والتسلسل الهرمي للقيادات. على هامش هذه الهيصة تمتلئ الأسواق بإعلاميين وشعراء وكتاب يدبجون مقالات وقصائد يرددون فيها ما يقوله المسؤولون و "المحللون الإستراتيجيون" ورجال الدين وخبراء القانون الدولي.
"مبدأ سلمان"
ضمن حفلة الزار المتزايدة صخباً يجري ترويج أن عاصفة الحزم، "فعلٌ يؤسس لواقع جديد صنعه الملك سلمان ويقوم على مبدأ سلمان (جمال خاشقجي، مدير "قناة العرب" السعودية الفضائية). في هذا الواقع الجديد تشكل عاصفة الحزم "الذراع الطويلة لمبدأ سلمان" حسبما يرى الباحث الكويتي والمدير التنفيذي لـ "مجموعة مراقبة الخليج" ظافر محمد العجمي. ومما كتب على هذا المنوال يمكن استخلاص خمسة أسس أسهمت في صياغة "مبدأ سلمان" كما يطرحه مروِّجوه. الأول أن السعودية دولة كبرى، بالمقاييس الإقليمية، ولديها مبررات لحماية مصالحها وتملك قدرات إستراتيجية (عسكرية واقتصادية وسياسية) لكي تتولى بنفسها حماية تلك المصالح. والثاني إن القدرات الإستراتيجية التي تمتلكها السعودية كافية لتمكينها من قيادة حركة لتغيير المعطيات الجيوسياسية في منطقة الخليج والجزيرة العربية بما يناسب مصالحها. وحسب "مبدأ سلمان"، فلا تحتاج دولة بقوة السعودية إلى انتظار موافقة أطراف أخرى معنية بالمنطقة، بل إن لها الحق في الحركة رغم معارضة تلك الأطراف. والأساس الثالث يتمثل في أن الولايات المتحدة الأميركية لن تجد مفراً من القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه عليها تحرك السعودية بإصرار وحزم تحت قيادة الملك سلمان باعتباره "زعيماً مستقلاً يتمتع بدعم شعبي وشرعية مع حزم وإصرار في المضي بما يريد". والأساس الرابع هو أن السعودية بتحالفاتها العربية/الإسلامية تستطيع احتواء نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، رغم أن القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في الخليج والجزيرة العربية تزيد على ما تمتلكه جميع بلدان المنطقة. أما الأساس الخامس فهو حاجة السعودية لضبط منظومة الحلفاء الذين قد "يتفلتون في زمن التراخي والتردد، بل قد يتقلبون في أهوائهم، ويستقلون بسياستهم".
لا يجد مروجو "مبدأ سلمان" سابقة له في التاريخ السياسي العربي الحديث. فحتى تدخل مصر لحماية الجمهورية اليمنية الوليدة في بداية ستينيات القرن الماضي ضد التدخل السعودي وقتها، لم يستند إلى ادعاء بحقها في حماية باب المندب مثلاً، أو إلى حجة الدفاع عن مصالحها الحيوية. لهذا يتجه مروجو "مبدأ سلمان" إلى تشبيه وضع السعودية بوضع الولايات المتحدة الأميركية. فكما يحق للولايات المتحدة أن تضبط حركة الأوضاع الدولية أو الإقليمية حسب متطلبات أمنها القومي ومصالحها، يحق للسعودية حسب هذا المنطق أن تضبط حركة الأوضاع السياسية في دول جوارها حسب متطلبات أمنها ومصالحها.
وهنا يسارع مروجو "مبدأ سلمان" إلى تكرار الإشارة إلى "مبدأ كارتر" دون غيره من المبادئ التي رُسمت على ضوئها السياسة الكونية الأميركية منذ الرئيس مونرو وحتى الرئيس أوباما. فمبدأ كارتر يتعلق بالتحديد بمنطقة الخليج العربي. وهو صيغ مباشرة بعد سقوط نظام الشاه الإيراني. فعلى أساس مبدأ كارتر تشكلت قوات التدخل السريع لمواجهة ما اعتبرته الإدارة الأميركية (وما زالت تعتبره) أخطارا محدقة تهدد حلفاءها في المنطقة. ولم تكن تلك الأخطار محصورة في الخشية من تصدير الثورة الإيرانية أو من التمدد الإيراني، بل وأيضاً من الإضطرابات الداخلية التي شهدتها بعض بلدان المنطقة، من قبيل ما حصل في المنطقة الشرقية وفي الحرم المكي في نهاية 1979.
ما بين التمني والتحليل
لو صدق ما يعرضه مروجو "مبدأ سلمان"، لأصبح المستقبل واعداً أمام العائلة المالكة في السعودية ولبقية المنطقة العربية في رعايتها. فتطبيق هذا المبدأ حسب المروّجين له سيكون مدخلأ لعودة القوة لمركز الثقل الحقيقي ولتصبح الرياض عاصمة أقوى الكيانات الفاعلة في المنطقة. ولا يحتاج كل ذلك، حسب الباحث العجمي، إلاّ إلى "خلق الآليات السياسية والعسكرية لتحقيق هذا المبدأ". وهنا مربط الفرس. فهل تستطيع السعودية حقاً أن تحتوي نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة لتصبح هي وحدها مركز الثقل فيها؟ بينما لا شك أن العائلة المالكة في السعودية تعلم أنها لا تشبه الصورة التي ترسمها لها مكاتب العلاقات العامة، وأنها لا تملك لا القدرة ولا الإرادة للقيام بما يُغضب الولايات المتحدة الأميركية.
تعتمد صدقية قيام دولة من الدول بإعلان مبدأ من المبادئ الإستراتيجية على تقييم الدول الأخرى المعنية لقدراتها الفعلية وعلى قوتها الذاتية لفرضه على أرض الواقع. وهذا ما حصل بالنسبة لـ "مبدأ بريجنيف" مثلاً، الذي أعطت موسكو لنفسها بموجبه حق التدخل في أية دولة من دول المعسكر الإشتراكي. وهو ما حصل بالفعل في تشيكوسلوفاكيا في 1968. وبالمثل أعطى "مبدأ ريغان" لواشنطن حق تقديم مختلف أشكال الدعم، بما فيه الدعم العسكري، لحركات المعارضة المسلحة ومساندتها في الإطاحة بالأنظمة المعادية للولايات المتحدة. وهو ما حصل بالفعل في نيكاراغوا في الثمانينيات من القرن الماضي. وفي الحالتين، ورغم معارضة دولية واسعة، تمكن الإتحاد السوفياتي آنذاك والولايات المتحدة من فرض إرادتيْهما. فالمسألة لا ترتبط بالرغبة بل تعتمد على القدرة.
لا تستطيع الدول الصغيرة والمتوسطة أن تفعل ما تفعل دولة عظمى مهما حاولت. فحتى فرنسا على سبيل المثال، لم تستطع أن تتدخل في 2013 لحماية مصالحها في مالي ومستعمرتها السابقة بدون دعم عسكري واستخباراتي من الولايات المتحدة، وبدون هِبَة مالية بقيمة 200 مليون دولار قدمها لها شيوخ أبو ظبي لدعم الحملة العسكرية الفرنسية. رغم ذلك كله، فلا بد من التأكيد على أن حال فرنسا ليس في سوء حال السعودية أو غيرها من دول الخليج. ففرنسا تعتمد على خبرات عسكرية متراكمة عبر تاريخ حربي مشهود. وهي فوق ذلك تمتلك صناعة عسكرية متقدمة وتستطيع أن توفر أغلب ما تحتاجه من العتاد وقطع الغيار اللازمة لإدامة واستخدام منظومات أسلحتها. أما السعودية، فلا تزيد الخبرات القتالية لقواتها المسلحة خلال الستين سنة الماضية عما راكمته من خلال الإشتباكات الحدودية مع جيرانها في شرق الجزيرة العربية وجنوبها. والسعودية، رغم مواردها المالية الضخمة والمخزون البشري الهائل في محيطها العربي، ما تزال رهينة للدول الغربية التي تستورد منها كل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات. فعلى الرغم من كل الإعلانات عن استقلال القرار الوطني أو الرغبة في أن تصبح دول منطقتنا قوة رادعة يُحسب لها الحساب، فلا يمكن تجاهل معيقات ذلك، بل واستحالة تحقيقه في ظل استمرار تبعية أنظمة الحكم العربية للغرب. فحتى في حالة الحرب الراهنة في اليمن، التي تعتبرها السعودية معركة مصيرية، فلا يمكن لأي مسؤول سياسي أو عسكري عاقل فيها أن يتجاهل احتمال أن تتوقف جميع العمليات العسكرية بقرار من الخارج. فبسبب تطور أنظمة التسليح الحديثة، يمكن أن تتوقف جميع الأجهزة العسكرية، ما عدا اليدوية، في حال امتنعت الولايات المتحدة أو غيرها من الدول المصدِّرة للسلاح عن تسليم قطع غيار مطلوبة لأجهزة التحكم والقيادة مثلاً.
وفوق ذلك، ثمة دراسات تشير إلى ان الهشاشة العسكرية للدول التي تعتمد على استيراد التقنيات المتقدمة، كما هو حال السعودية وبقية بلدان الخليج، تجعلها عاجزة عن الحركة في حال تعرضت إلى هجوم إلكتروني. هذه الهشاشة وذلك الإرتهان هما من جملة تداعيات التبعية المزمنة التي ارتضتها لنفسها بلدان التعاون الخليجي. وستتضح تلك التداعيات في حال استمرت عاصفة الحزم لمدة أطول من الأربعة أسابيع التي ربما خُطط لها اعتماداً على وهميْن: الأول هو أن محمد بن سلمان، وزير الدفاع وقائد "عاصفة الحزم"، سيتمكن من تكرار ما فعله الجنرال الأميركي نورمان شوارزكوف الذي قاد في 1991 جيشاً شاركت فيه قوات من ثلاثين دولة في تحالف دولي لتحرير الكويت. أما الثاني فهو ثقة القيادة السعودية بأنها قادرة مالياً وسياسياً على إقناع الجيشين المصري والباكستاني بأن يتوليا نيابة عنها مهمات الحرب البرية واجتياح عمق الأراضي اليمنية. ولقد أثبتت مجريات "عاصفة الحزم" مدى خطورة هذيْن الوهميْن. فليس في جعبة محمد بن سلمان ما كان لدى شوارزكوف من تأهيل عسكري وخبرات قتالية وطواقم قيادية. ومن جهة أخرى لا تمتلك السعودية ذلك القدر من القوة والنفوذ اللذيْن استطاعت الولايات المتحدة الأميركية بهما أن تفرض على ثلاثين دولة المشاركة في عملياتها العسكرية في 1991 وما تلاها.
مأزق إستراتيجي
تشير مجريات "عاصفة الحزم" إلى أن "مبدأ سلمان" يفتقد إلى ما يستند إليه، وأنه في أحسن الأحوال ليس أكثر من محاولة لمديح الملك الجديد وإسهام في حفلة إعلامية. فـ "عاصفة الحزم" ليست بداية "صحوة عربية جديدة" كما قال شيخ الأزهر. بل على العكس. فالقيادة السعودية أوقعت نفسها في مأزق إستراتيجي قد لن يكون من السهل عليها الخروج منه حتى ولو رأيناها ترفع راياتها على مبانِ في صنعاء. فبعد أكثر من أسبوعيْن على تدمير الدفاعات الجوية اليمنية وبدء القصف الجوي بمئات الطائرات من الدول الخليجية الخمس والدول المتحالفة معها، لم تحقق السعودية تقدمأ إستراتيجياً. بل إن بعض أخبار القصف قد كشفت أن أسلحة الجو في جميع بلدان التحالف لا تمتلك التجهيزات الملائمة ولا التأهيل الكافي لشن حرب جوية لمدة طويلة. فعلى سبيل المثال، تُضطر الطائرات العربية المغيرة على اليمن إلى إعادة ملء خزاناتها بالوقود جواً من طائرات الوقود التابعة لسلاح الجو الأميركي. أما حين سقط طياران سعوديان في البحر الأحمر، فلم يجدا سوى السفن الحربية الأميركية لتحديد موقع سقوطهما وانتشالهما... وهكذا!