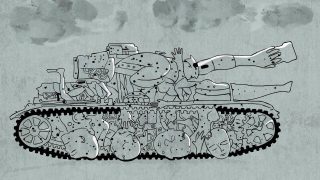في مثل هذه الأيام من كانون الثاني/ يناير من السنة الماضية، نشر أستاذ جامعة متقاعد في دولة الإمارات تغريدة في تويتر، تمنّى فيها أن تتوفر في الإمارات "حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجّمع...". لم ترُق تلك التغريدة للسلطات فقام جهاز أمن الدولة باعتقاله واحتجازه لمدة عشرة أيام. خلال تلك الفترة تحركت عدة منظمات وشخصيات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإدانة قمع السلطات الأماراتية لحرية الرأي والتعبير، ولتطالب بالإفراج عن الأكاديمي المعتقل. في المقابل تجاهل الإعلام الرسمي الخبر، بينما اعتبر من تناوله في مواقع التواصل الإجتماعي "إن من حق الدولة أن تحمي نفسها".
لحسن حظه، خرج الإستاذ الجامعي، الذي يُشيع المقربون منه أنه "مستشار ولي عهد أبو ظبي"، من معتقله ليعلن إنه كان في "رحلة مفاجئة وممتعة ومفيدة للغاية". بعد تلك الرحلة المفاجئة، صارت تصريحات الرجل وتعليقاته شديدة الإلتزام بالنص الرسمي، كما زاد التركيز فيها على التذكير بمآثر شيوخ البلاد وإنجازاتهم.
ليس غاية التذكير بمحنة الرجل الشماتة به وبأمثاله ممن ظنّوا إن موالاتهم للعائلة الحاكمة ستحميهم من عسف سلطاتها الأمنية. فلا أحد يستحق أن يُهان أو أن يُعاقب لمجرد التعبير عن رأي. إلا إن الإشارة هنا إلى تلك الحادثة وأمثالها تخدم رصد سلوكٍ صار شائعاً بين فصيل من المثقفين في منطقة الخليج العربي ومحيطها لا يجدون غضاضة في الدفاع عن سلطات بلادهم حتى ولو كانوا هم أنفسهم من بين ضحايا عسفها.
سطوة العوائل الحاكمة على المجال الثقافي
لا تنفرد الإمارات بالشدة في تعاطيها مع كل من يعبّر عن رأي لا يروق لولي الأمر فيها، حتى ولو كان الرأي لا يزيد عن أمنية بمناسبة حلول العام الجديد. ولا يختلف ما فعله جهاز أمن الأمارات بالأستاذ الجامعي عما تفعله الأجهزة الأمنية في بلدان الخليج الأخرى. بل هو يتكرر فيها بأشكال عديدة. خرج الأستاذ الإماراتي وهو ممتن لمحتجزيه على معاملتهم له التي ستختلف بكل تأكيد فيما لو كان ينتمي لتنظيم معارض. فلقد شهدنا في الأشهر الماضية أمثلة عديدة على مقدار الفزع الذي تشعر به العوائل الحاكمة في الخليج من كل رأي فيه شبهة الاختلاف عن الرأي الرسمي، حتى ولو كان أصحابه من عتاة الموالين وأشد المدافعين عن الأنظمة القائمة.
هناك سلوك صار شائعاً بين فصيل من المثقفين في منطقة الخليج العربي ومحيطها من الذين لا يجدون غضاضة في الدفاع عن سلطات بلادهم حتى ولو كانوا هم أنفسهم من بين ضحايا عسفها.
تتعدد أشكال السطوة التي تمارسها العوائل الحاكمة في بلدان الخليج العربية على المجالات الثقافية فيها على الرغم من أن أفرادها ليسوا من الفاعلين المميّزين في أيٍ من هذه المجالات. نعم، يخرج بين حين وآخر أميرٌ أو أميرةٌ بقصيدة تذاع عشرات المرات في أجهزة إعلام بلده، وقد يغنّي تلك القصيدة مطربٌ مشهور أو مطربٌة مشهورة، فتنشرها الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي. إلا إن هذه "الإسهامات الملكية" تبقى محدودة وموسمية لا يُعتد بأغلبها بل ويُنسبُ بعضها إلى أقلام مستأجرة مجهولة الإسم.
اقرأ أيضاً: حقوق الإنسان في الخليج.. مجتمع غائب أم خطاب غائم؟
على الرغم من ذلك، فإن سطوة العوائل الحاكمة في الخليج على المجال الثقافي في بلدانها وعلى المثقفين هي سطوة شاملة لا يفلت منها كاتبٌ أو شاعر أو فنان مهما علا شأنه أو شأنها، ومهما كبر رأسمالهم الرمزي وإتسعت دائرة المعجبين بهم. أما من يحاولون الإفلات من تلك السطوة فمصيرهم السجن أو المنفى أو ما هو أسوأ.
وتزداد قتامة هذه الصورة في أوقات الأزمات التي تتطلب أن تجند كل عائلة حاكمة من يتيسر لها من الناشطين في المجال الثقافي لمواجهة معارضيها أو لتسقيط أضدادها بين العوائل الحاكمة في البلدان لأخرى. ولقد كشفت أحداث السنوات الثلاث الماضية، بما فيها حرب اليمن والأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر، عدم قدرة أغلب العاملين في المجال العام الثقافي الإفلات من أداء الدور الذي تتوقع العائلة الحاكمة في بلادهم منهم أداءه. فالصمتُ في وقت الأزمات ليس من ذهب وليس النأي بالنفس خيار.
تجسير الفجوة
في أوج الطفرة النفطية في بلدان الخليج العربي برزت دعوات لمراجعة العلاقة بين السلطة والمثقف للوصول إلى أساليب ناجعة لما سمي بـ"تجسير الفجوة بين أصحاب الأفكار وأصحاب القرار". تقترح إحدى تجليات تلك الفكرة أن يمد الطرفان ــ أصحاب القرار وأصحاب الأفكار ــ ثلاثة جسور تتيح التواصل بينهما حسبما تقتضيه الظروف والإمكانيات والحاجة. أول الجسور ذهبيٌ مخصصٌ لكي يعْبره من يصطفيهم صاحب السلطان لتقديم ما يحتاجه من مشورة. وثانيها جسر فضي يتيح لمن يعبرونه هامشاً من الحرية للتعبير عن آرائهم مقابل سعيهم لإغناء الحياة الثقافية في البلاد وتحاشيهم توجيه النقد غير البناء. أما الجسر الخشبي فهو جسر لا يتيح لعابريه سوى أن تكف السلطة يدها عنهم وتضمن لهم وظائف يعتاشون منها وحدّاً أدنى من الأمان والقدرة على ممارسة العمل الثقافي حتى لو كان مقيّداً. مقابل ذلك يلتزم عابرو الجسر الخشبي بعدم المساهمة في التشكيك في شرعية السلطة أو عرقلة إنفاذ قراراتها.
أولئك الذين قاوموا الإغراءات بتفاصيلها لم يكن أمامهم إلا العزلة أو اللجوء إلى خليط من التقية والترميز والتورية والعمل السري لتمرير إسهاماتهم في المجال الثقافي.
إنتشرت هذه الفكرة بتجلياتها المختلفة في بقية البلدان العربية التي تعاطت معها حسب ظروفها وطبيعة توازن القوة بين مكوناتها. أما في بلدان الخليج العربية فلقد كان لها وضع خاص. فهذه البلدان كانت تحت الحماية البريطانية ولم تتخلص منها إلا قبل الطفرة النفطية بثلاث سنوات. ولهذا بدت فكرة تجسير الفجوة جذابة وواعدة بتحقيق طموحات عدة أطراف. فمن جهة كانت العوائل الحاكمة في حاجة لتجنيد الكوادر اللازمة لتشغيل "دولة الإستقلال" وتوسيع أجهزتها الإدارية والديبلوماسية والإعلامية والأمنية. لذا بذلت جهوداً في اجتذاب مثقفي المعارضة وتشجيعهم على الإنضواء فيها. ومن جهة ثانية، كان هناك آلاف المتعلمين من أبناء الشرائح الوسطى والفقيرة الذين تعلموا في الخارج وبقي أغلبهم قبل الطفرة النفطية عاطلين أو أشباه عاطلين عن العمل. ومن جهة ثالثة، كان هناك من بين نشطاء المعارضة وقياداتها من إقتنعوا بقدرتهم على "إختراق" السلطة وإصلاحها من الداخل.
اقرأ أيضاً: توثيق القمع والمقاومة في البحرين
استسهل بعض هؤلاء متطلبات تجسير الفجوة بينما رآها البعض الآخر مدخلاً إلى عالمٍ جديد ترعاه العوائل الحاكمة بما يتيسر من الوسائل، بما فيه المكرمات والمسابقات الثقافية والجوائز التقديرية. أما أولئك الذين قاوموا الإغراءات بتفاصيلها فلم يكن أمامهم إلا العزلة أو اللجوء إلى خليط من التقية والترميز والتورية والعمل السري لتمرير إسهاماتهم في المجال الثقافي.
لم يكن سهلاً تماماً تسويق دعوة التجسير في منتصف سبعينيات القرن الماضي بين مثقفي بلدان الخليج ممن اعتبروا أن إستقلال بلدانهم لن يكتمل بدون التخلص من إستبداد العوائل الحاكمة. إلا أن التأكيد على "حرية الإختيار" بين الجسور الثلاثة أعطت لمن أراد من المثقفين والنشطاء السياسيين، بمن فيهم من حملوا السلاح وعانوا لسنوات مرارة السجون والمنافي، فرصاً لإعادة ترتيب علاقاتهم بالعوائل الحاكمة. فلم يعد مطلوباً، كما قيل، من المثقف أو المثقفة أن يتخليا عن جميع قناعاتهما وإلتزاماتهما للمشاركة في بناء دولة الإستقلال. فمن لم يكن مؤهلاً لعبور الجسر الذهبي ولم يرغب في عبور الجسر الفضي فله أن يختار الجسر الخشبي.
المثقف الريْعي
في حكاية اعتقال الأكاديمي المعتبر تكمن عبرة تتخطاه شخصياً. فلقد كان بإمكان السلطة الأمنية إستدعاء الرجل لتوبيخه مثلاً. إلا إنها رأت أن تستخدم احتجازه لمدة عشرة أيام لتعلن ما قد لا يعرفه المستجدون في خدمة السلطة. فباعتقاله كانت تضرب مثلاً للناس وتعيد تذكيرهم بأن ليس لأحد عزوة أو هيبة دون رضاها.
وفي تلك الحكاية وفي مثيلاتٍ لها من بقية بلدان الخليج العربي يكمن إعلانٌ بأن الفجوة بين المثقفين والعوائل الحاكمة في الخليج باقية وتزداد اتساعاً كما وترتفع كلفة تجاهلها. وفيها يكمن أيضاً إشهار العوائل الحاكمة أن المجال الثقافي الذي ترضى برعايته وتمويله لا يتسع إلا لمثقفٍ من طراز خاص هو المثقف الريْعي. أي ذلك المثقف الملتصقٌ بالسلطة التي توزِّع الريع.
المثقف الريعي بهذه الخاصية هو فصيلٌ بذاته. فلا هو مثقفٌ تقليدي يحلم بالبقاء "فوق الطبقات وخارجها ومعبراً عن ضمير الأمة وعقلها". ولا هو مثقفٌ عضويٌ ينتمي إلى صلب طبقته (أو قبيلته أو طائفته) يعبِّر عنها ويعمل على تمتين تجانسها ويدافع عن مصالحها كما يراها.