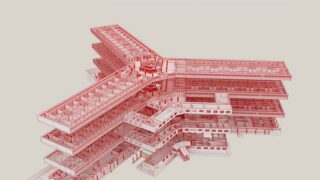بقيت بنيّة الدولة السورية ذات الطابع البوليسي قائمة داخل المناطق التي لم تشهد نزاعاً مسلّحاً، وبقي وعي الناس متأخراً عن صوابيّة استبدال العقد الاجتماعي القائم بآخر باعتباره انحيازاً موضوعياً لمجهود الحراك العام في تصويب نظرية السلطة ونظريّة المواطنة على السواء. ولعل السبب في ذلك أن السوريين يعيشون منذ سنوات حياةً متقهقرة جاءت كنتيجة حسابية لمجموع المغالطات التي بلغها الحراك الشعبي خلال انعطافاته الكثيرة ولمغالطات السلطة في تصديق نفسها كمعطى نهائي لا زال بإمكانه هضم المجتمع والسياسة معاً.
نصيب وافر من العدائية
المجتمع الذي حوّله النظام الحالي إلى نمطٍ سكانيّ معلّب داخل المنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب.. كان عاجزاً عن تطوير أدوات حراكه المناسبة، في حين تعاملت السلطة مع الحراك على أنه عمل عدائي هدفه إزالتها، وقد رأت بعينها نهاية أنظمة عربية كاملة في ثورات "الربيع العربي". لذا كان الصدام بين السلطة والمجتمع في سوريا قاسياً، تطوّر إلى نزاعٍ إلغائي قبل تدويله في عامه الثاني. لكن ما حدث كان كفيلاً أيضاً بكشف آليات الحراك المجتمعيّ المحدودة في مواجهة اقتدار الدولة البوليسيّة العميقة، فبقي مفهوم المواطَنة متعثّراً في مكانه، وبقيت مكوّنات السلطة المستبدة قائمة، ليدفع المجتمع بالدرجة الأولى ضريبة صراعٍ أعمى بين مكوّناته. مدنٌ كاملة تدمّرت وصارت تنتظر رأس المال الإقليمي أو الدولي ليعيد إعمارها، وكفاءات علمية وبحثيّة غادرت البلاد في موجات نزوحٍ وهجرة تعاظمت بعد العام 2014، ثم انخفضت القيمة الشرائية لليرة السورية الى الحضيض، وتفككت الطبقة الوسطى اقتصادياً واجتماعياً. وفي عمق المشهد القاتم أخذت الجريمة المنظمة تنتشر على نحوٍ واسع.
مواطنَة منقوصة الأركان
يفضي بحث علاقة المواطن السوري مع دولته إلى جملة نتائج تكشف عن انهزامٍ عميق في الوعي الاجتماعي أمام سطوة السلطة في سوريا. يخاف الناس في سوريا من السلطة ولا يزالون، بالرغم من إضعاف الحرب لبنية النظام الأمنية والعسكريّة. ويعتقد أغلبهم بأن السلطة والدولة هما كيانٌ واحد، فيخلطون التسميات بعضها ببعض، فيسمّون الدولة سلطةً بالخطأ، في أزمة خوفٍ مركّبة لم تُنقِص منها جرعة الحرب المشرعة على استفاضات دمٍ جديدة شيئاً، كما يخلط الوعي الاجتماعي بين حقوق المواطن السوري وواجبات الدولة، معتقداً إلى الآن بأن الدولة تمنّ عليه حين توظّفه، ويعتقد الكثيرون بأن للدولة كيان مادي مستقل عن المجتمع، كما لو أن لديها جيوباً مملوءة بالمال تدفع منها رواتب الناس الذين يعملون في الوظائف العامة. وهذا الاستلاب في تقصّي الواقع وفي تصويب فهمه يعود إلى نظرية الدولة كالأب الكليّ للمجتمع، وبعدها إلى نظرية الحزب القائد للدولة والمجتمع.
المجتمع الذي حوّله النظام الحالي إلى نمطٍ سكانيّ معلّب داخل المنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب.. كان عاجزاً عن تطوير أدوات حراكه المناسبة، في حين تعاملت السلطة مع الحراك على أنه عمل عدائي هدفه إزالتها
ولا يقيم الناس في سوريا وزناً لمواطَنتهم، إذ هم يعيشون على فكرة المنّة والمنحة، فالعمل تمنّ به الدولة عليهم، والراتب تمنّ به الدولة عليهم أيضاً، وتسمي لغة السلطة زيادة الأجور في سوريا بالمكرمة الرئاسيّة، ولا تزال السلطة تواظب على إسكات التفكير الاجتماعي بتبنّيها لدورٍ أبويّ وهمي قائدٍ للمجتمع، في استنطاقٍ لفكرة الأب وسلطته داخل الأسرة. ولا يمكن هنا إنكار نجاح النظام السوري خلال نصف قرن في تفكيك مكّونات المجتمع الحيّ وإلحاقها بهرمية ربّ الأسرة الكبيرة.
المواطن والدولة والحرب
تدل المواطَنة على عضوية الأفراد الكاملة والمتساوية في المجتمع. وهو مفهوم تطوّرت دلالاته منذ إعلان مبادئ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن الحكم البريطاني عام 1776، ثم في إعلان حقوق الانسان والمواطن الذي صدر في بداية الثورة الفرنسية عام 1789. لكن مفهوم المواطنة يظل قاصراً في المجتمعات التي تديرها أنظمة استبدادية، يتطلب تطوّره نضوجاً في الوعي الجمعي للأفراد، وهو ما لم يُثمره حراك آذار / مارس 2011 في سوريا، على الرغم من الإصلاحات الشكليّة التي أجرتها السلطة، مثل الدستور الجديد الذي تمّ إقراره أواخر شباط / فبراير 2012، وقانون الأحزاب الصادر مطلع آب / أغسطس 2011، وقانون الانتخابات العامة الذي صدر منتصف آذار / مارس 2014.
علاقة المواطن بالدولة لم تشهد تبدلاً، لا في الحقوق ولا في الواجبات. ظلّت ملتبسة تحمل كل التشوّهات التكوينيّة التي أكسبها لها حكم حزب البعث الطويل، لدرجة أن كل الأحزاب السياسيّة، بما فيها الأحزاب الحديثة التي تصنّف نفسها كمعارضة داخليّة، كانت عاجزة عن تنظيم مظاهرة شعبيّة واحدة، أو اعتصام احتجاجيّ على الأقل ضد الغلاء أو ضد غياب وقود التدفئة عن منافذ البيع الحكوميّة وتوافره في السوق السوداء، أو حتى في تنظيم وقفة احتجاجيّة على محتوى رغيف الخبز وسعره، أو على ساعات تقنين الكهرباء التي تشبه بلاءً لا نهاية له. لم يتحرّك الناس لا في العاصمة دمشق، ولا في أيٍّ من المحافظات التي يسوسها النظام الحالي. وهم بذلك يبذلون أقصى درجات اللامبالاة، يتّكلون على الدولة الأب حيناً، ويخافونها حيناً آخر، ثم ينفرون من واجباتهم، إذ أنّ شعورهم بالانتماء إلى الوطن واهٍ، يتصوّرونه السلطة والدولة معاً، وهم غير ملامين على ذلك، إذ أنّ محصلة حقوق مواطنتهم تكاد لا تذكر، لا يشعرون بقيمة كيانهم الفرديّ، فيتنازلون عنه لصالح كيان السلطة، وهذا مقابل شعورهم بأمانهم الذاتي. وبحسب الأرقام الحديثة التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية، فإن عدد المطلوبين لتأدية الخدمة العسكرية الاحتياطيّة في سوريا تجاوز 300 ألف مواطن حتى نهاية العام 2016، وجميعهم يرفضون الالتحاق بجهات القتال. وهؤلاء شريحة اجتماعيّة تتراوح أعمارها ما بين 23 و42 عاماً، وهم من كل الأديان والمذاهب بلا استثناء. وقد يكون للانشطار القائم، السياسي والمذهبي، دور في ذلك التخلي، وهؤلاء لم يدافعوا عن السلطة القائمة، ولا التحقوا بالقوى المناهضة للنظام، فبقوا في حيز الرمادية المعطلة لأي تعبير عن إرادة أو موقف كمواطنين.
يفضي بحث علاقة المواطن السوري مع دولته إلى جملة نتائج تكشف عن انهزامٍ عميق في الوعي الاجتماعي أمام سطوة السلطة في سوريا. يخاف الناس في سوريا من السلطة ولا يزالون، بالرغم من إضعاف الحرب لبنية النظام الأمنية والعسكريّة
ومثلما هي حقوق المواطنة في سوريا ضحلة المنسوب، كذلك هي واجبات المواطنة التي تعيش ضحالةً موازية: التحايل على دفع الضرائب مثالٌ آخر يقيس ارتباك العلاقة بين الفرد والدولة، فقد قدّر الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا مطلع آذار / مارس 2015 أن قيمة التهرّب الضريبي السنوي تصل إلى 200 مليار ليرة، وقد اعتاد دافعوا الضرائب في سوريا من تجار وصناعيين على اقتناء دفترين للمحاسبة واحدٌ يقدّمونه لموظف الضرائب ولا يكون حقيقياً، ودفترٌ آخر فيه النفقات والكُلف والأرباح الحقيقية. يعتقدون بأن الدولة تأخذ مالهم، فيحتالون عليها بإخفائه، وهذا يستبطن نظريّاً ضعفاً في حسّ بالمواطنة. لكن الالتزام بتلك الواجبات ليس أحد المسلّمات الجدلية التي تشرح لوحدها علاقة المواطن بالدولة، إذ أنّ شرط تحققها وهو اكتساب حقوق المواطنة بالكامل، ومنها الحق في محاسبة الدولة، وكشف الفساد والإشراف على الإنفاق العام.
يشعر السوريون بأن مواطنتهم مسلوبة منهم، لا حقوق يمتلكونها ليدافعوا عنها، أو ليقايضونها بالوجبات المترتّبة عليهم. وهم منذ ثلاث سنوات يبيعون بيوتهم أو سيّاراتهم ويسيرون على درب اللجوء الشهير من تركيا إلى الجزر اليونانيّة ليصلوا إلى أوروبا. لا يهربون من حياةٍ بائسة بقدر ما يستثمرون ظروف الحرب لإيجاد أوطانٍ بديلة، لعلّها تصير دائمة مع مرور الوقت.