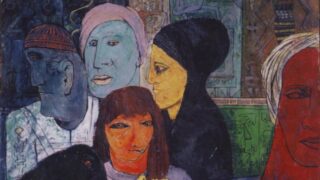غسان نداف | موقع "حبر"
07 تشرين الثاني / نوفمبر 2025
«الليلة هَز مفيش.. البلد كِلّها مهزوزة».
بهذه العبارة التي وصلتنا مسجّلة صوتيًا عبر «يوتيوب» نبدأ بالتعرّف على واقع مسرحية «نزل السرور»، ومن خلال المسرحية بدأ المجتمع اللبناني ولاحقًا العربي يتعرّف على لغة جديدة للمسرح الرحباني، وهو مسرح الابن: زياد الرحباني.
بدأ الرحباني عبر هذه المسرحية يرسم ملامح خطّه المسرحيّ الخاص به، واختارَ أن يبدأ بالإشارة للإضرابات العمالية والمظاهرات، التي لم تكن قد بدأت فعليًا في الشارع اللبناني وإنّما وصّفها ضمن المتخيّل، ليسائل موضوع الثورة وإمكانياتها في لبنان.
مع بدء الحرب الأهلية في بيروت، واصلَ زياد خطّه المسرحيّ وذهبَ لتأليف وإخراج مسرحية «بالنسبة لبكرا شو» التي بُنِيَت فكريًا على «نزل السرور» وعالجت سؤال الطبقة مع تعقيدات الواقع الطائفي دون أن يصرّح به. لاحقًا، أخذت مسرحياته تتطرّق إلى سؤال الطائفية بوضوحٍ، تحديدًا في مسرحيتيْ «فيلم أمريكي طويل» و«شي فاشل».
لبنان: ريع من نوع خاص
12-11-2020
وصلتنا جميع هذه المسرحيات مسجّلة صوتيًا، ولنا أن نتخيّل المكان والفعل الدرامي، أمّا ما انطبعَ منها فينا (غالبًا) هو الحوارات المسرحية والموسيقى والأغاني، وشكّلت مجتمعةً ملامح خاصّة لمسرح زياد الرحباني وخروجه عن مسرح العائلة. تناقش المقالة ذلك من خلال تتبّع لحظة الخروج في مسرحية «نزل السرور» وأبرز ملامحها، ثمّ التوقّف أمام سؤال الاغتراب والاستغلال في مسرحية «بالنسبة لبكرا شو» ضمن إطار فهم هنري لفيفر للاغتراب في الحياة اليومية.
لحظة الخروج
في الآونة الأخيرة لقي مسلسل «مرحبا دولة» رواجًا واسعًا وقد انتشرت آراءٌ كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تَأثُّر العمل بالمسرح الرحباني وصلت إلى درجة اتهامه بتقليده، وفي المقابل خرجَ مخرج المسلسل ومؤلفه محمد الدايخ في أكثر من مقابلة ينفي التقليد ويشير إلى أنّ الاتهام جاءَ لأنّ كلاهما يكتب بصورة واقعية ولغة الشارع والحياة اليومية. لسنا هنا بصدد تأكيد أو نفي الاتهام، وإنّما يمكن القول إنّ في الاتهام وفي الرد اتفاقٌ ضمنيّ على وجود ملامح واضحة لمسرح زياد الرحباني يكاد ينفرد فيها، نجدها في اللغة اليومية وقضايا الطبقة والطائفية والجرأة السياسية.
بعد حرب تشرين 1973، تجاوزَ زياد الرّحباني أسلوب عائلته الفنيّ، وخاصّةً مسرحياته الّتي اتّخذت «الشكل السياسيّ الواقعيّ جدًّا، الذي يمسّ حياة الشعب اليوميّة، بعد أن كانت مسرحيّات الأخوين رحبانيّ تغوص في المثاليّة».[1] لم يكتفِ زياد بالخروج عن هذه المثالية، بل إنّه في مسرحية «شي فاشل» قدّمَ نقدًا ساخرًا أخذَ شكله الأوضح في نهاية المسرحية، حيث تأتي شخصية أبو الزلف والتي تمثّل التراث وتواجه شخصية مخرج المسرحية وتفكّك كل المقولات المثالية حول التراث والوحدة الوطنية والعيش المشترك وما إلى ذلك، وقد جاءت هذه المواضيع بصورتها الأوضح بعد أن بدأ يرسم خطوطها في لحظة خروجه الأساسية في ثنائية «نزل السرور» و«بالنسبة لبكرة شو» وبلغة مفرطة في واقعيتها وتكاد تكون مسجّلة من الحياة اليومية في الشارع اللبناني، تحديدًا في بيروت الغربية.
هكذا تكلّم زياد الرحباني..
31-07-2025
جاءت لحظة الخروج مع مسرحية «نزل السرور» من خلال جمع أبناء الطبقة الكادحة في فندقٍ ورسم خطٍ دراميٍ يناقش الواقع السياسي والطبقي في لبنان. ومع الحرب الأهلية اللبنانية، ذهبَ في مسرحية «بالنسبة لبكرة شو» إلى «معالجة الوضع الاجتماعيّ، والسياسيّ، والاقتصاديّ، من خلال الفترة التي سادت في بداية الحرب الأهليّة، وما رافقها من صراع طبقيّ في لبنان»،[2] يصوّر فيها الرحباني الحياة اليومية لخليط من اللبنانيين والعرب والأجانب في المطعم، بالتركيز على واقع العمّال، ثمّ انشغلَ في سؤال الطائفية بوضوحها في مسرحيتيْ «فيلم أمريكي طويل» و«شي فاشل»، ففي الأولى جمعَ جميع الطوائف في مشفى مجانين في محاولةٍ لـ«علاجهم» إلى أن تفشل كلّ الطرق في العلاج فيضطر إلى ضربهم بالصعقات الكهربائية وإعادة تشكيل وعيهم، بينما في «شي فاشل» جمعَ الطوائف كممثلين يسعون لتمثيل مسرحية حول العيش المشترك والوطن والتراث وفشلوا حتّى في تمثيل أنّ كلّ الطوائف أخوة.
الفضاء المسرحي من النزل إلى البار
في حديثه عن تاريخ لبنان يقول زياد الرحباني إنّ المسحوقين في لبنان يحتاجون أن يلتقوا ويجتمعوا لربع ساعة فقط حتّى يعوا أنّ «التعتير هوّ ذاتُه» ولكنّ تاريخ لبنان المكرّر لم يسمح لهم بأن يلتقوا.[3] وفي مسرحية «نزل السرور» يقرّر الرحباني أن يجمعهم لأكثر من ساعتين في النزل الّذي يصفه بالأغنية أنّه فندق المظلوم وجامع المظلومين.
جميع نزلاء النّزل يشتركون في الطبقة الدّنيا من المجتمع؛ ويختلفون طائفيًا وفكريًا وعمريًا. والنّزل بالنسبة لهم ليس مكانًا للحياة اليومية وليس مجرّد نزل للنّزول والنوم. ولعلّ الرحباني أرادَ من اختيار هذا الفضاء المسرحي ليجمع أكبر قدرٍ من الشخصيات المتباينة والغريبة عن بعضها البعض، ولكنّها في الوقت نفسه تنتمي لنفس الطبقة، لتكون الثورة فيما بعد هي ثورة الطبقة المسحوقة «المعتّرة» أمام الاضطهاد الطبقي.
منذ البداية نعرف أنّ هناك إضراب ومظاهرات عمّالية خارج النّزل؛ ليس فقط بالمعنى المكاني وإنّما فيما يتعلّق بوعيهم للإضراب، فمع بداية الفصل الأوّل يتّصل صاحب الكباريه بالمغنّي ليخبره بالإضراب فيكون ردّ المغني لزميله الملحّن: «معك خبر إنّه أنا وإياك مساندين الإضراب بدون ما نعرف يا قيصر؟ مساندينه وما في مين يسندنا يا قيصر». نجد في الفندق، كذلك، شخصية منظّر الثّورة الّذي يسعى طوال الوقت لتحريض النزلاء على الثورة ويؤطر مراحلها في كتابه الّذي يسعى لنشره بأسرع وقت كونهم يعيشون في موسم «نقمة». في السياق ذاته نجد جميع الشخصيات لا مبالية تجاه واقعها والمظاهرات والإضرابات وأوّلهم منظّر الثورة، أو بكلمات ستيفن سايدمان تبدو كأنّها ذوات «متخففة من أعبائها (..) تعيش لحظتها الآنيّة بقوّة وكثافة»،[4] ولا تكترث بماضيها أو واقعها الاقتصاديّ أو بالمظاهرات الّتي تحدث خارج النّزل.
عندما تأتي الثورة إلى النّزل متمثلة بشخصيتيْ «فهد وعباس» (أبناء الطبقة ذاتها) ترفض جميع شخصيات النزل الانخراط في الثورة، ولا تسعى الشخصيتان المذكورتان إلى تحريض النّزلاء كما يفعل منظّر الثورة وإنّما تجبران كلّ من في النزل على المشاركة في الثورة وإلّا الموت، وتؤكد الشخصيتان أنّهما جاءتا إلى النّزل كونه يجمع المشرّدين و«المعثّرين» في مكانٍ واحد. يأتي رفض كافة الشخصيات للثورة من منطلق الخوف، فيحتمون بمُنظّر الثورة ليجنّبهم الثورة، فيخفي خوفه وراء التنظير ويسعى من خلاله لإلغاء الثورة:
– «الثورة، أنا أقول، تخطيط، فحزب، فجريدة حزب، فإعداد للرأي العام، فتيهؤ، فاقتحام…»
– «فسد بوزك»
ينتهي الفصل الأوّل وقد صدرَ القرار: إمّا الثورة أو سُيقتَل عباس وفهد جميع النزلاء ثم يقتلان أنفسهما، وبين الفصلين نستمع لفاصلٍ غنائيّ «كنّا في أحلى الفنادق، جرجرونا عالخنادق» على افتراض أنّ النّزل كان سعيدًا بدون الثورة، فتتجاهل الشخصيات همومها اليومية وأعبائها أمام «عبء» الثّورة ولهذا تجد الشخصيات تحايلًا ذكيًّا إذ يقدّمون رشوة فيتم إلغاء أو تأجيل الثورة. يهرب الجميع من الفندق بأمرٍ من عباس وفهد إلّا زكريا الّتي قدّمها زياد الرحباني، وهي الشخصية المحورية التي ستستمرّ معنا إلى «بالنسبة لبكرا شو».
زكريا المطرود من بيته، والعاجز عن إعالة أسرته وأولاده يكون قد تعاطى الحشيش ثمّ يقف أمام فهد رافضًا الهرب ويستنكر أن تمضي الحكاية دون ثورة، ويؤمن أنّ حلّ أزمته الطّبقية يكمن بالثورة: «كنت واعد ولادي جبلهن هدايا من الثّورة». وينتهي العمل بعبارت زكريا التي لم تزل تتأمل بالثورة دون أن تحدث.
النّزل -الذي كان جامعًا للطبقة من جهةٍ، وكان مساحة تنفيسيّة للمظلومين من جهةٍ، وكان منعزلًا عن السياق السياسي في المدينة من جهةٍ أخرى- يُفرغ من نزلائه المشردين، ويفقد جدواه ومعناه السّابق ليصير بمعناه الحرفيّ «نزل» للنزول والنّوم، وقد يكون هذا رمزًا لتشتّت الطّبقة وتفكّكها إلى ذوات بروليتارية ولكنّها غير مجتمعة كطبقة موحّدة في مساحة مشتركة، وبالتالي تُلغى الثّورة. بينما في الواقع اللبنانيّ وبعد عرض «نزل السرور» تبدأ الحرب الأهلية، وقد ذهبت بعض التحليلات إلى أنّ الثورة في نزل السرور هي شيء من التنبؤ بالحرب الأهلية.
بيروت: جولة بين مباني خندق الغميق المتداعية
11-10-2021
بعد ثلاث سنوات على الحرب الأهلية، تعود شخصية زكريا وتظهر في مسرحية «بالنسبة لبكرا شو» برفقة زوجته ثريا، وإذا كانَ «نزل السّرور» فضاءً يجمعُ المشرّدين وأبناء الطّبقة الواحدة فإنّ البار يجمع مُختلف الطّبقات، فهو مكان عمل زكريا وثريا، وهو فضاء للتعبير الشعري لابنِ الطبقة الوسطى، وهو فضاء مخصوص للتعبير عن المكبوت وتحديدًا لأبناء الطّبقة الوسطى وبعض الأجانب، وهو فضاء لتبادل الصفقات، والاتّجار بالجنس والمخدرات، إضافة لكونه فضاءً ترفيهيًا للأجانب المقيمين في بيروت، وتحديدًا شارع الحمرا، وبهذا يضعُ العرض الذّوات البروليتارية في تقابلٍ مع الرأسمالية والبرجوازية في مساحةٍ مشتركة وضمن وجود خفيف للطبقة الوسطى.
الفضاء المسرحي في «بالنسبة لبكرا شو» لا يجمع «المعتّرين» كطبقة وإنّما يفكّكهم إلى عمّال وبعض الزبائن، وبالتالي لا تلتقي الشخصيات بهمٍّ مشترك وواضح ومباشر مقابل قضية محددة ومباشرة، وإنّما تبدو جلّها مغتربة ومشتّتة في سياق الاستغلال والتفاوت الطبقي مسرحيًا، والحرب الأهلية والبعد الطائفي واقعيًا.
اقتلاع الإنسان من نفسه
يأتي كلٌّ من زكريا وزوجته ثريا إلى البار، ويضطران للاستئجار في بيروت، وبالتالي يزداد الدخل من جهة ولكن يتضاعف المصروف من جهةٍ أخرى. يستأجران بيتًا ويشتريان أغراضه بالأقساط، وفيما يتعلّق بطبيعة عملهما يحاولُ الرحباني أن يوضّح الجانب الأبسط للاغتراب وفق تفسير لوفيفر الّذي يقول بأنّ «العمل ضمن حدود الملكية الخاصة هو عمل مغترب، يعمل الأجير لصاحب العمل وتعمل الطبقة البروليتارية للطبقة الرأسمالية»،[5] وسيكون هذا الجانب واضحًا على طول العرض كتأكيدٍ على الاغتراب وكنقطة انطلاق لفهم جوانبَ مختلفة له.
لا يهدف عمل زكريا وثريا إلّا لسداد الأقساط وتعليم الأولاد، ويعملان إكراهًا دون أن «يكون العمل حاجة حيوية وإنسانية» فيتحوّلان من «كائنينِ إنسانيينِ إلى أداةٍ تستخدمها أدواتٌ أخرى» فهما يعملان «لدفعِ فواتيرهم المستحقّة، لا للتعبير عن طاقاتهم وقيمهم أو مواهبهم».[6] وبالنتيجة فهو عملٌ مغترب كونه يفتقد لجوهره الاجتماعيّ والإنسانيّ. يقدّم الرّحباني اغترابه عبر وقوف العمال أمام المدير الّذي يستبدل صفاتهم بصفات العمّال المناسبة، ويلغي شخصية كلّ عامل ليحلّ محلّها صفات وشخصيات ملائمة للزبائن، والأجانب بصورة خاصّة، ليشير الرّحباني لما تفعله الرأسمالية من «اقتلاعٍ للإنسان بعيدًا عن نفسه».[7]
أمّا ثريا فكانَ عليها أن تنسلخ عن ذاتها وجسدها لإرضاء كافة الزبائن الأثرياء، وتحديدًا الأجانب، وهذا ما يشكّل قلق زكريا الدّائم على طول فترة المسرحية، ولكنّه يتعامل معها على أنّها غريبة داخل نطاق العمل، وعند كلّ أزمةٍ تسأل ثريا: «بالنسبة لبكرا شو؟» ودائمًا لا يجد زكريا أيّ إجابة فيجدان نفسيهما متجاهلين طبيعة عمل ثريا أمام مستقبل مجهول ومشوّش يرمّز فيه لمستقبل لبنان طائفيًا وطبقيًا.
رغم أنّ ثريّا (أو جسدها) تمثّل المشكلة أو السؤال المسرحي، إلّا أنّ العرض ركّزَ على تبعات وأثر المشكلة على شخصية زكريا واغترابها، أمّا ثريا فلا تتحدّث بشكلٍ واضح عن أزمتها إلّا مرةً واحدة في منتصف المسرحية حيث تواجه زكريا، وعبر هذه المواجهة تُظهِر المسرحية قضيتها وعلاقتها بموقعها الطّبقي وجسدها الّتي تتجاهله لتوفير ملابس جيّدة لابنتها «هالبنت بحاجة لمصاريف حتّى حدا يحبّها» ولتوفير قسط المدرسة الخاصة لأبنائها لكي يتعلّموا اللغة الفرنسية، اعتقادًا منها أنّ الملابس الجيّدة واللغة الفرنسية ستجعلهم يتجاوزون واقعهم الاجتماعي، ويبدو هذا واضحًا فيما تقوله لزكريا حول واقعهما الاقتصاديّ: «لأنّك مش متعلّم، وما بتعرف لغات، وما عندك إمكانيات لشي». فيكون امتلاك لغة الفرنسي والعلم أكثر جدوى من امتلاك الجسد والذّات واللغة، وكلا الأمرينِ يحولان بين ثريا وبين معرفة طبيعة المشكلة ماديًا وطبقيًا.[8]
يسعى كلٌ من زكريا وثريا إلى تجاوز واقعهما الطبقيّ ولكن من خلال الرأسمالية نفسها (شروط البار)، حيث يطلب زكريا رفع أجره، ولكنّ المدير يرفض بالضرورة، ولاحقًا يعرض عليه فرصة أن يسافر إلى الخليج ويعمل في الفرع الثاني للبار، ليظهر أنّ زكريا «سلعة تُباع في سوق العمل في هيئة عقد العمل».[9] وفي المقابِل على ثريّا أن تبقى في بيروت وحدها وتواصل عملها الإضافيّ الّذي تقدّمُ فيه جسدها كسلعة. وبهذا يزداد اغتراب زكريا عن عمله واغتراب ثريا عن جسدها.
ومع تراكم مستويات الاغتراب والشعور بالاستغلال لا يجد زكريا إلّا زوجته ثريا ليفرّغ عنفه فيها، فبدل أن يرتد العنف إلى البار يمتد أفقيًا إلى زوجته وشريكته، فيختلق معها مشكلة كونها تتحدث مع زبونٍ إسبانيّ. والمفارقة أنّ انفجار زكريا في وجه ثريا لم يأتِ لأنّها تتحدث مع الإسبانيّ وتتفق معه على موعد جنسيّ، وإنّما لأنّها اختارت الإسبانيّ وفضّلته على الزبون الفرنسيّ، تدافع ثريا عن نفسها بأنّها اختارته لأنّه يدفع أكثر وتتحول المشكلة بصورة كوميدية إلى اختلاف على من الأكثر بخلًا؛ الإسبان أم الفرنسيين؟
تأخذ هذه المواجهة زكريا للاعتراف بأزمته والبوح بها لصديقه على أمل استرجاع ذاته المغتربة، ليس فيما يتعلّق بحبّه وعلاقته بثريّا وحسب، وإنّما بكلّ موقعه الطّبقي، فيقول: «أنا جبتها لتشتغل بالمطبخ، هنّي ما قبلوها غير هيك»، لإظهار أنّ النّظام الرأسمالي هو من يحدّد استخدام «قوّة العمل» بحيث يدفع «الأجير أن يبيع قوّة عمله كأنّها شيء، ويصبح شيئًا» وبهذا يغدو «منفصلًا عن ذاته ومتحلّلًا منها».[10] تتوالد أسئلة زكريا واعترافاته خلال البوح (الانفجار) فيخبر صديقه (والجمهور ككل) أنّ المنظومة قسّطت أغراض البيت وبدون انتباه وجد أنّه يشتري الأغراض لكنّها لم تصبح ملكًا له، وفي سبيل امتلاكها يواصل عمله كأجيرٍ فلا يمتلكها ولا يمتلك ذاته الإنسانية ولا الأشياء التي يشتريها بالأقساط، ويظهر وعي زكريا الطّبقيّ فيما يحدث معه «جماعة هيك عقلهن، عم بستغلونا». وفي المواجهة ذاتها ينتقل إلى أولاده ويرى أنّ شكل لبسهم ومستوى لغتهم يحدد مستوى فهمهم «ولادي إذا ضلّوا لابسين نفس اللبس ما حدا رح يسمعهن تا يشوف إذا بفهموا»، كإشارة لما قاله ماركس «بأنّ امتلاك المال يمنح قوّة كبيرة ويمتلك قدرة على قلب الصّفات»،[11] ويواصل «ولادي ما كانوا يحبّوني، الولاد بحبّوا إلّي بعطيهن مصاري» كربطٍ بين الحبّ والثروة، واستمرارًا لمقولته على مدى المسرحية المرتبطة بتسليع الحب في ظلّ الاقتصاد الرّأسمالي الّذي «يخلق حاجة وحيدة وهي الحاجة إلى المال» فيقتلع «الإنسان بعيدًا عن نفسه» وهنا يتمظهر «اغتراب الإنسان ذاته».[12]
ينتهي البوح بحديث زكريا عن الفقر ويرتفع المستوى الدرامي في الأداء، ويرى أنّ الفقر أصبحَ مرعبًا في المدينة، بينما في حياته السابقة (في الجبل) كانَ يعيش الفقر دون أن يراه، أمّا في المدينة ومع التناقض الطبقي الصارخ ورؤيته لأنماط حياة مختلفة وجدَ نفسه يرى فقره بوضوح ويرى أنماط الحياة الممكنة أمامه، ويقتنعَ بإمكانية أن يغدو في منزلة أعلى عبر رفع الأجور مثلًا، أو السفر، أو العمل لساعاتٍ أطول، أو شراء أغراض البيت عبر التقسيط.
في الجزء الأخير من المسرحية يعيش زكريا حالة مركّبة من الاغتراب النفسي، فتصبح شخصيته أكثر انطواءً إلى حدّ الاختفاء. ففي هذا الجزء تنشغل المسرحية عن زكريا بسلاسة وذكاء إخراجي، إذ يقدّمُ حياةً مستمرة وسريعة وعفوية: العمال يعملون بحيوية إرضاءً لمالك الكباريه، ويبيع الشّاعر قصائده للشريك الخليجيّ، تُعرَض قصّة حب هامشية والتي نسمع خلالها أغنية «عايشة وحدها بلاك»، ومشهد لتجارة (الممنوعات)، وتستمر ثريا بعملها مع زبونٍ أجنبيٍّ آخر، في حين يقف زكريا وراء البار دون أي «وجودٍ». لاحقًا، ودون مقدّمات، يقررّ زكريا العودة إلى قلب المسرحية واسترجاع ذاته، ويطلب فجأةً من زكريا أن يتركا العمل في البار.
تنتهي المواجهة الأخيرة مع ثريا إلى تساؤلات جدية حول تدبير الأمور المنزلية، فيما يتعلق بأقساط الأغراض وقسط الطلاب، وهو نفسه السؤال الّذي تبدأ به المسرحية، فتسأله عن القسط: بالنسبة لبكرا شو؟ وفي حين بدأت المسرحية بتشويش حول المستقبل وعدم معرفتهما ماذا سيفعلان، إلّا أنّ زكريا في النهاية يبدو واثقًا وواضحًا: «غراضهن، بيجوا بوخدوهن»، وحول الأولاد: «ولادنا، بنروح بنوخدهن». تعلو المواجهة وترتفع الأصوات مما يزعج الزبائن الأجانب، وضمن السياق الدّراما يقوم زكريا بطعن زبونٍ أجنبيٍ.
لبنان: من هو الوطني اليوم؟
16-01-2025
تبدو الطّعنة الأخيرة وكأنّها (مجازًا) محاولة يائسة للثورة الّتي لم تتحقّق في «نزل السّرور» ولكنّها تظلّ في إطار الفعل الفرديّ والانفعاليّ ولا يخلو من الغيرة (وفيها استبطان ذكوري)، وبالتالي لم يحقّق أي تبديلٍ في الواقع، بل على العكس، تتوقف الحياة المسرحية للحظات يحاول خلالها روّاد المكان وصاحبه بإخراج ثريا من حالة الحزن، ثمّ تستمرّ الحياة بشكلٍ سريعٍ وقاطعٍ وتعلو الموسيقى.
يمكن قراءة هذه النهاية على أنها تشاؤمية إلّا أنّ الرحباني في هذا النص وفي كل نصوصه لا يسعى لتقديم نهايات مُريحة للجمهور، وفي هذا النهج خروج آخر من مسرح الرحابنة. لا يسعى زياد الرحباني إلى تجميل الواقع وإراحة الجمهور، وإذا كانَ الواقع اللبناني بطائفيته وطبقيته وتعقيداته لم يتبدل فمصائر الشخصيات المسرحية ستبقى في اغترابها وفقرها. لم يقدّم أيّ نهاية مُريحة، ولكنّه في الوقت نفسه لا يذهب إلى العدمية، وإنّما يطرح الأسئلة الصعبة ويفتح عيون الناس على قسوة واقعهم وإمكانية تغييره.
[1] فاتن إسماعيل، تحليل الواقع اللبنانيّ من الناحية الاجتماعيّة والسياسيّة من خلال مسرحيّتي زياد الرحبانيّ «نزل السرور» و«بالنسبة لبكرا شو؟». أوراق ثقافية – مجلّة الآداب والعلوم الإنسانية، ع2 (2019).
[2] فاتن إسماعيل: مصدر سابق.
[3] زياد الرّحباني – التاريخ يعيد نفسه. يوتيوب.
[4] ستيفن سايدمان. شوارع بيروت: الذّات والمواجهة مع الآخر. المجلّة العربية لعلم الاجتماع – إضافات، ع5 (2009): ص48
[5] هنري لوفيفر. معرفة الحياة اليومية. (ترجمة: ثائر ديب) مجلّة أسطور، ع5 (2017): ص225.
[6] توماس ويستون. الفلسفة والحياة اليومية في ظلّ الرأسمالية. (ترجمة رائد القاقون) مجلّة بدايات، ع30 (2021).
[7] هنري لوفيفر: مصدر سّابق، ص222.
[8] هنري لوفيفر: مصدر سابق، ص 216 – 217.
[9] المصدر السابق، ص214.
[10] المصدر سابق، ص226.
[11] توماس ويستون: مصدر سابق.
[12] هنري لوفيفر: مصدر سابق، 223.