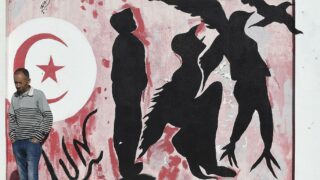" كيف تريدني أن أتزوج وسعر طن الإسمنت يتجاوز 300 دينار".. هذه واحدة من الإجابات المتكررة التي يوردها في السنوات الأخيرة بعض الشبان التونسيين، الذين "تأخروا" في الزواج. طبعاً ليس سعر الإسمنت بحد ذاته هو العامل المؤثر، في مسألة الزواج المتأخر، بل هناك أسباب أخرى اقتصادية وحتى ثقافية، وهناك مشكل حقيقي في مسألة الإسكان. ففضلاً عن الإسمنت، تشهد البلاد ارتفاعاً هائلاً ومستمراً في أسعار أغلب مواد البناء. هذا الارتفاع يتسبب في حرمان شرائح واسعة من التونسيين من إمكانية تملّك مسكن في بلد كان يفخر قبل بضعة عقود بأن قرابة 80 في المئة من الأسر تمتلك المساكن التي تقطنها. الضرر يشمل عدة فئات أخرى، وليس الشباب وحدهم. وما يزيد من حنق الناس أن تونس لا تعتمد على التوريد، بل تمتلك صناعة محلية متكاملة تُمكّنها من تغطية الطلب المحلي، وحتى تصدير كميات كبيرة إلى الخارج. أين الخلل؟ ربما نستطيع تبينه من خلال العودة إلى أهم مراحل نشأة وتطور هذا القطاع في تونس، على امتداد قرابة القرن من الزمن.
التاريخ السياسي والاقتصادي للإسمنت في تونس
يمكن لمتتبع تاريخ هذه الصناعة في تونس أن يلاحظ بسهولة تقاطعاً متكرراً بين أهم مراحلها، ومحطات فارقة في تاريخ البلاد. دخلت هذه السلعة، التي كانت مجهولة لدى التونسيين، البلاد مع قدوم الفرنسيين الذين احتلوا تونس في عام 1881. حتى سنة 1931، كان الإسمنت المستعمل في تونس مستورداً كلياً من فرنسا ومن دول أخرى، لكن تزايد الطلب عليه بحكم تطور حركة التمدن والنمو الديمغرافي - بلغ حجم الاستهلاك 100 ألف طن في تلك السنة - حث بعض التجار والصناعيين الفرنسيين على التفكير في إنتاج هذه السلعة محلياً. وفي سنة 1932 أُنشئ أول مصنع إسمنت في تونس، تحديداً في منطقة "جبل الجلود" التابعة للعاصمة، وبدأ مشوار مصنع "الإسمنت الاصطناعي التونسي" بفرنين طاقة إنتاجهما 100 ألف طن.
هناك في تونس 9 وحدات أساسية لانتاج الإسمنت م،تفاوتة الحجم والقدرة الإنتاجية، تتوزع على مختلف أقاليم البلاد. ثلاثة منها ملك لإسبانيين، واثنان لبرتغاليين، باع أحدهما نصيبه لمجموعة برازيلية أعادت بيعه مؤخراً لمجموعة صينية، ومصنع مملوك لإيطاليين. وتمتلك الدولة مصنعين، وتسيطر على مصنع ثالث، بعد أن صادرت في 2011 ممتلكات عائلة الرئيس الأسبق بن علي.
بعيد الحرب العالمية الثانية، ومع انطلاق مرحلة إعادة الاعمار، وتنشيط الاقتصاد من جديد، تزايدت الحاجة مرة أخرى إلى الإسمنت في تونس، فأنشئ مصنع ثان من قبل "شركة إسمنت مرسيليا وما وراء البحار" في مدينة بنزرت. ومع استقلال البلاد سنة 1956، كانت طاقة الإنتاج قد بلغت حوالي 300 ألف طن سنوياً. سال في هذين المصنعين عرق العمال التونسيين ودمهم أيضاً. مصنع "جبل الجلود" كان في أربعينيات القرن الفائت أحد معاقل الحركة النقابية والوطنية، وفي 2 آب/أغسطس 1947 شهد مواجهات دامية بين العمال المضربين والسلطات الاستعمارية، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة عمال تونسيين وجرح واعتقال آخرين. أما مصنع إسمنت بنزرت، الذي قامت الدولة التونسية بتأميمه سنة 1959، فقد قصفته الطائرات الفرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر 1961.
القطاع العمومي في تونس: ثلاثون تهدم ثلاثين..
22-03-2018
تونس: حين ترتفع "اليد اليمنى" للدولة
14-09-2016
قامت الدولة بتأميم مصنع "إسمنت جبل الجلود" أيضاً سنة 1964، وأُنشئت شركة عمومية صارت تتحكم في صناعة واستيراد وتسويق الجزء الأكبر من احتياجات البلاد من مواد البناء. إلى حد سنة 1969 ، ظلت احتياجات البلاد من الإسمنت محدودة نظراً لضعف حركة التصنيع والاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي، وكان المصنعان الفرنسيان اللذان وقع تأميمهما يغطيان أغلب الطلب المحلي. لكن الدولة قررت انطلاقاً من سنة 1970 تنويع النشاط الاقتصادي، مع التعويل على الصناعات الخفيفة وأنشطة تحويل الموارد الطبيعية لمنتجات صناعية، وتعزيز السياحة. كما وضعت مخططات للنهوض ببعض الجهات الداخلية، عبر تكثيف الاستثمار العمومي، وتطوير البنى التحتية، وشبكات الطرقات والنقل الحديدي، بالإضافة إلى بناء مئات المؤسسات التربوية والصحية وغيرها. هذا التوجه الجديد تطلب كميات هائلة من مواد البناء، من أهمها الإسمنت، في حين كانت الطاقة الإنتاجية المحلية ضعيفة. لذا قررت حكومة الهادي نويرة آنذاك بناء سلسلة من مصانع الإسمنت التابعة للقطاع العام، توزعت على عدة مناطق من البلاد: مصنع "اسمنت قابس" في الجنوب الشرقي سنة 1973، ومصنع "أم الكليل" في محافظة "الكاف" بالشراكة مع الدولة الجزائرية في 1973، ومصنع "إسمنت جبل الوسط" في محافظة "زغوان" في عام 1978، ومصنع "الشركة التونسية الجزائرية للإسمنت الأبيض" في محافظة "القصرين" سنة 1982، و"إسمنت النفيضة" في محافظة سوسة في 1983. بحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين كانت تونس تمتلك 6 مصانع لإنتاج الإسمنت البورتلاندي الرمادي، ومصنع للإسمنت الأبيض، بطاقة إنتاج تتجاوز 5 مليون طن وفوائض قابلة للتصدير.
لكن ليست هذه نهاية "القصة"، ففي الفترة نفسها التي بلغت فيها صناعة الإسمنت مرحلة النضج، شهدت البلاد أزمة مزدوجة، سياسية واقتصادية، انتهت الأولى بوصول الجنرال "بن علي" إلى الحكم سنة 1987 خلفاً للرئيس الحبيب بورقيبة، في حين أن الثانية تكللت سنة 1986 ببرنامج "إصلاح هيكلي"، وضعه صندوق النقد الدولي لـ"إنقاذ" الاقتصاد التونسي وإنعاشه. ومن بين أهم بنود البرنامج انسحاب الدولة تدريجياً من عدة قطاعات منتجة لصالح القطاع الخاص، وتقليص الإنفاق العمومي، والتخلص من عشرات المؤسسات الاقتصادية العمومية. وبحكم حجمها الاقتصادي وربحيتها، كانت مصانع الإسمنت على رأس قائمة المؤسسات المعنية بالخصخصة. وبالفعل بيعت خمسة مصانع ما بين سنة 1998 و2005 لمستثمرين أجانب. ولا يمكن إنكار أن الخصخصة أسهمت في تطوير القطاع، سواء من حيث عصرنة التجهيزات وزيادة حجم الإنتاج، أو تحسين جودة السلع وتنويعها، لكن الثمن كان باهظاً بالنسبة إلى المستهلك العادي: ما بين سنتي 1998 و2008 قفز سعر الطن الإسمنت الرمادي العادي من 54 ديناراً إلى 106 دنانير.
في السنوات الأخيرة من حكم "بن علي"، أعلنت السلطة عن عدة مشاريع استثمارية خليجية وأوروبية في مجال العقارات والسياحة، مما شجع بعض المستثمرين التونسيين، بالشراكة مع مستثمرين ألمان، على التفكير في إنشاء مصنع إسمنت ثامن، ونال مشروع "إسمنت قرطاج" (محافظة "منوبة") الترخيص المبدئي من قبل السلطات، قبل أن يتدخل أحد أصهار الرئيس الأسبق بن علي، بلحسن الطرابلسي، ويفرض إقصاء المستثمرين الألمان، ثم الاستحواذ على 51 في المئة من أسهم الشركة، التي تمت رسملتها من قبل بنوك عامة وخاصة، وأدرجت في البورصة قبل حتى استكمال بناء المصنع والانطلاق في الإنتاج. صادرت الدولة أملاك بلحسن الطرابلسي بعيد الثورة، واستطاعت استكمال المشروع والانطلاق في إنتاج الإسمنت منذ سنة 2013. في تلك السنة، افتتح المستثمر الإسباني المالك لمصنع الإسمنت الأبيض في "القصرين"، مصنعاً آخر للإسمنت الرمادي في محافظة القيروان. ومنذ تلك الفترة دخلت صناعة الإسمنت في مرحلة من الركود.
قطاع استراتيجي يواجه تحديات كبرى
يَعد قطاع إنتاج الإسمنت في تونس 9 وحدات أساسية متفاوتة الحجم والقدرة الإنتاجية، تتوزع على مختلف أقاليم البلاد، مع تركز واضح في الجهة الشرقية الساحلية. ستة من بين هذه الشركات ملك أجانب، ثلاثة منها لإسبانيين، واثنان لبرتغاليين، باع أحدهما نصيبه لمجموعة برازيلية أعادت بيعه مؤخراً لمجموعة صينية، ومصنع مملوك لإيطاليين. وتمتلك الدولة مصنعين، وتسيطر على مصنع ثالث، بعد أن صادرت في 2011 ممتلكات عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. يمثل "الاسمنت البورتلاندي العادي" 94 في المئة من الإنتاج، والاسمنت الأبيض 5 في المئة، والبقية أنواع خاصة من الاسمنت.
يمكن لمتتبع تاريخ صناعة الإسمنت في تونس أن يلاحظ بسهولة تقاطعاً متكرراً بين أهم مراحلها، ومحطات فارقة في تاريخ البلاد. دخلت هذه السلعة، التي كانت مجهولة لدى التونسيين، البلاد مع قدوم الفرنسيين الذين احتلوا تونس في عام 1881.
في الفترة نفسها التي بلغت فيها صناعة الإسمنت مرحلة النضج، شهدت البلاد أزمة مزدوجة، سياسية واقتصادية، انتهت الأولى بوصول الجنرال "بن علي" إلى الحكم سنة 1987 خلفاً للرئيس الحبيب بورقيبة، في حين أن الثانية تكللت سنة 1986 ببرنامج "إصلاح هيكلي"، وضعه صندوق النقد الدولي لـ"إنقاذ" الاقتصاد التونسي وإنعاشه. ومن بين أهم بنوده، انسحاب الدولة تدريجياً من عدة قطاعات منتِجة لصالح القطاع الخاص.
الإسمنت عمود أساسي في مجال "صناعات مواد البناء والسيراميك" الذي تبلغ قيمة إنتاجه ما بين 3 و4 مليار دينار سنوياً، اذ يسهم بحوالي 44 في المئة من مداخيل هذا المجال، وقرابة 55 في المئة من صادراته. وهو طبعاً سلعة أساسية في مجال "البناء والأشغال العامة"، الذي يمثل حوالي 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويشغِّل بشكل مباشر وغير مباشر حوالي نصف مليون تونسي. وعلى أهميته، يواجه قطاع الاسمنت تحديات كبيرة.
أكبر التحديات هي مسألة الطاقة، فوحدات إنتاج الإسمنت هي من أكثر الصناعات شراهة لاستهلاك المحروقات: حوالي 575 ألف طن من النفط المكافئ، أي حوالي 4 مليون برميل نفط سنوياً. علماً أن الفاتورة الطاقية تمثّل ما بين 30 و40 في المئة من تكلفة الإنتاج. إلى حد سنة 2014، كانت الدولة التونسية تتكفل بدعم جزء من تكلفة المصاريف الطاقية لمصانع الاسمنت، بهدف الحفاظ على انخفاض الأسعار، ضماناً لتزويد السوق المحلية، وللتنافسية في الأسواق العالمية. لكنها قررت في 2014 تحرير الأسعار، ورفع الدعم بسبب تفاقم العجز الطاقي الذي تفوق قيمته 50 في المئة من احتياجات البلاد. المشكلة الطاقية لا تتوقف عند التكلفة المالية، بل تشمل الآثار البيئية أيضاً. وكانت الدولة التونسية قد التزمت ضمن قمة المناخ في باريس 2015 بخفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 45 في المئة في حدود سنة 2030، كما أن عدة دول وضعت معايير عالية للبصمة الكربونية للسلع التي تعْبر حدودها، مما يعني ضرورة تأقلم شركات الاسمنت حتى تتطابق منتجاتها مع الالتزامات الدولية لتونس ومعايير الدول المستوردة. وكانت هذه الشركات قد وقّعت في نيسان/أبريل 2019 " ميثاق مساهمة صناعة الاسمنت في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية"، الذي ينص على التزامها بالبحث عن حلول لدعم التحول الطاقي، والحد من الانبعاثات الغازية، وذلك عبر استعمال الطاقات البديلة. هذا الميثاق "المواطني" لا يزال إلى اليوم أقرب إلى كونه عملية دعائية "خضراء". في الواقع، بعد إلغاء الدعم الطاقي، سعى المنتجون إلى الحفاظ على هوامش الربح نفسها، بل وحتى زيادتها، فزادت الأسعار أكثر من الضعف، من 130 ديناراً للطن الواحد سنة 2013 إلى حوالي 300 دينار سنة 2024.
الأسعار المرتفعة وتقييدات التصدير التي تصدرها الحكومة من وقت إلى آخر، تعطّل انتشار الاسمنت التونسي في الأسواق العالمية، لكن هناك معطيات خارجية أيضاً. فأكبر مستهلِكَين تقليديين للإسمنت المحلي، سواء عبر التصدير المنظم أو التهريب، أي ليبيا والجزائر، لم يعودا بحاجة ملحة إلى المنتَج التونسي. ليبيا صارت أكثر ارتباطاً بالسلع التركية والمصرية، والجزائر تطورت طاقتها الإنتاجية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حتى صارت تصدّر فائض إنتاجها من الاسمنت، مستفيدة من الأفضلية التي تمنحها إياها احتياطاتها الضخمة من الوقود الأحفوري.
على المستوى المحلي، تسبب تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة في تراجع طلب القطاع الخاص على الاسمنت، فهناك صعوبات كبيرة يلقاها التونسيون في بناء العقارات. كما أن ارتفاع نسب التداين والعجز العموميين يقلص من حجم الإنفاق العمومي في إنشاء وصيانة البنى التحتية والمشاريع الكبرى، التي تتطلب استعمال كميات كبيرة من الخرسانة والاسمنت. ونتيجة لهذا التراجع في الطلب تناقص الإنتاج في بعض السنوات الأخيرة إلى ما دون 7 مليون طن سنوياً، في حين أن الطاقة الإنتاجية القصوى تبلغ حوالي 12 مليون طن.
الصين على الخط
أعلن السفير الصيني في تونس في تموز/يوليو 2024 عن دخول شركة "الصين الوطنية لمواد البناء المحدودة"، أكبر منتج للإسمنت في الصين، في مفاوضات لشراء وحدتين إنتاجيتين مرتبطتين بصناعة الاسمنت، وهما مصنع اسمنت جبل الوسط ومصنع آخر يتبعه مختص في صناعة مشتقات الاسمنت، عبر شراء حصة المجموعة البرازيلية، التي كانت بدورها قد اشترت في 2012 حصة المجموعة البرتغالية. نجح الصينيون في إتمام الصفقة بمبلغ يناهز 130 مليون دولار. وكشفت مصادر نقابية تونسية عن أن الشركة الصينية نفسها عبّرت عن رغبتها في شراء مصنعين آخرين. وفي صورة تحقق هذه الطموحات في السنوات القادمة فإن الصين ستسيطر على أكثر من نصف الإنتاج وتصبح اللاعب الأكبر في السوق.
لكن ما سر هذا الاهتمام الصيني بالإسمنت التونسي؟ بحسب احصائيات سنة 2024، فإن الصين هي المنتج الأول للإسمنت في العالم ب1،9 مليار طن، يذهب الجزء الأعظم منها إلى السوق المحلية، وهي الأكثر استهلاكا في العالم، ومن المستبعد أن تمثل ستة أو سبعة ملايين طن من الاسمنت (متوسط الإنتاج السنوي في تونس) إغراءً كبيراً للصينيين. التفسير الأقرب إلى المنطق يتعلق بالدور المتنامي للصين في الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، خاصة، بعد وصول قيس سعيّد إلى السلطة.
أكبر التحديات في ملف الإسمنت هي مسألة الطاقة، فوحدات إنتاج الإسمنت هي من أكثر الصناعات شراهة لاستهلاك المحروقات: حوالي 575 ألف طن من النفط المكافئ، أي حوالي 4 مليون برميل نفط سنوياً. علماً أن الفاتورة الطاقية تمثّل ما بين 30 و40 في المئة من تكلفة الإنتاج.
إلى حد سنة 2014، كانت الدولة التونسية تتكفل بدعم جزء من تكلفة المصاريف الطاقية لمصانع الاسمنت، بهدف الحفاظ على انخفاض الأسعار، ضماناً لتزويد السوق المحلية، وللتنافسية في الأسواق العالمية. لكنها قررت في 2014 تحرير الأسعار، ورفع الدعم بسبب تفاقم العجز الطاقي الذي تفوق قيمته 50 في المئة من احتياجات البلاد.
ويعول الرئيس سعيّد بشكل واضح على "الصداقة الصينية-التونسية" لإنعاش الاقتصاد التونسي، في ظل صعوبة جلب الاستثمارات، والحصول على قروض كبرى، وتدني التصنيف الائتماني للبلاد. في الحقيقة يصعب الحديث عن علاقة ندية بين البلدين، فميزان المبادلات التجارية مختل تماماً لصالح الصين، التي استأثرت في سنة 2023 مثلاً ب8،4 مليار دينار من إجمالي العجز التجاري الخارجي لتونس المقدر بحوالي 17 مليار دينار.
وكان قيس سعيّد قد التقى بالرئيس الصيني في كانون الأول/ ديسمبر 2022، على هامش القمة العربية الصينية التي انعقدت في السعودية. وخلال اللقاء، طُرحت فكرة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، التي صارت اتفاقاً رسمياً إثر الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى الصين في العام 2024، حيث وُقِّعت سبع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة. ويأمل الرئيس سعيّد أن تكون الصين، بحكم إمكانياتها وخبرتها، "المقاول" الذي سيحول الرؤى والوعود الرئاسية إلى واقع. ومن أهم المشاريع التي أنجزتها الصين - بعضها تم الاتفاق عليه مع حكومات سابقة - أو شرعت في إنجازها: بناء أكاديمية دولية للديبلوماسيين، وإعادة بناء الملعب الأولمبي ("المنزه") في العاصمة تونس، وبناء مستشفى جامعي في محافظة صفاقس، وتوسعة المستشفى الجامعي في محافظة قابس، وإنشاء جسر بحري في محافظة بنزرت. وهناك حالياً مفاوضات - أو إبداء اهتمام من قبل الصينيين - حول مشاريع أكبر بكثير، مثل إنشاء مدينة طبية ضخمة في محافظة القيروان، وربط شمال البلاد بجنوبها بشبكة طرقات وقطارات سريعة، وإنشاء ميناء المياه العميقة في "النفيضة" بمحافظة سوسة. كل هذه المشاريع الضخمة، المنجز منها، والذي في طور الإنجاز والمتوقع إنجازه، تتطلب كميات هائلة من الاسمنت قد تجد الشركات الصينية صعوبة في ضمان توافرها بشكل سلس في السوق المحلية، كما أن استيرادها من خارج تونس قد يزيد من تكلفة المشاريع. وقد تكون الحاجة إلى الإمداد السريع والمتواصل لمدة سنوات، هي المنطلق الأساسي الذي دفع الصينيين للسعي إلى شراء مصانع اسمنت، يتحكمون في إنتاجها ونسقه وتوزيعه. طبعاً هناك أرباح ستجنيها الصين من صناعة الاسمنت في تونس، لكن يبدو أن السيطرة على مفصل من أهم مفاصل قطاع البناء والأشغال العامة له منافع اقتصادية وسياسية أكبر.
وليست تونس الحالة الأولى، التي تشهد هذه السياسة الصينية. ففي آذار/مارس 2025 افتتحت شركات صينية مصنعاً للإسمنت في بوركينا فاسو، وقبلها وقّعت في كانون الثاني/يناير 2025 عقداً لبناء مصنع اسمنت في جنوب إفريقيا، وحصلت على ترخيص لبناء مصنع اسمنت جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر 2024، واستحوذت على 83 في المئة من حصة مجموعة "هولسيم" السويسرية في نيجيريا، وأعلنت عن نيتها بناء مصنع اسمنت في زامبيا. وهناك عمليات سابقة في المسعى نفسه، ولا يبدو أنها ستتوقف قبل أن تصبح الصين المصنِّع الأول للإسمنت في إفريقيا، بعد أن صارت أكبر المقاولين فيها...
لا غنى عن الإسمنت لبناء "طريق الحرير"!