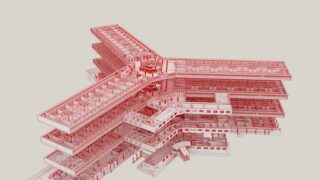استأصلوا الخوف الذي استوطن داخلهم، بقدومهم المثقل بالصعاب إلى هذا المكان في حي"الجميلية" من حلب، حيث موقع الصالة التي تقدم على منصتها المسرحية. وصلوا من جهات المدينة الثلاث، غير مبالين بمخاطر المكان الذي سقطت على مقربة منه قذائف "جهنم" عدة في استهلالية الزمن المنسوب إلى هدنة عيد الأضحى.. وغير مبالين بمخاطر الطرقات الموصلة إليه، حيث تهاوت كذلك العديد من القذائف والصواريخ لتسخر لا من قيمة هذه الهدنة الافتراضية، ولا من الهدنات التي سبقتها، بل من قيمة الحياة برمتها التي أمسى البقاء على قيدها رهين مصادفات متعددة، ويمكن إدراج ضحاياها وضحايا ما شابهها من صراعات حربية (الحرب الأهلية في لبنان/الحرب العراقية - الإيرانية) كفرق حساب في صراعات خرجت مع توالي الزمن عن مسارها، ومسار أهلها وآمالهم.
بقناعة أو من دونها، أمسوا في ديار حرب. إنْ قبل أهل البلاد من القادرين على حمل السلاح بشروطها، فهم مدعوون إلى جبهاتها، وإن لم يقبلوا.. سيحل مكانهم، من غير أهل البلاد، من حملوا هذه القناعة. وبمرور متأن على المتحاربين، يمكن التعرف دون عناء على عشرات الجنسيات التي وصل أصحابها إلى ديار مَن غادروها أو دُفنوا تحت ترابها.
لا تترك العروض المسرحية في ظل غياب الحريات العمومية، أي فرصة للتخيل والتنبؤ. كافٍ استعراض أسماء المؤلف والممثلين لإرشاد المتفرجين إلى المسار المحتمل للعرض. والقادمون إلى العرض المسرحي مهيئون بشكل مسبق لاستقبال الهزل (لن يقبل أحد الذهاب طواعية إلى عرض مسرحي مأساوي) برغبة لإزاحة موقتة للوقت المهدور بانتظارات طويلة لعودة المياه والكهرباء والاتصالات والوقود، وترقب انخفاض أسعار السلع والاحتياجات اليومية، واستفسارات طويلة عن مصائر الأقرباء والأصدقاء والجيران الذين توزعوا على ثبوتيات ومخيمات النازحين ومراكز الإقامة الموقتة للمهاجرين.
أخذ المسرح، منذ عهد بعيد في المدينة وغيرها، إلى حتمية الترفيه، متفلتاً من جميع المهام التي وضعها المنظرون المسرحيون على عاتقه من تنوير يتهيأ لوثبة التثوير، بالتلازم مع حتمية إيهام المشاهد – الشعب بأنه من الكفاية الإشارة العابرة لأي مشكلة سياسية، أو لمشاكل الحياة اليومية، أو الاقتراب منها ليتأسس بديل لحل، أو لرفع الأعباء الأخلاقية والنفسية عن وجدان طارحيه... ليتأكد يوماً بعد يوم، وعقداً بعد عقد، أنه لا مسرح يقارب الوقائع دون حريات عمومية وقوانين لحمايتها.
وإضافة للمواضيع التي باتت تقليدية، كالرشى والفساد الإداري، وتحكم الأجهزة الأمنية في الحياة العامة... هناك مواضيع جديدة دخلت في ميتافيزيقا المقاربة المسرحية، التي لم تأت على أي من النتائج التي عملت على مقاربتها درامياً، من حين قررت طرحها وفق هذا المنهج بفرق مسرحية متعددة، كـ "مسرح الشوك" و "دبابيس" و "المضحك المبكي"... وفرق أخرى تتبدل أسماؤها دون أن تتبدل حدود مقارباتها وسردياتها، حتى أضحت مشكلات المجتمع والدولة والسلطة أشبه بالأقدار التي تتحكم بحياة الشعب وتقرر مصيره، وليس له عنها فكاكاً، كقوة الآلهة التي رسمت مصائر أبطال المسرح الإغريقي وتحكمت بها.
انطلقت إستراتيجية الهزل، وفائض السخرية من الأحوال العمومية، لا بغاية الاستعداد لتغييرها، بل لتوطين التعايش معها وتفهم أسبابها! لم يصعد الشعب إلى المنصة، وما انفكت الرغبة المضمرة، عند من صعدوا بالنيابة عنه، ولم ينزلوا قط، هي العمل على إيهامه بأنهم ممثلوه، أي أنهم عينة مخصوصة من الشعب الجالس على مقاعده في العتمة، يتابع الكلام الذي يتبادله بالنيابة عنه المشخصاتية، وينسبونه إليه.
***
ليس غريباً أن تُشغَل كل مقاعد الصالة، في مدينة طالما أحب أهلها السعي إلى الأعياد والبهجة والمرح... وليس غريباً كذلك أن يتصاعد التصفيق عند نطق الممثلين والممثلات لعبارات تؤكد على أهمية "المصالحة بين الأبناء والأخوة"، وضرورة الإنهاء الفوري للحرب، لأنهم يريدون مخرجاً من هذا النفق الدموي، ويصفقون عند ذكر اسم بلادهم، كأنهم يبعثونه حياً من بين الأنقاض، مبددين خوفهم عليه من مخاطر تحاصره لتمزيقه وإتلافه.
ويصمتون عند ذكر المخططات المسماة مشبوهة، والقوى التي ترسمها وتعدها وتنفذها، وفق ما يحدده المشخصاتية ويؤكدونه بتكرار تعليمي: الماسونية والصهيونية العالمية والدوائر الشيطانية، فضلاً عن حزمة من الدول تبدأ من الولايات المتحدة وتنتهي بدول من الخليج العربي... كأنهم يرتجلون بخيال أعجف مشكلة سهلة، ويعملون بسهولة أكبر على حلها.
ويبقى من يتساءل بصوت خافت: ترى لماذا يتآمر هؤلاء علينا، ولا يتآمرون على غيرنا، أم أنها حصتنا من فائض تآمرهم...؟ ولماذا لا نرد لهم صاع التآمر صاعين بأن نبدأ بالتآمر عليهم؟
انتقل "الشعب" في المسرحية إلى مركز لجوء في ألمانيا، وأمسى تحت إشراف جهات متعالية ومتعجرفة وذات ملامح وسلوك بوليسي، أخذت على عاتقها مهام المراقبة والدعم النفسي، ومتابعة الاندماج بتعلم اللغة الجديدة والقوانين الناظمة للمجتمع، التي تتوزع بين حقوق وواجبات المهاجر، وإعداده ليصبح مواطناً.
من حيثيات الحياة في المركز، تجري مقاربة أحوال الذين لم يهاجروا. وتجري الالتفافة إلى المتحكمين بالمولدات التي تبيع الكهرباء، وتجار المواد الغذائية التي لا تصلح للاستخدام البشري، إلى باعة رخص الأكشاك، إلى الموظفين المرتشين، النازحين، مراكز توزيع المعونات الغذائية والإشراف الصحي والطبي. ليصل العرض إلى الزواج بين ولدّي مهاجرين واحد معارض وآخر مؤيد... وإنجابهم طفلاً.
لم يقتنع المشاهدون الذين يتابعون العرض المسرحي، ولا فريق المتابعة الألماني، بقرار الممثلين وهم بمثابة "شعب متخيل" قرر الرحيل جماعياً إلى ألمانيا، لذلك من غير المجدي التحري عن أسباب قرارهم الجماعي في نهاية العرض، بعد قرار إحدى شخصيات المسرحية خلع غطاء رأسها إرادياً، لتحفيز زوجها الذي لم يعد يهتم بها على العودة إلى "حضن الوطن"، كناية عن الوطن بعد إضافة حضن له... في الوقت الذي تقدم آلاف الطلبات مسندة بالأوراق الثبوتية في المراكز الرسمية للهيئات التابعة للأمم المتحدة، لمغادرة الوطن والتفلت من حضنه... فضلاً عن الملايين الذين سبقوهم، وتوزعوا على أربعة أطراف الكوكب، ولم يسعفهم الوقت لحمل أوراق هجرة من المؤسسات الدولية ومكاتبها الرسمية.
تأخر العرض نصف ساعة، وتوقف لأكثر منها بسبب تعطل المولد، ورزح الجميع في عتمة تامة، ربما كي لا ينسوا أنهم يعيشون في مدينة بلا كهرباء. ويبقى الليل البهيم يسدل على الطرقات رداء عتمته، لا تبددها إلا الإضاءات الخجولة من الشواحن الكهربائية الصغيرة التي لم ينس أي من المشاهدين حملها في حقيبته، لعلها تضيء طريق عودتهم إلى بيوت تضيء بأصوات أهلها، وبأنفاس لم تقطع حياتها بعد النصال المشحوذة.