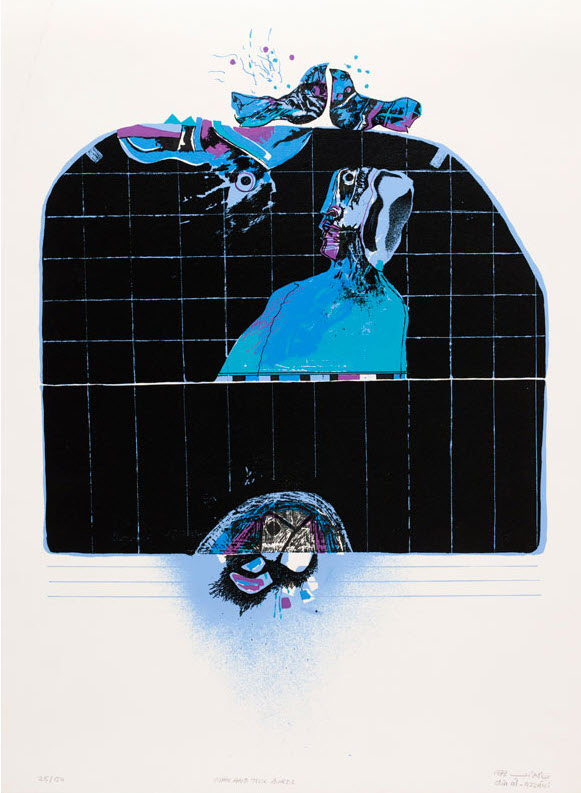هل يمكن الإشارة، في تاريخ فلسطين الحديث، إلى ما يفوق النكبة وهزيمة 1967 من حيث الأذى؟ هذه مجازفة فكريّة، فما الذي يُمكن مقارنته بأبشع أشكال التطهير العرقيّ، وما الذي يُمكن مقارنته بتساقط أكبر الأقطار العربيّة (والأهم، المشروع العربيّ لتحرير فلسطين) أمام إسرائيل خلال أيّامٍ قليلة؟ مادياً، ومن حيث الوقع التاريخيّ المباشر، لا شيء يُمكن حمله في ذات الكفّ. وعلى الرغم من ذلك، وباقتضابٍ شديد، فإن اتفاقيّة أوسلو التي وُقّعت في مثل هذا الشهر من العام 1993، تضاهي من حيث المصاب "المعرفي" (وبتشديد على "المعرفي") ما شهده الشعب الفلسطينيّ من كوارث في العامين 1948 و1967.
مصاب "معرفي"
يستند هذا التقدير إلى التغيير الحاد والشامل الذي أحدثته هذه الاتفاقيّة في المعرفة السياسيّة الفلسطينيّة، إذ تشكّلت على أثر أوسلو بنية تحتيّة متماسكة، وعلى جميع الأصعدة، لصياغة نظامٍ مفاهيميّ جديد بالنسبة للقضيّة الفلسطينيّة. صحيح أن المفاهيم القديمة لم تندثر من الوجود، وما زالت مستخدمة في البلاغة السياسيّة العربيّة، إلا أنها مفاهيم لم تعد واقعة في الحاضر ولا محركةً للمستقبل. بمعنى أنّها، وإن بقيت في ذاكرة الناس وعاطفتهم، فقدت وظيفتها السياسيّة العملانيّة.
تغيّرت بشكلٍ جذريّ مفاهيم معرفيّة أساسيّة بالنسبة لقضيّة فلسطين: ما هي جغرافيا فلسطين؟ من هو الفلسطينيّ؟ ما هي قضيّة فلسطين؟ وما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟ صارت جغرافيا فلسطين تعتبر الخليل (وليس بئر السبع) جنوباً وجنين (وليس صفد) شمالاً، أما مركزيّة اللاجئ في تكوين هويّة "الفلسطينيّ" فاستُبدلت بمركزيّة الخاضعين للحكم العسكريّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وصار "الفلسطيني" هو الموجود في فلسطين لا المطرود منها، لذلك فإن قضيّته هي قضيّة الاستقلال في أرضه لا العودة إليها، وهذه مسألة دولة وليست مسألة وطن، مسألة كيانٍ سياسيّ، لا مسألة وجود إنساني.
أين الجديد في أوسلو؟
تُغيّر الأحداث التاريخيّة دائماً مفاهيمَ سياسيّة واجتماعيّة وفكريّة. أكثر من ذلك: إننا بالأصل نُعرف الأحداث السياسيّة على أنّها تغيّرات جديدة في مجال ما (السياسي والتاريخي مثلاً)، تُعيد تعريف ما سبقها في هذا المجال باعتباره سبباً لوقوعها. وتتفاوت هذه الأحداث في حجمها، بلا مقارنة لهذه الجهة بين حصار بيروت مثلاً، من حيث تاريخيّته، وعمليّة كمال عدوان عام 1978، أو الثورة الناصريّة في مصر بتأسيس "حركة الأرض" عام 1959 داخل الخطّ الأخضر. وعلى الرغم من الاختلاف في الحجم، تُغيّر هذه الأحداث ـ كلّها ـ معرفتنا، تطوّرها وتزيد من إدراكنا لدور كل عاملٍ من العوامل في دفع التاريخ باتجاه لحظة الحاضر. فما الذي يجعل اتفاقيّة أوسلو حدثاً مختلفاً عن غيره، وأشد وطأةً وخطورةً؟
تتصل هذه الأحداث المذكورة فيما بينها، وغيرها الكثير، باستمراريّة تاريخيّة ومعرفيّة. يؤدّي مفهوم معيّن منها إلى أفعالٍ لها نتائج، وتعيد هذه النتائج بلورة مفاهيم جديدة لتتفاعل من جديد. لكنّها تبقى كلّها جزءاً من مسار معرفيّ متواصل. بيدَ أن أحداث أخرى في التاريخ تكسر هذه الاستمراريّة، تلفظ ماضيها وتؤسس مجالاً جديداً من المعرفة، عالماً جديداً يُعيد تعريف كل عوامله، حتّى أنه يعيد تشكيل الأسئلة من جديد، وهو في الغالب يوسّع هذا المجال المعرفيّ، ويزيد من دقّة وتعدد احتمالاته.
في فلسفة العلوم، يصف الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار هذا النوع من الأحداث على أنه "قطيعةً معرفية" (Epistemological Break). وهي التسمية التي استخدمها التوسير في قراءته لكارل ماركس، باعتبار هذه الفلسفة قطيعةً مع الفلسفة الهيغليّة. ومن بعد التوسير ميشيل فوكو. وعربياً، حاز المصطلح على اهتمامٍ في الفلسفة الإسلاميّة الحديثة (محمد أركون مثلاً) في جدل القطيعة المعرفيّة والتاريخيّة مع التراث. وترفض القطيعة المعرفيّة أن تشكل استمراريّة وتطويراً لمفاهيم العلوم القائمة، إنما تخلق ميداناً جديداً يتأسس على عقلانيّتها الخاصّة.
فلسطينياً، وفي السياسة، تختلف اتفاقيّة أوسلو جذرياً عن غيرها من الأحداث، إذ أنها أخضعت الفلسطينيين لمجالٍ جديدٍ في المعرفة السياسيّة لم تكن عقلانيّتنا السياسيّة خاضعة له حتّى لحظة من قبل. وذلك نتاج عملية اجتماعيّة وسياسيّة طويلة بدأت بالانسحاب من بيروت ولا تزال تتفاعل حتّى اليوم، واكبتها في حينه وأثّرت عليها بقوّة عوامل دوليّة وإقليميّة موضوعيّة، كنتائج الحرب الباردة، حيث هزم الاتحاد السوفياتي وتفكك، وتدمير العراق في حرب الكويت، وهي أحداث غيّرت وجه المنطقة والعالم، وكان لها وزن أساسي في الدفع باتجاه قبول أوسلو.
ليس هناك ما هو أخطر من أن يدخل الإنسان هزيمته مزهواً بالنصر: إنه أسوأ أشكال الوعي الزائف، وأكثرها ضرراً.
ليس في علم السياسة، كما في غيرها من العلوم، عقلانيّة واحدة، وإنما مناطق عقلانيّة مختلفة يخضع لها الإنسان. لقد دخلنا عبر أوسلو منطقة مختلفة من المعرفة السياسيّة، واضطرت السياسة الفلسطينيّة إلى إعادة صياغة نفسها بما يتلائم مع هذا العالم الجديد. وعليه، فإنّ التغيّر في الأجوبة لأسئلة "من هو الفلسطيني؟" و"ما هي جغرافيا فلسطين؟" و"ما هي قضيّة فلسطين؟" ينبع أصلاً من سؤال أهم: "ما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟".
ما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟
لعلّ أهم ما يُحسب للثورة الناصريّة تاريخياً، هو إدراكها العميق للعالم الذي تنتمي إليه. ولذلك إشارتين هامتين: الأولى في"دوائر" عبد الناصر، العربيّة والإسلاميّة والأفريقيّة ـ وهو العالم الذي اختارت الناصرية أن تتفاعل فيه، بمنطقه وعقليّته، وأن تدفعه إلى الأمام من خلاله لا من خارجه. أما الإشارة الثانية ففي الانخراط الفعّال بحركة عدم الإنحياز ـ وهو العالم الذي رفضت الناصريّة العيش فيه، وبالأحرى، هما العالمان (الأميركي والسوفياتي) اللذان رفضت الناصريّة العيش فيهما. واستمدّت الناصرية من ذلك أصولها المناهضة للاستعمار، بمعنى أنها استمراريّة لعوامل كانت حاضرة في السابق.
لقد عبّرت الناصريّة عن هذا "العالم" بكلماتٍ واضحة، لكنّ عملية الاختيار هذه تنطبق على كلّ حركة سياسيّة منذ لحظة ولادتها. كانت مقاومة الصهيونيّة في فلسطين استمراراً طبيعياً لبدايات الحركة القوميّة العربيّة مطلع القرن العشرين. وظلّت، حتّى ثمانينيات القرن المنصرم (والانسحاب من بيروت تحديداً) تحوم في فلك المقاومة للامبرياليّة الغربيّة. وقد تحالفت، بشكلٍ طبيعيّ، مع اليسار الثوريّ في الوطن العربيّ، ومع حركات التحرر في أميركا اللاتينيّة، ومع التنظيمات الثوريّة في أوروبّا. وكانت هزيمة العرب في النكبة، كما هزيمتهم في العام 1967 شكلاً من أشكال "الاستمراريّة" المنسجمة مع وجودهم في هذا الفلك السياسيّ.
بعدها، فقد تحوّلت فكرة "الاعتراف بمنظمة التحرير" إلى تسمية مرادفة لـ"اعتراف الدول الغربيّة بمنظمة التحرير"، وبالتالي التفاوض والتحاور معها، وهو ليس اعترافاً مجانياً إنما مشروطاً بالانضواء تحت المنظومة الديبلوماسيّة. وهو ما تطلّب، كقرارٍ استراتيجيّ، هيكلة منظمة التحرير على هذا الأساس.
بهذا المعنى، فقد كانت عمليّة أوسلو تتويجاً لانسلاخ القضيّة الفلسطينيّة عن عمودها الفقريّ اليساريّ الكونيّ وقبولها الدخول في فلك الهيمنة الليبراليّة التامّة ـ وهذه "منطقة عقلانيّة" مختلفة كلّ الاختلاف، أحْوجت الفلسطينيين إلى إعادة صياغة جميع المفاهيم السياسيّة والفكريّة، وإخضاعها جميعها إلى المنطق المسمّى بـ"الشرعيّة الدوليّة"، وبالتالي التسليم بروايةٍ تاريخيّة تبدأ الصراع من العام 1967، وتعترف بشكلٍ أو بآخر بحق اليهود في تقرير مصيرهم على أرض فلسطين، فتُعيد تعريف اصطلاح "المناطق المحتلّة" وبالتالي تصيغ الهويّة الفلسطينيّة. وإن لم يكن ذلك كافياً، فقد أعاد أوسلو أيضاً تعريف "العدو" بالنسبة للفلسطيني، فأصبح "اليمين الإسرائيلي" الذي اغتال "الصديق" رابين هو العدو، وليس الصهيونيّة كأيديولوجيا استعماريّة وعنصريّة. ويشمل ذلك رهاناً على "اليسار الإسرائيلي" (حزب العمل وتفرعاته)، رغم أن هؤلاء، للتذكير، هم ذاتهم من نفّذوا جرائم 1948 و1967 بيديهم. لقد تغيّر كلّ شيء، بما في ذلك قوانين اللعبة.
.. ولأن الهزيمة أيديولوجيّة وليست عسكريّة أو سياسيّة أو ماديّة، فالانبعاث من رمادها أكثر صعوبةً.
انطلاقاً من مبدأ "تأسيس الدولة"..
لذا فلا بدّ من مقاربة اتفاقيّة أوسلو كأيديولوجيا. ليس بالمفهوم المتداول عموماً للأيديولوجيا على أنها مجموعة أفكار يتبناها الإنسان لنفسه. إنما بمفهوم الأيديولوجيا التي تُهيمن على جميع مناحي الحياة ابتداءً من اللغة ونُظُم المجتمع. وبهذا المفهوم، فإن اتفاقيّة أوسلو ليست، بأي شكلٍ من الأشكال اتفاقيّة إداريّة، بل مدخل إلى منظومة فكريّة شاملة ضربت قلب الشعب الفلسطينيّ وأعادت تشكيل عقلانيّته. وبدأت عمليّة مأسسة الأجهزة الأمنيّة نظامياً، وتحويلها "وكالةً قمعيّة" في خدمة أيديولوجيا السلطة هذه، إلى جانب بناء واسع بأموال غير محدودة للمؤسسات "المدنيّة" التي أعادت إنتاج أيديولوجيا أوسلو من خلال التزاماتها بأجندات الممولين، شاغلة دور "الوكالة الأيديولوجيّة للدولة"، وأخضعت الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة لعقليّة اقتصاديّة ليبراليّة ليكتسحها القطاع الخاص من مقاولين وشركات ومصارف انطلاقاً من مبدأ "تأسيس الدولة"، وهو ما سحق مبادئ أساسيّة لمجتمع مناضل كالتكافل الاجتماعيّ، وخلق بهذا نخبةً فلسطينيّة جديدة تمتلك القرار السياسيّ والثقافة السياسيّة انطلاقاً من مكانتها الطبقيّة التي تُمكنها من امتهان السياسة التي باتت تعتمد قبل كلّ شيء على الديبلوماسيّة تجاه الغرب. وقد خلق هذا، في ظل استمرار الجريمة الصهيونيّة يومياً، انشقاقاً عنيفاً داخل المجتمع الفلسطينيّ اتّخذ أشكالاً فصائليّة. فكان الانقسام الفلسطينيّ بين الضفة وغزة عبارة عن انفجارٍ شبه حتميّ للفجوة الهائلة في لحظة الانسداد التام لمجالات العنف الثوري، مع خمود الانتفاضة الثانية. هذا كلّه، علاوة على نفي اللاجئين عن الوجود السياسي مع هجر منظمة التحرير لقاعدتها الشعبيّة في الشتات وإنهاء وظيفة اللجوء السياسيّة. وعلاوة على التسليم النهائيّ بمصير المواطَنة الإسرائيليّة للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلّة عام 1948.
تيه الهزيمة
ليس هناك ما هو أخطر من أن يدخل الإنسان هزيمته مزهواً بالنصر: إنه أسوأ أشكال الوعي الزائف، وأكثرها ضرراً، وهذا تحديداً ما فعلته منظمة التحرير الفلسطينيّة قبل 23 عاماً في أوسلو. ولأن الهزيمة أيديولوجيّة وليست عسكريّة أو سياسيّة أو ماديّة، فالانبعاث من رمادها أكثر صعوبةً. الهزيمة الأيديولوجيّة، تلك التي تحلّق واهمةً في تيه النصر، هي التي وضعت البنية التحتيّة للحالة التي وصلت إليها فلسطين اليوم، وهي حالة مرعبة لا تنفصل عن المشهد المروّع الذي يعيشه الوطن العربيّ برمّته. وهذا النوع من الهزيمة لا يخلّف الصدمة ولا يشكّل حافزاً، لا يتيح رفع ركام الهزيمة ولا يُعيد البناء من تحته، إنها هزيمة يعمّر أصحابها بنيانهم المستقبليّ عليها، فوق الحُطام، فنتفاجأ كل مرةٍ من جديد في سقوط عمرانها. إن تكرار محاولة النهوض والسقوط كلّ مرة من جديد على الأساس الأيديولوجيّ ذاته، لا بدّ لها أن تفضي في النهاية إلى صيرورة يأس تعيسة، خاصةً أن عدوّنا مستمر في دراسة تشييد بُنى القمع والطمس والجريمة التي تهدف بالأساس، وقبل كل شيء، إلى بعث اليأس فينا.