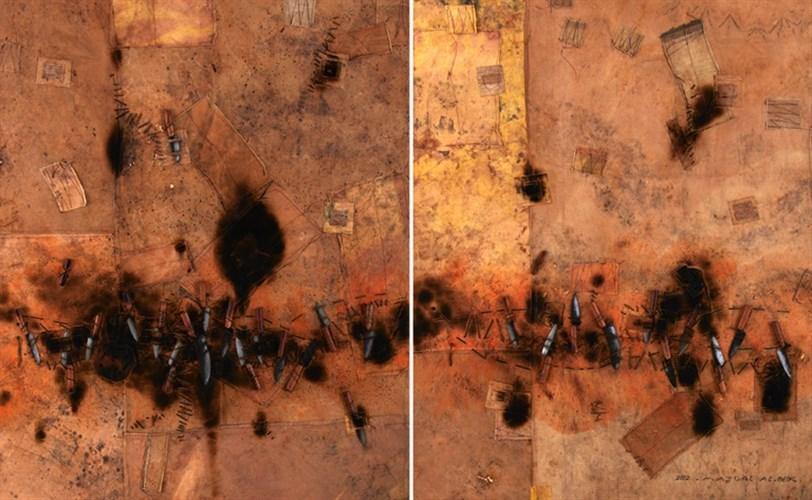في "الكيا" (الاسم الشائع لسيارات الاجرة الكبيرة في العراق، وهو مشتق من ماركة السيارات الكورية) حيث أركب الآن، يحدث ضحك كالبكاء. كتبتُ ذلك في مفكرة هاتفي لأتذكر الموقف والرجل. عجوز بغدادي، تجاعيد وجهه، وفراغات أسنانه التي سقطت منذ زمن بعيد، تاركةً فتحات تشبه تلك النوافذ الخشبية القديمة التي رأيتها فوق مقهى حسن عجمي في شارع الرشيد، والجلد المترهل على رقبته، وكل هذه السخرية وتصنّع الضحك، تشي أن الرجل عاش بما يكفي ليطور آلية دفاعية ضد القهر، وأسلوباً فجَّاً للتعامل مع الحياة اليومية في هذه المدينة، الحياة الفجة كذلك.
جلست وجهاً لوجه معه، وللحظة اعتقدتُ أنَّه شخص خُلِق من النيكوتين والتبغ، رائحته تشبه منفضة سجائر، وحين يتحدث - في الحقيقة هو لم يسكت أبداً - كان لعابه يتطاير على وجهي، ورائحة فمه الكريهة تصيبني بالدوار والغثيان، ولولا أنني كنت أمد رأسي خارج النافذة مثل كلب العوائل المترفة، لتقيأتُ كل أحشائي.
عندما أوقفت الكيا وركبت، كان يمسك سيجارة ويغني شيئاً يشبه المقام، صوته كان جميلاً، يشبه صوت يوسف عمر، وحين صعد بصوته مع كلمة آآآآخ، مدَّ رأسه نحوي وقال: جرّه. وأطلق ضحكةً جعلت الركاب يدخلون في نوبة هستيرية من الضحك. ضحكاتهم جعلتني أضحك، وكنت مندهشاً في اللحظة الأولى ومرتبكاً، لكنني أحد الركاب الآن، الأمر يستحق المجازفة! لنضحك معاً.
هذا العجوز لا يدخن السيجارة، إنه يمصّها، ولا يكاد يُخرج الدخان من رئتيه مثلما يفعل المدخنون، وحين انتبه إلى يده، وأدرك أن سيجارته وصلت إلى عقبها، مدَّ يده الأخرى إلى الأعضاء التناسلية للرجل الذي يجلس إلى جانبه وسأله: عندك جكارة؟ ثمَّ تجدد الضحك مرة أخرى، وأخرج له واحدة، وحين أخذها قال له: خوش جكارة طويلة هههههههههه.
ماذا يحدث يا إلهي، إنها نوبات من الضحك على أشياء ليست مضحكة. سخرية هذا العجوز معدية، لا تستطيع إلا أن تُصاب بها، كنتُ أبكي من شدة الضحك، وهذه صفة ورثتها عن أبي، نحن في العائلة حين نضحك تتسابق قهقهاتنا مع دموعنا، وعلى رأي تشارلز داروين فإنه من الصعب أحياناً التفريق بين البكاء والضحك، هل حقاً أنا أبكي أم أضحك في هذه الكيه؟
نضحك لأننا حيوانات تعاني بوحشية
العراقيون بحاجة للضحك، وإلا فكيف نعبر هذه الأيام الرديئة؟ مدَّ العجوز رأسه من النافذة وشتم سائق سيارة نوافذها مغلقة ومظللة: ها أخ الكحبة.. مشغّل تبريد، نعله على نيج عرضك. ثم أدخل رأسه مرة أخرى: هذا واحد من كواويد المنطقة الخضراء، خرا بالعراق، الشمس شمسي والعراق عراقي، طييييط، هاهاهاها بلد ما بيه شريف، سلمتك بيد الله يا محملني أذية وآه آآآه آآآآه. أطلق هذه الآهات على طريقة الأفلام الإباحية، واكتظت الكيا بالضحك العالي مجدداً.
لا يبدو على ذلك العجوز الفقر بقدر ما يبدو عليه التعب، والضجر من كل شيء. إنه يحيل في نكته وأحاديثه إلى أسماء وأغنيات وأحداث ومواقف هي بالنسبة لنا في العراق مسببات للبكاء، وكأنه يطبق عملياً ما ينظِّر له عالم الانثروبولوجيا ديزموند موريس في كتابه "القرد العاري" من أن الضحك تطور عن البكاء. لقد عشت تلك التجربة العملية في ذلك المختبر الصغير/الكيا.
ماذا يحدث يا إلهي؟ إنها نوبات من الضحك على أشياء ليست مضحكة. العراقيون بحاجة للضحك، وإلا فكيف نعبر هذه الأيام الرديئة؟
هذا العجوز يضحك ويسب ويضحك، وحين يبدأ بأي حديث سرعان ما يحوله إلى دعابة جنسية، يستخدم لسانه وصوته ويده لذلك، لا يتردد أبداً في مد يده إلى الأعضاء التناسلية للآخرين، الرجال بطبيعة الحال. النساء يستخدم معهن الألفاظ والتورية المكشوفة فقط. فمثلاً حين نزلت إحدى النساء من الكيا، سألها: هل أنت عجّانة؟ فقالت له: لا. وحين أغلقت خلفها باب السيارة، قال: لو يجي ربج عجانة! فسأله أحد الركاب: حجي مو قالت لك مو عجانة. فرد: وهذا الطيز؟ هاهاهاهاها. إنه وقح حد أن ترغب في البصاق عليه، لكنه يجعل الآخرين يضحكون في المدينة العابسة.
كنت أخشى أن أصل إلى وجهتي، الباب الشرقي، وهو لم ينزل بعد، أردت أن ينزل قبلي مخافة أن أكون أحد أسباب ضحكاته تلك. وبالفعل، بعد أن مص آخر سيجارة حتى نهايتها، صاح: نازل نازل ومعها آه جنسية طويلة. وحين أغلق الباب قال للجميع: كلكم تضربون بلنكو وآني أكبر أخ كحبة بيكم، (البلنكو كناية عن الكحول بكل أنواعه).
إنها جرعة زائدة من الضحك، ضحك على أشياء مضحكة، وضحك على الضحك، وضحك غرائبي على أحداث حين يتذكرها العراقي مع نفسه يشتهي أن يبكي، ويصرخ، ويغضب. لكن ذلك العجوز كان حيواناً قادراً على الضحك لأنه كان يعاني بوحشية، كما يقول نيتشه، ونحن حيوانات مثله أيضاً. لقد عانينا بوحشية.
ما أن نزل العجوز، حتى عاد كل شيء إلى طبيعته. نحن، والمزاج الواجم داخل الكيا، كأننا عدنا من رحلة مؤقتة. الوجوه عادت عابسة، والصمت ملأ الحيز الذي كان يشغله ذلك الرجل الصاخب، لم يبق منه غير رائحته الثقيلة، رائحة الدخان والنيكوتين.
في الوقت الذي كنت أضحك فيه من سخرية الرجل العجوز، كان لدي إحساس بالتحفظ يشبه العائق، يمنعني من الضحك بصوت أعلى، وبحرية مطلقة. ذلك الاحساس هو الخوف، والشعور بأنني غريب، لا أعرف الآخرين، كان شيء ما يمسك برغبتي في الضحك الحر، لم يكن إحساساً أعلى بالواجب كما يصفه هيغل في فلسفته للفنون الجميلة، لا، كان إحساساً بالخوف، الخوف الذي أحمله معي أنّى ذهبت في العراق.
أفكر بذلك العجوز دائماً، لم يكن متحفظاً بالمطلق، يسخر من كل شيء، حتى من التفاتة شخص ما، أو ضحكته، أو سؤاله، يستهزئ بالمارة، والمشاهد التي يراها، ويحيل في كل ذلك إلى مصائب كبرى أودت بالبلاد إلى هذا الانحدار الذي نضحك عليه الآن. إنها طريقته للنجاة ربما، أو للاستمرار، وقد تكون أسلوباً احتجاجياً على العنف. لا أعني عنف السلطة، أية سلطة، وأجزم أنه عاش زمن كل الجمهوريات العراقية حتى الآن، الجمهوريات الخمسة، ليس العنف الذي انتجته وتسببت به تلك الجمهوريات ما أقصده، بل عنف الحياة بالمطلق.
كل ذرة في جسدي كانت تتوسل طلباً للنجاة
في الغرفة الرطبة، بفندق زوزك، أعدتُ ترتيب الحقيبة، وكتبت رسالة إلى صديقي مهند، الذي ينتظرني في إسطنبول، قال لي: غرفتك في البيت جاهزة، وسأنتظرك في صالة استقبال المسافرين في مطار أتاتورك. وأخبرني ماذا أفعل حين أصل إلى هناك.
وأنا أتفحص الغرفة مخافة أنني نسيت شيئاً، انتبهت لضجيج أصوات سيارات وأشخاص في الشارع أسفل النافذة. شخص ما يصرخ: مو آني، عوفوني، آني ما عليّ (لا شأن لي بالأمر)، والكثير من العبارات الخائفة، والصراخ والغضب.
مددت رأسي من النافذة: مركبات لا أعرف عددها بالضبط، ورجال مسلحون يرتدون الأسود، وضعوا ذلك الرجل بالقوة في صندوق إحدى تلك السيارات وانطلقوا مثل رصاصة في الشارع، وبينما كان الناس على جانبي الشارع يصطفون لمشاهدة ما حدث، رفعت رأسي إلى السماء وقلت لله: قد لا أستحق حياة جديدة، لكنني أتوسل إليك أن تدعني أنجو هذه الليلة، دعني أخرج من العراق يا الله. قلتها وأنا أشعر بكل ذرة في جسدي تتوسل طلباً للنجاة.
أفكر بذلك العجوز دائماً، لم يكن متحفظاً بالمطلق، يسخر من كل شيء، يستهزئ بالمارة والمشاهد التي يراها، ويحيل في كل ذلك إلى مصائب كبرى أودت بالبلاد إلى هذا الانحدار الذي نضحك عليه الآن. إنها طريقته للنجاة ربما، أو للاستمرار، وقد تكون أسلوباً احتجاجياً على العنف. لا أعني عنف السلطة، أية سلطة، بل عنف الحياة بالمطلق.
كتبت لمهند أنني خارج الآن إلى مطار بغداد، لم أخبره بما حدث حتى لا أدعه يقلق بشأني. حملت الحقيبة ونزلتُ لتسليم مفتاح الغرفة، كان الرجال في مدخل الفندق يتهامسون ويبدو على وجوههم القلق، هنالك شخص اختطف على بعد أمتار منهم، منا جميعاً. إنه أمر مخيف، قلت لمدير الفندق إنني مغادر الآن، وشكرته على كل شيء، لكنه نصحني بالبقاء قليلاً حتى يتبدد الخوف في الشارع، أو يخف قليلاً، فانتظرت في زاوية قرب ركن الجايجي (الشخص الذي يعد الشاي للضيوف ونزلاء الفندق)، وكان قلبي يركض من الخوف مثل عداء المسافات القصيرة.
أغلقت المطاعم والمقاهي الشعبية أبوابها مبكراً، ومثلما يهرب الناس من العاصفة، هربوا وفرغ الشارع كأن لم تطأه قدما إنسان من قبل. ندمت لأنني سمعت كلام مدير الفندق، الشارع الآن يبدو مخيفاً أكثر، لكنني لا أريد أن أصل متأخراً إلى المطار، لا أدري ماذا يحدث هناك أيضاً، فكان علي الخروج.
"من قَتَلَني؟"… ملف الموت والاغتيال في العراق
27-05-2021
حراك الأمهات والدولة المنهارة في العراق
06-07-2021
عند رأس الشارع تقف سيارات تاكسي، أشار إلي السائق الذي حان دوره، فقلت له إلى المطار، فتح لي صندوق السيارة ووضعت حقيبتي، وحين ركبت في المقعد الأمامي، قلت: يا عليّ، تورية مني وعبوراً لسؤال من أين أنت..
ولأنه لا بد من السؤال، قال السائق: وين مسافر؟ قلت: إلى تركيا، وتابعت لأنهي الحكاية على طريقتي: الوالد مريض وسبقوني بيه أهلي لهناك حتى نسويله عملية. كان سائق التاكسي هادئاً لكنه كان شاباً في العشرينيات ويرتدي الأسود، ويطلق لحيته بغير ترتيب، وهذا ما جعلني أرتاب، فقلت عليَّ أن أكذب كالعادة لأكسب التعاطف على الأقل، وهذا ما حدث.
آخر المحطات في العراق
الطريق إلى مطار بغداد الدولي يسمى شارع المطار، لا يشبه شوارع بغداد القذرة والعشوائية والرديئة. هنالك على الجانبين خطين من النخيل لا ينتهيان إلا عند ساحة عباس بن فرناس، والإضاءة على امتداد الطريق تشبه امتداد ذلك النخيل، واللوائح والعلامات المرورية تبدو جديدة وألوانها ما تزال تحتفظ ببريقها الأول، والجزرة الوسطية خضراء، لا تشبه أرض المدينة التي يغلب عليها التصحر، وهنالك أشجار لم أر مثلها في بغداد، وبين مسافة وأخرى هنالك سيارة عسكرية وجنود يقفون على طول الطريق. إنه شارع لا ينتمي إلى تلك المدينة، وهذا يبدو مفهوماً بالنسبة لي على الأقل، فالسلطة تدرك أن شارع المطار يجب أن يكون "شارعاً" بالنسبة للزائرين والوفود الآتين من خارج البلاد، والذاهبين إلى فنادقهم ومقار إقامتهم في المنطقة الخضراء، الممنوعة على العراقيين. هناك حيث تتحصن السلطة وأحزابها منذ 2003، في 10 كيلومترات مربعة، هذه المساحة التي تتحكم بـ 438.317 ألف كيلومتر مربع.
مددت رأسي من النافذة. مركبات لا أعرف عددها ورجال مسلحون يرتدون الأسود، وضعوا ذلك الرجل بالقوة في صندوق إحدى تلك السيارات وانطلقوا مثل رصاصة في الشارع. وبينما كان الناس على جانبي الشارع يصطفون لمشاهدة ما حدث، رفعت رأسي إلى السماء وقلت لله: قد لا أستحق حياة جديدة، لكنني أتوسل إليك أن تدعني أنجو.
ومثل كل شيء في العراق، أتذكر أن جدلاً ومعارك كلامية حدثت بين البرلمان "الفاسد" وأمانة بغداد "الفاسدة" في عام 2011 بخصوص فساد وهدر للمال العام في مشروع تطوير شارع المطار. حينها اتهمت لجنة النزاهة في البرلمان أمين العاصمة حينها صابر العيساوي ودعت لاستجوابه "لأنه صرف أموالاً طائلة على شارع المطار الدولي" الذي بلغت قيمة تطويره 200 مليون دولار.
توقف التاكسي في ساحة عباس بن فرناس، التي تحولت إلى مرآب يجب أن تتوقف فيه قبل ذهابك إلى المطار وقبل خروجك منه إلى المدينة. لا جدوى من هذه الساحة غير جباية الأموال، التي تؤخذ غصباً من المسافر وسائق التاكسي. قال لي السائق: هذا حدي، وعليك أن تركب في تلك "الجمسيات" (سيارات GMC) هناك، فهي التي توصل المسافرين إلى المطار. لم أفهم الأمر لكنني حملت الحقيبة واتجهت إلى تلك السيارات السوداء التي كانت تشبه تماماً السيارات التي رأيتها ضمن الرتل العسكري الذي كان متجهاً نحو عامرية الفلوجة وأوقفنا لمدة ساعتين في الصحراء.
عشرة آلاف دينار (8 دولارات تقريباً) يدفعها كل مسافر يريد الذهاب من ساحة عباس بن فرناس إلى المطار. دفعتها وركبت مع مسافرين آخرين بعضهم ليسوا عراقيين، وكانوا يتساءلون عن جدوى هذا الأمر وغرابته، لكننا دفعنا تلك الأموال التي هي "إتاوة" وليست أجرة، وانطلقنا إلى المطار، آخر المحطات في العراق.
مطار المليشيات الدولي
الخوف الذي كان يقبض على قلبي وأنا أسير في شوارع منطقة البتاوين، وخلال إقامتي بها، هو ذاته الذي يقبض على قلبي في مطار بغداد الدولي. لم يكن عليَّ إلا أن أخاف، لأنني أدري أنه ليس مطاراً كما ينبغي للمطارات أن تكون، وأعرف أنه يُدار من قبل المليشيات المسلحة، وهو تحت سيطرتهم، ولا وجود لسلطة الطيران المدني هناك.
العراق: دولة أم ميليشيات؟
03-09-2014
كتائب حزب الله العراقية، ومليشيات أخرى مثل بدر وعصائب أهل الحق، وقبلها جيش المهدي، هي كلها مليشيات موالية لإيران ولحزب الله اللبناني، هي التي تدير شؤون المطار بشكل فعلي، وتسيطر على الهيئات والشركات والخدمات هناك. وهذا ليس سراً، إنه يشبه البديهيات في العراق، والأسلحة والمقاتلون يمرون منه ويطيرون إلى سوريا ولبنان واليمن قادمين من مدن العراق، وإيران وأفغانستان، ودول أخرى لا يعلمها إلا الراسخون في الولاء لإيران وحرس الثورة.
الطريق إلى مطار بغداد الدولي يسمى شارع المطار، لا يشبه شوارع بغداد القذرة والعشوائية والرديئة. هنالك على الجانبين خطين من النخيل لا ينتهيان إلا عند ساحة عباس بن فرناس، والإضاءة على امتداد الطريق تشبه امتداد ذلك النخيل، واللوائح والعلامات المرورية تبدو جديدة وألوانها ما تزال تحتفظ ببريقها الأول، والجزرة الوسطية خضراء، لا تشبه أرض المدينة التي يغلب عليها التصحر.
منذ 2003، كانت وزارة النقل حكراً على المليشيات، الوزراء هم قادة في تلك المليشيات، بدءاً من مليشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، حيث كان وزير النقل سلام المالكي، ثم الوزير هادي العامري، زعيم مليشيات منظمة بدر، ثم الوزير باقر جبر صولاغ، المعروف عند العراقيين "صولاغ أبو الدريل" والمشهور بأنه أول من أمر باستخدام أجهزة Drills (أجهزة ثقب كهربائية) لثقب الجماجم والأجساد، خلال الحرب الطائفية عام 2006، وكان حينها وزيراً للداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري.
العراق لمن؟
17-09-2020
مررت بمرحلتين من التدقيق "الأمني" في مطار بغداد، وفي كل مرحلة لم يكن هدف "الضابط" أو الموظف، أو المقاتل في مليشيا ما التأكد من أن الجواز مزور أو فيه خطأ أو ما شابه، بقدر ما كان الهدف هو اكتشاف هل أنني مطلوب عند "الدولة" أو تلك المليشيات. فنحن نعرف في العراق أن في المطار قوائم لمطلوبين لأسباب لا تتعلق بأمن الدولة وهذا "الخريط" (الخزعبلات)، وإلا فماذا تفعل المليشيات في مطار العاصمة!
بالكثير من الخوف والدعاء وافتعال الابتسامات الهادئة، عبرت إلى صالة الانتظار، عند البوابة التي تؤدي إلى الطائرة، وكنت أحسب الثواني والدقائق للعبور، ولم أكن متأكداً أنني سأنجو، لكنني كنت على وشك ذلك، وأشعر أنني أقترب من الخلاص، بيني وبين النجاة بوابة وطائرة تقف على أرض ينمو فيها الخوف كما تنمو الأدغال في الأرض المتروكة.
لقد نجوت
عندما صعدت إلى الطائرة، كان قد مرَّ على سقوط الموصل بيد تنظيم داعش أربعة أشهر، وبينما كنت أبحث عن مقعدي رأيت علي غيدان، فريق أول ركن وقائد القوات البرية العراقية لحظة سقوط الموصل وثلث العراق بيد التنظيم. لم استوعب اللحظة، إنه على الطائرة نفسها! تباً! لابدَّ أنني أتوهم، أو أنني أرى كابوساً. كيف يُعقل هذا؟ أليس من المفترض أن يكون في السجن؟ على الأقل، وإلا فأربعة أشهر كافية ليتفسخ ويأكله الدود في قبره، بعد رميه بالرصاص في ساحة عامة.
إنه هو، بشحمه ولحمه وشواربه المصبوغة! يجلس مع عدد من الأشخاص (بينهم نساء) مما يبدو أنها عائلته، ويبدو عليه البرود. لم أكن متأكداً من أنه هو، وقلت في نفسي ما لكَ وله يا نازح! ربما قد شُبّه لك، جد مقعدك اللعين، وحاول أن تصل بسلام إلى إسطنبول، لكنني طوال الرحلة، كنت أفكر بالطريقة التي سأتأكد بها من هويته، من إنه علي غيدان، الذي تسبب لي ولملايين النازحين بكل ما حدث. إنه المجرم والمنهزم الذي تسبب لي بكل هذا الخوف، وتجريب الموت بما لا يُحصى من المرات، كنت أريد أن أبصق عليه، وأشتمه، وأخنقه، كنت أريد أن أنتقم، لكن عليَّ أن أتأكد أنه هو قبل كل شيء.
مررت بمرحلتين من التدقيق "الأمني" في مطار بغداد، وفي كل مرحلة لم يكن هدف "الضابط" أو الموظف، أو المقاتل في مليشيا ما التأكد من أن الجواز مزور أو فيه خطأ أو ما شابه، بقدر ما كان الهدف هو اكتشاف هل أنني مطلوب عند "الدولة" أو تلك المليشيات.
كان مقعدي قرب نافذة على الجانب الأيمن من الطائرة، حين أقلعت الطائرة، وصعدنا إلى السماء، رأيت بغداد، مظلمة في الغالب، الأضواء تنتشر عليها مثل ثقوب في عباءة سوداء، والمشهد من الأعلى لا يقل كآبة عن المشهد في الشوارع والأحياء، لكن القمر كان بدراً تلك الليلة، دائري مثل مصباح وحيد معلق فوق مدينة بعيدة، ها هي بغداد تبتعد، وتتوارى في الظلام، والطائرة تدخل في الليل.
المسافة كانت تتسع للبكاء والفرح، وكافية لأمرَّ على جثة ذلك العمر الذي أتحرر منه الآن، أدوس عليه بكل هذا الغضب والحزن الذي يشتعل بجسدي الطائر في السماء الآن، ولم استوعب أنني أطير فوق تلك الحفرة، فوق تلك المقبرة، فوق ذلك السجن المرعب، فوق ذلك العراق.
المرة الأولى التي رأيت فيها إسطنبول من السماء، كانت تشبه شجرة عيد الميلاد، شاسعة ومتلألئة، لن أنسى تلك المرة الأولى. ولدٌ خرج لتوه من الحرب والظلام، ويدخل في كل هذا الضوء! لم أر بحراً من قبل، ولم أر مدينةً في حياتي، وها أنا الآن، أهبط من الكابوس إلى الحلم، إلى إسطنبول، المدينة التي آوتني، يوم طاردني العراق.
عند المكان المخصص لاستلام الحقائب، أخذت حقيبتي وذهبت إلى علي غيدان، كان ينتظر مع ثلاث نساء، إحدى النساء كانت مقعدة على كرسي متحرك، كبيرة في العمر، وكان يقف هو مرتدياً معطفاً أسود، حين اقتربت منه قلت له: إنت علي غيدان؟ فرد: نعم، تفضل؟ شعرت حينها أنها لحظتي، وعليَّ الانتقام بالكلام على الأقل، وكنتُ خائفاً من إحداث مشكلة تتطلب تدخل أمن المطار، ولست بحاجة إلى هذه المصيبة. قلت له:
- أتفضل! على شنو؟ الله لا ينطيك، انت وأمثالك السبب بكل الي صار بينا، بسببك اني هنا هسه، بسببك نزحت وإنقتلوا أصدقائي وعفت أهلي وبيتي، الي مثلك خائن وجبان لازم ينعدم، يا كلب.
تركته ومضيت، لم يقل شيئاً ولم ألتفت إليه، وكنت أمشي نحو صالة استقبال المسافرين وأقول في نفسي: لقد نجوت، وفي النهاية حصلت على انتقام صغير. مهند كان ينتظرني رفقة ابتسامته مع الحشود التي تنتظر أحبتها في الصالة، ذهب كل تعب الحياة وأنا أعانقه وأبكي، وأقول له: لقد نجوت يا مهند.. لقد نجوت.
نوفمبر.. موعد للرحيل أو الهرب
15-04-2021
بغداد.. مدينة القتلى والظلال الطويلة
22-04-2021
سأموت هنا.. في العراق
13-05-2021
الجنود يحرسون الحرب
04-06-2021
أبي يحب الله ويكره رجال الدين
10-06-2021
لا شيء يجلب الحب في بغداد
02-07-2021