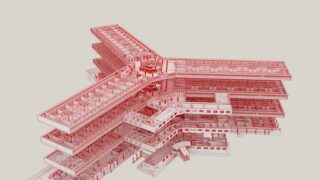أثناء نشأتي في مرابع دمشق، تكوّنت لدي صداقة مع ابن شيخ، ومؤذن مسجد، ورجل دينٍ معروف في منطقته، وابنة ضابط أمن له حظّه من الصيت والسلطة أيضاً. لم يكن لهذين النموذجين أن يكونا أشد اختلافاً، فقد كانا من طائفتين مختلفتين، وبيئتين اجتماعيتين في غاية التباين. لكن ذلك لم يمنع أن تُفضي قصتهما إلى نتيجة واحدة: كان كلاهما ضحية لنوبات دورية من العنف والغضب الأبوي. على مرّ السنين، قاوم كلاهما تاريخ الجراح بروح شديدة المرح والتعاطف، ولم يكن يعرف أغلب رفاقنا المشتركين بنوعية الأهوال التي يتعرض لها هذان الطفلان (ومن ثم المراهقان لاحقاً).
حين أسترجع تلك الأيام أستغرب من تفنّن الآباء بألوان الإيذاء والمستوى الذي يدلّ على اقتراب الأب من شهوة التعذيب أكثر من كونها مجرد نوبة غضب عابرة. كان الشيخ أحياناً يقيّد ابنه للنافذة في طريقة تشابه الصلب ويبقيه هناك لساعات، وكان يخترع أحياناً نوعيات جديدة من التعليق رأساً على عقب في الحمّام، وجلده بالسوط حتى يتعب – الأب - مرفقاً ذلك بأنواع التعنيف الكلامي. الضابط بالمقابل كان لديه نمط مختلف من التعنيف، إذ كان يحلو له أحياناً حين يعود ثملاً بعد منتصف الليل أن يوقظ أبناءه جميعهم –من بينهم صديقتي- ويضربهم بأساليب مختلفة. في إحدى المرات كان الضابط غاضباً بصورة مفرطة عن العادة، وحين لم يعلم ماذا يفعل، أمسك بجهاز الـDVD المنتشر في البيوت آنذاك، ورماه عشوائياً على أحد أبنائه ليصيب جزءاً من رأسه ويُدميه. وفي مرة أخرى ضرب صديقتي بحزام له أطراف معدنية، وحين أتت إلى المدرسة في اليوم التالي، أخذتني إلى الحمامات لتُريني سرّاً الآثار على مناطق مختلفة من جسدها.
التعليم في سوريا، مسيرة نحو القاع
02-04-2019
الحرب ندبةٌ فوق مقاعد الدراسة في سوريا
14-04-2016
لا أكاد أحصي النماذج التي شهدتها في حياتي لحالات العنف المنزلي والقسر والإيذاء الجسدي والنفسي على حد سواء، لكن يبرز هذان النموذجان في عقلي لشدة شبههما واختلافهما في الوقت نفسه. بدا وكأنّ صديقتي قد شكلت مناعة ضد الحزن، كانت أكثرنا ضحكاً في الصف وأشدنا استثماراً لكل لحظة، وحين كنا نتشكّى من شيء ما يحدث في بيئتنا، كانت تواسي الباقيات وتضاحكهنّ حتى ينسين. لم تشارك همّها مع الأخريات أبداً، وربما كانت ساعات الدراسة المساحة الآمنة الوحيدة لها بعيداً عن رعب المنزل، المكان الذي تستطيع أن تمثل فيه ذاتها. صديقي هو الآخر كان شديد الجزل المرِح، ولديه شبكة أصدقاء غاية في الاتساع، وشغل أيضاً موقع المواسي المعين للكثير من رفاقه. كنا ثلّة من الفتيات المحجبات في الصف، وأحبّت صديقتي أن تجرب الحجاب مثلنا يوماً لتلقى تعنيفاً شديداً من والدها على ذلك، وتأتي في اليوم التالي كسيرةً ومغيّرة لرأيها. بالمقابل، وفي واقع شديد القرب، كان والد صديقي يسحب ابنه من أذنه ليعنّفه أمام أناس أغراب، وهو يصرخ عليه لأنه تخلّف عن إحدى الصلوات في المسجد. اختلفت المبادئ والأفكار، وتشابهت البطريركية. لم ينجب هؤلاء أبناءً إلا ليقصّوا أجنحتهم بقسوة، ويضعونهم في القالب المصنوع سلفاً على أحجام أمزجتهم.
ديكتاتوريات داخل ديكتاتوريات
يتساءل المرء: أين المجتمع المحيط من هذه الشخصيات؟ كيف يمكن لأب أن يمتلك سلطة مطلقة على أطفال صغار على مدى سنين، أو على امرأة يُفترض بها أن تكون له شريكة حياة؟ لا تأتي هذه السلطة من عدم، لا يصادف أن يزدهر شخص سيء في بيئة، إلا وهذه البيئة تهادنه بمستوى أو بآخر. كانت إحدى الوالدتين زُوّجت قسراً لهذا الأب وهي في عمر صغير (14 عاماً، أو ربما 15)، ولم تكن تبذل أيّ جهد للدفاع عن أبنائها، إذ كانت تعتقد بأن هذه حال العائلات ولا بدائل محتملة أخرى، فيما كانت الأم الأخرى تُعنَّف مع أبنائها، ويطالها من الضرب ما ينالهم سواءً بسواء. حين تقدمت بنا السنين أصرّيت على صديقي بأن نجد شخصاً يمكن اللجوء إليه من بين كل المعارف المحيطين بوالده. اقترح عليّ اسم شيخ آخر يقول أن والده يحترمه ويهابه، فهو بطريقة ما أعلى منه مكانة. وصلنا إلى هذا الشيخ وأخبرناه بما يحدث، ليُخبرنا بأنه لا يستطيع التدخل بصورة جادة، ولكنه سينصحه بـ"تخفيف نوبات غضبه" حين يراه المرة القادمة. وحين علم الوالد بأن ابنه شكاه لأحدٍ خارج عائلتهم هدده بأنه "سيقطع له لسانه" في حال شكا لأحد مرة أخرى. جدير بالذكر أن هذا الشيخ كان وجهة للعديد من الناس لحلّ مشاكلهم وطلب الصلح والفتوى.
تُقدّر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه من بين 87 ألف امرأة قُتلن في جميع أنحاء العالم عام 2017، مات أكثر من نصفهن على أيدي أزواجهن أو أقاربهن، ما يعني أن هناك حوالي 137 امرأة تُقتل يومياً على يد أحد أفراد أسرتها.
تسجل إحصاءات الأمم المتحدة أن 37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لأحد أنواع العنف الجسدي، أو الجنسي لمرة واحدة في حياتهن على الأقل، مضيفة أنّ النسبة قد تكون في الحقيقة أعلى، إلا أنّ غياب الإحصائيات التي يمكنها أن توثق جميع الحالات يمكنه أن يغير في النتيجة.
لم يكن من الشائع أن تساعد المدارس في هذه الحالات أيضاً. لم تعرف المعلمات بما يحصل، وكنّ مستعدات لأن يعاقبن صديقتي بأشكال وألوان العقوبات الشائعة في مدارس البعث مثلها مثل أي طالبة أخرى. عُيّنت مختصة اجتماعية في مدارس الثانوية، ولكنّها لم تكن وظيفة ذات فعالية حقيقية على أرض الواقع، وفي حالات مماثلة لصديقتي كانت الجلسات مع أولئك المختصات أقرب لمساحات "للفضفضة" مما هي أماكن للعلاج.. نصف ساعة يومياً تفتح فيها المختصة الاجتماعية بابها لتستقبل من يريد أن يشارك شيئاً من حياته، ولم تكن أغلب الطالبات تؤمنّ بجدوى قول أيّ شيء. هذا بالطبع إن لم تكن المختصة نفسها تحمل إيديولوجيات أو تحيزات معينة (وذلك حديث آخر).
ممالك الصمت الصغيرة
توثق الإحصائيات انتشاراً عالمياً لظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة الذي يصل للقتل في بعض الحالات. تُقدّر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه من بين 87 ألف امرأة قُتلن في جميع أنحاء العالم عام 2017، مات أكثر من نصفهن على أيدي أزواجهن أو أقاربهن، ما يعني أن هناك حوالي 137 امرأة تُقتل يومياً على يد أحد أفراد أسرتها. وتقول هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إن العنف المنزلي من ضمن أحد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان، ويتضح ذلك في تقرير الأمم المتحدة الصادر في شهر نيسان/أبريل 2020 حول العنف الأسري في العالم، ضد الإناث عموماً، والذي خلص أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال الأشهر الأثني عشر السابقة لتاريخ الصدور. وبالنسبة للعنف الأسري ضد الأطفال، تشير التقديرات إلى تعرض ما يصل إلى مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عاماً لعنف بدني أو جنسي أو وجداني، أو معاناة من الإهمال في عام 2019.
تطرح خصوصية الوضع السوري تحديات أكبر تُفاقم من الأزمة. فعلاوة على غياب التشريعات القانونية التي تحمي المرأة من العنف، تشهد العائلات السورية ازدياداً ملحوظاً لحالات العنف الأسري بسبب الحرب وسوء المعيشة وتبعاتهما. يشير رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي أن ضرب المرأة شهد ازدياداً بنسبة 50 في المئة في العام 2016 عن الإحصائيات التي تخص عام 2011.
يتضّح انتشار مشكلة العنف الأسري على نطاقٍ عالمي. لكن تزداد حدّة الأزمة سوءاً في حالات البلدان الخاضعة لأنظمة قمعيّة، أو تتعرض لأهوال الحرب أو التهجير أو الكوارث الطبيعية، وكذلك العيش في مجتمعات بها تركيزات عالية من عدم المساواة والبطالة والفقر. في الواقع، تتصدر المرأة العربية قائمة نساء العالم الأكثر تعرضاً للعنف بمختلف أشكاله، وتسجل إحصاءات الأمم المتحدة أن 37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لأحد أنواع العنف الجسدي أو الجنسي لمرة واحدة في حياتهن على الأقل، مضيفة أنّ النسبة قد تكون في الحقيقة أعلى، إلا أنّ غياب الإحصائيات التي يمكنها أن توثّق جميع الحالات يمكنه أن يغير في النتيجة. وينوّه موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنه - وعلى الصعيد العالمي - 6 من كلّ 10 نساء معنّفات، لا يخبرن أي جهة عن أنهنّ معنفات، فيما الباقيات يتحدثن عن الأمر للعائلة والأصدقاء وليس للشرطة.
في البحث عن حكاية لطارق..
17-12-2014
أطفال سوريا في مصر.. ما زالت الغربة عنوانهم
05-11-2014
تطرح خصوصية الوضع السوري تحديات أكبر تُفاقم من الأزمة. فمع غياب التشريعات القانونية التي تحمي المرأة من العنف، تشهد العائلات السورية ازدياداً ملحوظاً لحالات العنف الأسري بسبب الحرب وسوء المعيشة وتبعاتها، ومثال ذلك تصريح رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي عام 2016 عن ازدياد ضرب المرأة بنسبة 50 في المئة عن إحصائيات عام 2011، سواء جاء هذا الضرب من الزوج أو الإخوة أو الأب، مع التنويه إلى تعذّر الوصول لإحصائيات شاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يجعل الشتات السوري اللجوء إلى القانون ترفاً أو خياراً مستبعداً بالنسبة للكثير من العائلات، مضافاً إليه غياب منظومة ردع وحماية مناسبة وفعالة للمهددين بالعنف الأسري، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبته تفكك بنية المجتمع التقليدية والأواصر التي كان يمكن أن تخفف من وطأة بعض الحالات.
حين أقلّب في صور المدرسة القديمة وأجد وجه رفيقتي أكثرنا ابتساماً وجزلاً في كلّ الصور، أتساءل عن أحوال الأطفال والنساء والأشخاص الذين يعبرون بي يومياً، وتضمّهم جدران تلك البيوت. قد يحتاج الأمر إلى مراحل متعددة لخلق بيئات آمنة، والوصول لتأمين الحقوق الإنسانية المتفق عليها عالمياً. لكن وبسبب طبيعة سلوكيات العنف الأسري، لا يمكن لهذا أن يتحقق إلا عبر خطوة كسر جدار ثقافة التستّر والصمت. ليست جرائم العنف، ولا سلوكيات الإيذاء الأسرية بأيّ من أنواعها أسراراً داخلية، ولا البيوت قلاع محصنة أمام تدخل الآخرين عند الحاجة، أو عند وقوع أحد أفراد العائلة في خطر التعنيف. وإن كنا فقدنا نوع التكافل الاجتماعي التقليدي مع كل ما عانته سوريا من أهوال، فإن الوسائل التقنية الحديثة تطرح نفسها خياراً لمنبر جديد يمكن عبره محاربة ثقافة التستّر والعيب ومنع انتقالها لبيئات المهجر، فضلاً عن فتحها لمنصة جديدة لنشر الوعي بحقوق الطفل والمرأة وتشبيك خطوط جديدة للتكافل والدعم.