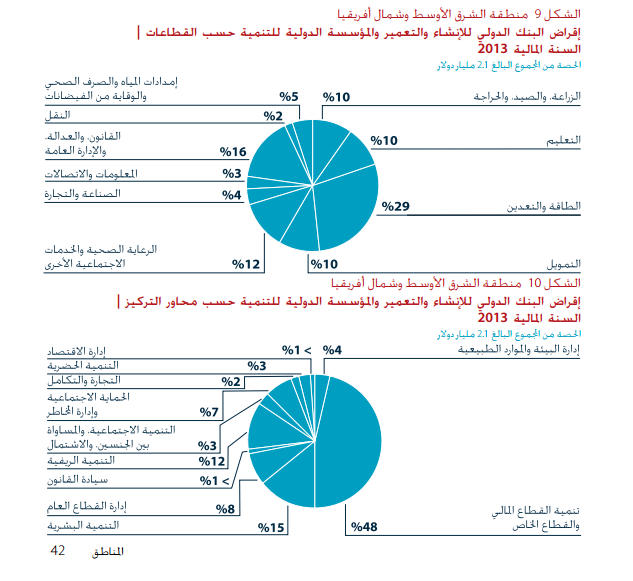تتنبأ الدراسة السنوية للجمعية الاقتصادية العالمية أن أكبر المشاكل في العام 2014 ستكون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع التفاوت الاقتصادي والبطالة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مهمة كالتغيير المناخي، والهجوم على الانترنت، وتسريب معلومات خطيرة ومغالِطة على الشبكة العنكبوتية الخ... يبقى أن النقطتين الأُول هما ما يهمان شعوب المنطقة أكثر، ويوحيان بأن هناك خطراً لاستمرار الحروب والفوضى في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي للعالم كما هو قائم.
بدأت الثورات العربية في ظل أزمة خانقة للأنظمة الغربية وللعولمة، وهي الأزمة التي أدت إلى انتفاضة للجياع (جياع إلى الأكل والحرية) على الأنظمة السائدة. للوهلة الأولى الآن، تبدو الأزمة العالمية وكأنها قد انتهت، وأن الدول الغربية قد بدأت تضمد جراحها، لا بل أن بعضها ابتدأ ينتعش اقتصادياً. يقول محللون إن هذا الواقع الجديد سمح «بالثورات المضادة» و«الانقلابات على الثورة»، إذ تحولت الأنظمة الغربية من شاهد غير فاعل لسقوط الأنظمة الحليفة (مبارك، بن علي...)، وغير قادر على التعامل مع الأنظمة الجديدة، إلى فاعل مؤثر في الانقلابات والتحولات في المرحلة الثانية: إخراج الإخوان في مصر، وإقالة أمير قطر، والضغط على زعيم النهضة راشد الغنوشي، ودعم المالكي... ترافقت هذه الفاعلية الجديدة مع مسار اعتمد السعودية وصندوق النقد الدولي كمموليَن لتلك المرحلة. فهل ستشهد المرحلة الثالثة إعادة الاعتبار لدور الولايات المتحدة وروسيا في الصراعات الإقليمية، كما حصل مؤخراً في سوريا، أم سيبقى الاتجاه الطاغي هو ضعف تأثير الدول الكبرى على مجريات الأحداث لمصلحة القوى الإقليمية الفاعلة، كإيران وتركيا والسعودية... وبالطبع إسرائيل؟
الأزمة الاقتصادية العالمية
واهمٌ تماماً من يعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية تعيش مرحلتها الأخيرة، وان الولايات المتحدة وروسيا ستتمكنان من التخفيف من حدتها، ومن تثبيت ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقاسم النفوذ، كما حصل بعد أزمة قناة السويس، أو قبلها بين القوى العظمى آنذاك، عبر اتفاقية سايكس بيكو. أما أسباب الضعف في نفوذ القوى العالمية فيعود إلى مسائل عدة، أولها عدم انتهاء الأزمة في الغرب، بل على العكس، فإن الانتعاش في الغرب يعيش فصوله الأخيرة، ولن يلبث العالم خلال السنوات المقبلة، إلا أن يدخل في أزمة جديدة نتيجة ارتفاع الديون والصعوبات في الدول النامية. ولا يخفى على أحد، بعد اتفاق إدارة أوباما مع الجمهوريين على الميزانية للسنتين المقبلتين، أن الدين العام في الولايات المتحدة سيصل إلى حوالي 120 في المئة من الدخل القومي عند انتهاء ولاية الرئيس، أي إلى النسبة نفسها التي كان عليها الدين اليوناني عند بدء الأزمة! وهذا بحد ذاته يعني أن الولايات المتحدة تمتص كل الادخار العالمي. أما الدول الأخرى فليست بحال أفضل. فالدين العام لليابان وصل إلى 240 في المئة، وهو في ايطاليا سيتعدى 130 في المئة ، وفي بريطانيا 120 في المئة، وفي فرنسا 100 في المئة. وبسبب الأزمة، اضطر البنك المركزي الأميركي إلى مضاعفة حجم الكتلة النقدية في السنوات الخمس الأخيرة، ومن الجلي انه لا يستطيع الإكمال في هذه الوجهة من دون أن ينهار الدولار وتُرفع الضرائب وتُخفّض ميزانية الدفاع، ومن دون الاعتماد أكثر فأكثر على مصادر الطاقة المحلية. وبمعنى آخر، فهو يمارس الانكفاء على الذات، خاصة أن «مردودية» الحروب الأميركية الأخيرة كانت سلبية تماماً. أما تحسن الأوضاع في أوروبا، وهو ما تم فعلا، ولم يعد انفجار منطقة اليورو مطروحاً على المدى القصير، فهو لا يعني أنها قادرة على أن تكون فاعلة اقتصادياً وعسكرياً في منطقة الشرق الأوسط، إلا من الناحية الشكلية فحسب. فالديون الأوروبية العامة الكبيرة، بالإضافة إلى الديموغرافيا المترهلة (أي ارتفاع المتوسط العمري) ستمنع حصول نمو كبير لفترة طويلة في هذه المنطقة، كما حصل في اليابان في التسعينيات من القرن الماضي. وهو كذلك يحمل على خفض ميزانيات الدفاع بشكل دراماتيكي، إذ انتصفت تقريباً هذه الأخيرة في فرنسا وانكلترا... ولم تعد فرنسا تستطيع التدخل إلا رمزياً في بعض الدول الأفريقية. وهذا ما قد يفسر لماذا أصبحت انكلترا المحارِبة عادة، أقل عدوانية في الملفين السوري والإيراني.
صندوق النقد هنا أيضاً
نتيجة عدم انتهاء الأزمة والتلويح بأزمة جديدة في الأفق، اضطرت الدول الغربية إلى اللجوء ولو بطريقة متواضعة إلى صندوق النقد الدولي لتعويم بعض الدول الصديقة في منطقة الشرق الاوسط. فأعطى الصندوق في الآونة الأخيرة الكثير من القروض بدون شروط آنية تعجيزية، كتلك التي كانت تُطلب من مرسي والغنوشي، بل هو خفض كثيراً من مطالبه، حتى انه سمح (مؤقتاً) للأردن بألاّ ينفذ وعوده بتخفيض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية، وأعطى 8 مليارات دولار كقرض للمغرب من دون ربطه بمطالب تعجيزية، كما جرت العادة قبل «الربيع العربي» وبعده.
الادوار الاقليمية
وهذا الضعف في حجم تدخل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، سمح لدول المنطقة بأن تلعب دوراً أكبر، بل بأن تتحدى إدارة أوباما. ومثال السعودية معبر لهذه الجهة. فالمملكة التي لم يكن لها دور كبير في بداية الحراك، حيث اعتبرت آنذاك سقوط مبارك وبن علي خسارة كبيرة لها، وسارع الملك وقتها إلى توزيع حوالي 60 مليار دولار كهبات على الناس وزيادات في الأجور لامتصاص أي حركة في بلده، السعودية إذاً استعادت في السنة الماضية زمام المبادرة في العديد من الدول، كالعراق ومصر وسوريا، على حساب قطر وتركيا، أو أحياناً بالاتفاق معهما. إلا ان دول الخليج لن تستطيع من خلال الأموال ان تحسم الوضع في المنطقة لمصلحتها، من دون دعم إحدى الدول الإقليمية، كتركيا (التي تتخبط في أزمة اقتصادية كبرى) أو مصر، المقسومة عموديا والتي تعاني من أزمة نوعية بأهمية أزمة آخر عهد مبارك... ولم يتمكن المال من جر الإدارة الأميركية الحالية أو روسيا إلى تبني موقفها السياسي تجاه إيران وسوريا.
من الواضح أيضاً أن أزمة الغرب الاقتصادية (الماضية والمقبلة) أجبرت الإدارة الأميركية على مهادنة إيران لكي تُبقي على التناقضات في المنطقة بعد التحدي الإسرائيلي (المستوطنات) والسعودي (في الملف السوري/ الإيراني).
الشرق الأوسط فوق ارض متحركة
هكذا يبقى الشرق الأوسط على أرض غير ثابتة بالرغم من بعض التعديلات في ميزان القوى، إذ لا تستطيع أي من القوى الإقليمية حسم الصراع من دون اللجوء إلى الخارج، مع العلم أن هذا الخارج لا يستطيع أن يتدخل! اللهم إلا لأخذ 3 مليارات دولار من المعونات... لمساعدة لبنان. يبقى أن بعض القوى الإقليمية تراهن على دور أكبر للولايات المتحدة الأميركية بعد الانتخابات الفرعية في حزيران/يونيو من السنة الحالية، إذ أن أغلب الاستطلاعات تتوقع خسارة الحزب الديموقراطي لمقاعد جديدة في الكونغرس ومجلس الشيوخ مما سيؤدي إلى نقض الاتفاقات الإيرانية ـ الأميركية، والروسية ـ الأميركية حول سوريا... والرهان على ذلك يعود إلى مسائل ستضعف إدارة أوباما:
ــ المشاكل التي اعترضت تطبيق الضمان الصحي،
ــ فضائح تجسس وكالة الأمن القومي NSA،
ــ تخلي بعض الديموقراطيين عن أوباما، ومنهم آل كلينتون،
ــ بداية انخفاض أرباح الشركات الأميركية وانخفاض التيسير الكمي.
لكن هذه الرهانات قد تكون خاطئة، سواء بالنسبة للانتخابات أو لما بعد الانتخابات. فإدارة أوباما ستحاول خلال الفترة الممتدة حتى حزيران المقبل من أن تصحح الأخطاء المتعلقة بالضمان، وقد نجحت مؤخراً إلى حد ما، وستعمد إلى رفع أجور الحد الأدنى بنسبة 50 في المئة، وذلك بمساعدة رئيسة البنك المركزي الجديدة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي. أما بالنسبة لفضيحة التجسس، فقد اتخذت الإدارة قرارات تمنع تكرار ما حصل مستقبلاً. وأخيراً، فإذا كان وول ستريت لا يحب أوباما، إلا أن أميركا الصناعية والزراعية ستصوت لمصلحته مجدداً. وعلى كل، فما زال لديه 45 في المئة من الشعبية حتى الآن، بعد حوالي ست سنوات من الحكم.
حتى لو خسر أوباما الانتخابات الفرعية، فلا يعني ذلك أبداً أن تعديل ميزان القوى الداخلي الأميركي لمصلحة الجمهوريين سيكون بالضرورة في صالح السيناتور مكّين. وعلى أية حال، فكل هذا لن يسمح بتعديل ميزان القوى في الشرق الأوسط، لأن الميزانية العسكرية تنخفض والدين العام الأميركي سيزداد... كائنا من كان المنتصر.